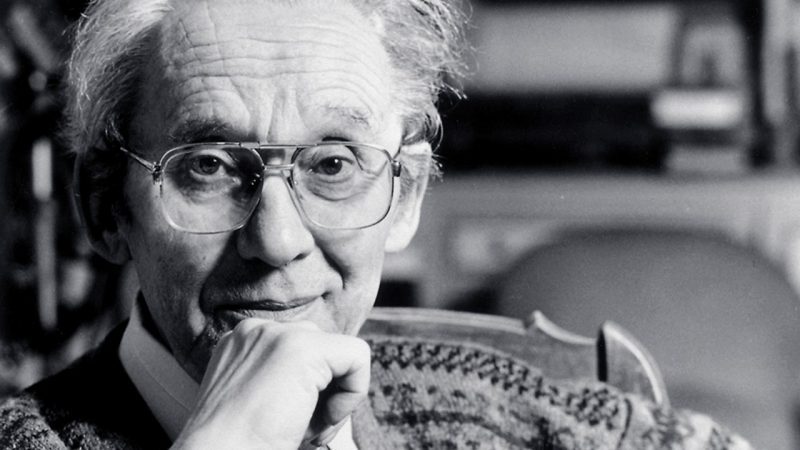هناك اغتراب سياسي مخصوص لأن السياسي مستقل. إنه الوجه الآخر ل لمفارقة التي لابدّ من توضيحه الآن:
بيت القصيد هو أن الدولة إرادة . يمكن أن نلحّ قدر ما نشاء على المعقولية التي يمنحها السياسي للتاريخ ـ هذا حق ـ؛ لكن إذا كانت الدولة معقولة الغاية، فإنها تتقدّم في التاريخ بفعل القرارات. ليس من الممكن أن لا نُدخل في تعريف السياسي فكرة القرارات ذات المدى التاريخي، أي تلك التي تغيّر بصورة دائمة مصير جماعة إنسانية تنظمها الدولة وتوجّهها. فالسياسيّ تنظيم معقول ، والسياسي قرار: تحليل محتمل للأوضاع ، ورهان محتمل على المستقبل. لا يستقيم السياسي دون سياسة.
يحمل السياسي معناه بعد أن يفوت أوانه، في التفكير، في " الاستذكار"، في التنقيب، في المشروع، أي في قراءة محتملة للأحداث المعاصرة وفي حزم الحلول في الآن نفسه. لأجل ذلك إذا كانت الوظيفة السياسية والسياسي بلا تناوب، أمكن أن نقول في معنى ما أن السّياسي لا يوجد إلا في اللحظات الحاسمة، في " الأزمات"، في " المنعطفات "، وفي مفاصل التاريخ.
ولكن ليس من الممكن تعريف السياسي دون إدراج اللحظة الإرادية للقرار. وليس من الممكن أبدا الحديث عن " قرار سياسي" دون التفكير في السلطة.من السياسي إلى السياسة، نمر من تولّي السلطة إلى الأحداث، من السيادة إلى صاحب السيادة، من الدولة إلى الحكم، من العقل التاريخي إلى السلطة. هكذا تظهر خصوصية السياسي في خصوصية وسائله؛ فالدولة منظورا إليها من جهة السياسة ، هي الحكم الذي يحتكر الإرغام الفيزيائي الشرعي؛ و تشهد صفة شرعي بأن تعريف الدولة بوسيلتها المميّزة يحيل إلى تعريف الدولة ذاتها بغايتها وشكلها؛ ولكن، إذا حدث أن تطابقت الدولة، صدفة، مع أساس شرعيتها، ـ كأن تصير مثلا سلطة القانون ـ فإن هذه الدولة ستكون أيضا محتكرة للإرغام. ستكون أيضا سلطة البعض على الجميع؛ وستضمّ أيضا شرعية، أي سلطة أخلاقية للإلزام، و عنف لا راد له، أي سلطة مادية للإرغام.
هكذا ندرك فكرة السياسة بالذات في كل اتساعها؛ نقول إنها مجموع الأفعال التي موضوعها ممارسة السلطة ،وبالتالي الاحتكار والحفاظ على السلطة أيضا؛ ورويدا رويدا قد يصير سياسة كل نشاط تكون له غاية أو حتى ببساطة نتيجة هي التأثير على توزيع السلطة(8). إنها السياسة ـ السياسة محددة بالرجوع إلى السلطة ـ هي التي تطرح مشكل الشرّ السياسي. (أو الداء السياسي) لأن هناك مشكل مخصوص للسلطة ثمة مشكل الشر السياسي.
ليس لكون السلطة هي الشر، بل لأن السلطة تعني عظمة الإنسان وهو خاضع تماما للشرّ؛ وقد يكون في التاريخ أكبر مناسبة للشرّ وأكبر برهنة عليه. وذلك لأن السلطة شيء عظيم؛ ولأنها(أي السلطة) هي أداة المعقولية التاريخية للدولة. ولا يجب في أي حال من الأحوال إسقاط هذه المفارقة.
إن هذا الداء المخصوص للسلطة قد أقر به أعظم المفكرين السياسييين ومعهم مجموع هائل . أنبياء بنو إسرائيل وسقراط القورجياس يلتقون في هذه النقطة؛ أمير ماكيافللي، نقد ماركس لفلسفة الحق لهيجل ، الدولة والثورة للينين، و....تقرير خروشتشاف، هذه الوثيقة الممتازة عن الشر في السياسة- جميعها تقول نفس الشيء، في سياقات لاهوتية وفلسفية مختلفة جوهريا. ويشهد هذا التقارب ذاته باستقرار الإشكالية السياسية عبر التاريخ والذي نفهم نحن ، بفضله ، هذه النصوص كحقيقة لكل الأزمان.
والملفت للنظر أن أقدم نبوءة توراتية مكتوبة، نبوءة "آموس" تدين بالأساس جرائم سياسية لا أخطاء فردية. وحيثما يستهوينا النظر إلى ذلك كمجرد آثارا لفكرة فاسدة للخطيئة الجماعية، سابقة لفردنة العقاب والخطأ، يجب معرفة حصريا إدانة شر السياسة كشر للسلطة ؛ إن الوجود السياسي للإنسان هو الذي يمنح للخطيئة بعدها التاريخي، قوتها المكتسحة، وإذا أمكن أن نقول ، عظمتها. يمر موت المسيح ، كما موت سقراط، عبر فعل سياسي ، بمحاكمة سياسية ، إنه حكم سياسي، ذاك الذي هو ذاته يضمن بنظامه وهدوءه النجاح التاريخي للإنسانيhumanitas والكوني، luniversalitas، إنها السلطة السياسية
الرومانية هي التي رفعت الصليب: " لقد عانى تحت جكم "بونس بيلات" ponce pilate " وهكذا تظهر الخطيئة في السلطة وتكشف السلطة طبيعة الخطيئة التي ليست متعة، بل كبرياء القوة، داء التملك والسلطة.
لايقول الجورياس شيئا غير هذا ، بل يمكن أن نقول إن الفلسفة السقراطية والأفلاطونية نشأت في جانب منها عن التأمل في " الطاغية" ، أي عن الحكم بلا قانون ودون رضى من قبل الرعايا. كيف يكون الطاغية- نقيض الفيلسوف- ممكنا؟ إن هذا السؤال يمسّ صميم الفلسفة لأن الاستبداد ليس ممكنا دون تزييف للكلام، أي لهذه السلطة الإنسانية بامتياز، سلطة قول الأشياء والتواصل مع البشر. يرتكز كل الحجاج الأفلاطوني في القورجياس على التقاطع بين انحراف الفلسفة الذي تمثله السفسطة وانحراف السياسة التي يمثله الاستبداد . يشكل الاستبداد والسفسطة زوجا مريعا. وهكذا يكتشف أفلاطون وجها لشر السياسة مختلفا عن القوة، ولكنه شديد الصلة بها، هو" المغالطة"، أي فنّ اغتصاب الإقناع بوسائل أخرى غير الحقيقة؛ وهذا يذهب بنا بعيدا، فإذا صحّ أن الكلام هو الوسط ، مميّز الإنسانية ، اللوغوس الذي يجعل الإنسان شبيها بالإنسان ويؤسس التواصل ، فإن الكذب والتملق ، واللاحقيقة- الشرور السياسية بامتياز- تهدم الإنسان إذن من الأساس الذي هو كلام، خطاب وعقل.هذا إذن تأمل مزدوج في كبرياء القوة وفي اللاحقيقة اللتان تكشفان عن شرور متصلة بماهية السياسة.
غير أني أجد هذا التأمل المزدوج في هذين الأثرين العظيمين للفلسفة: الأمير لماكيافللي والدولة والثورة للينين،اللذان يشهدان باستمرار إشكالية السلطة عبر حقيقة أشكال الحكم، بتطور التقنيات وتحولات التشريطات الاقتصادية والاجتماعية. فلمسألة السلطة، وممارستها وامتلاكها و دفاعها واتساعها، استقرار مدهش يحمل على الاعتقاد في استمرار طبيعة إنسانية.
قد قيل الكثير عن " الماكيافللية"، ذمّا ؛ ولكن إذا شئنا أن يحمل الأمير، كما يلزم ، على محمل الجدّ فسنكتشف أننا لن نتجنب بيسر مشكله الذي هو بالتحديد تأسيس سلطة جديدة لدولة جديدة . إن الأمير هو المنطق العنيد للعمل السياسي؛ إنه منطق الوسائل، التقنية الخالصة للحيازة والمحافظة على السلطة؛ وهذه التقنية تهيمن عليها تماما العلاقة السياسية الأساسية صديق- عدو، العدو الذي يمكن أن يكون خارجيا أو داخليا، شعب، نبالة، جيش أو مستشار وكل صديق يمكن أن يصير عدوا والعكس بالعكس؛ وتتحرك هذه التقنية فوق مجال واسع يبدأ من القوة العسكرية إلى مشاعر الخشية والاعتراف، الانتقام والوفاء.
إن الأمير بمعرفته كل نتائج القوة، الجسامة و التنوع والألاعيب المتباينة لبطانته ،سيكون خبيرا استراتيجيا وعالم نفس ، أسد وثعلب. هكذا يطرح ماكيافللي المشكل الحقيقي للعنف السياسي، الذي ليس هو بعنف عقيم ،عنف الاعتباطي والجنون، إنما عنف محسوب ومحدود، مقدر بالذات بهدف تشييد دولة مستمرة.و من شك يمكن أن نقول ،أنه بهذا الحساب يخضع العنف المؤسس لحكم الشرعية المؤسسة ؛ غير أن هذه الشرعية المؤسسة ، هذه " الجمهورية"موسومة منذ النشأة بالعنف الذي نجح.هكذا نشأت جميع الأمم، كل السلطات وكل النظم؛ و انصهرت نشأتها العنيفة في الشرعية الجديدة التي ولدتها، إلا أن هذه الشرعية الجديدة تحتفظ بشيء ما من العرضي، من التاريخي تحديدا،لا تكفّ نشأتها العنيفة عن إفادتها به.
لقد كشف ماكيافللي للعيان علاقة السياسة بالعنف؛ وهنا تكمن نزاهته وصدقه. وبعد قرون عديدة يعود ماركس ولينين إلى مبحث يمكن أن نقول إنه أفلاطوني، مشكل " الوعي الزائف". ويبدو لي بالفعل أن أهم ما في النقد الماركسي للسياسة والدولة الهيجيلية، ليس تفسيرهما(أي ماركس وليين) للدولة بعلاقات القوة بين طبقات، وبالتالي اختزال الشر السياسي في شر اقتصادي – اجتماعي، إنما وصف هذا الشر كشر خاص بالسياسة؛ بل أعتقد أن أعظم بلية تصيب كل عمل الماركسية- اللينينية وترزح على كل النظم التي ولدتها الماركسية، هي هذا الاختزال للشر السياسي في شر اقتصادي ؛ من هنا جاء وهم مجتمع متحرر من تناقضات المجتمع البورجوازي سيتحرر أيضا من الاغتراب السياسي. غير أن الأساسي في نقد ماركس(ج.و.كالفاز" فكر كارل ماركس، الفصل المتعلق بالاغتراب السياسي.) هو أن الدولة ليست هي ما تدعيه وما لا تقدر أن تكونه. ماذا تدعّي؟ إذا كان هيجل على صواب، فإن الدولة هي المصالحة، المصالحة في حقل أرفع من المصالح والأفراد، غير القابلة للتوفيق بينها في مستوى ما يسميه هيجل المجتمع المدني،لنقل مصالحة على الصعيد الاقتصادي- الاجتماعي. إن عالم العلاقات الخاصة غير المنسجم محكوم ومعقلن بالحكم الأعلى للدولة. فالدولة هي الوسيط وهي إذن العقل.ويدرك كل منا حريته كحق من خلال حكم الدولة.
هذا ما يعنيه سياسيا أنني حرّ. وفي هذا المعنى يفهم هيجل أن الدولة نيابية : توجد في التمثيل والإنسان يمثل فيها.إن الأساسي في نقد ماركس هو فضح وهم قائم في هذا التمثيل؛ كون الدولة ليست العالم الحقيقي للإنسان، ولكن عالم آخر لاواقعي؛ لا يحل التناقضات الواقعية إلا في حق خيالي هو بدوره في تناقض مع العلاقات الواقعية بين البشر. وانطلاقا من هذا الأكذوبة الأساسية ، من هذا التنافر بين الإدعاء والموجود الحقيقي سيعثر ماركس من جديد على مشكل العنف . ذلك أن السيادة ليست كون الشعب في واقعه العيني إنما في عالم آخر منشود، ملزم بان يسند بدعامة صاحب سيادة فعلي، عيني، ملموس.فمثالية الحق لا يحتفظ بها في التاريخ إلا بواقعية الاعتباطي لدى الأمير. هذا هو مجال السياسي الذي ينقسم إلى مثالي السيادة وواقع السلطة، إلى السيادة وصاحب السيادة، إلى الدستور والدولة، بل الشرطة. ولا يهم كثيرا أن ماركس لم يعرف إلا الملكية الدستورية؛ فتفكك الدستور والملكية، وتفكك الحق والعرضي، هو تناقض داخلي لكل سلطة سياسية. ويصدق هذا أيضا على الجمهورية .انظروا كيف أنه في السنة الماضية سلبت أصواتنا من طرف سياسيين بارعين قلبوا السلطة القائمة ضدّ سيادة الجسم الانتخابي؛ يميل صاحب السيادة دوما إلى التحايل على السيادة؛ إنه الداء السياسي الجوهري. لا توجد دولة دون حكم، دون إدارة وشرطة؛ ثم ألا تخترق ظاهرة الاغتراب السياسي كل الأنظمة، عبر كل الأشكال الدستورية؟ والمجتمع السياسي هو الذي يحتمل هذا التناقض الخارجي بين عالم مثالي لعلاقات الحق وعالم واقعي لعلاقات جماعية وهذا التناقض الداخلي بين السيادة وصاحب السيادة، بين الدستور والسلطة، وفي النهاية الشرطة. إننا نحلم بدولة يحل فيها التناقض الجوهري الذي يوجد بين كونية تنشدها الدولة وبين ما يلحقها في الواقع من الجزئية والعرضي؛ والداء هو أن هذا الحلم صعب المنال.
ومن المؤسف أن ماركس لم يلحظ الطابع المستقلّ لهذا التناقض؛ لقد رأى فيه مجرد بنية فوقية ، أي تغيير موضع، على صعيد مضاف، لتناقضات تنتمي لمستوى تحتي للمجتمع الرأسمالي وفي النهاية أثرا لتناقض الطبقات.فالدولة ليست إذن إلا أداة عنف الطبقات، في حين أن للدولة دوما هدفا، مشروعا يتجاوز الطبقات وان تأثيرها السيئ هو المقابل لهذا الهدف العظيم. ولكون الدولة مختزلة هكذا في أداة قمع بيد الطبقة المهيمنة، فإن وهم الدولة في أن تكون مصالحة كونية ليس إلا حالة خاصة لهذه العلة للمجتمعات البورجوازية التي لا تقدر على احتمال فشلها أو حلّ تناقضاتها إلا بالهروب إلى الحلم بالحقّ. وأعتقد أنه يجب أن نحتفظ، ضد ماركس ولينين بأن الاغتراب السياسي ليس قابلا للاختزال في غيره، ولكنه مقوم للوجود الإنساني، و في هذا المعنى، فإن نمط الوجود السياسي يحتمل انفصال الحياة المجردة للمواطن عن الحياة العينية للأسرة والعمل.وأعتقد أيضا أننا ننقذ هكذا أفضل ما في النقد الماركسي، الذي يلتحق بالنقد الماكيفللي، الأفلاطوني والتوراتي للسلطة.
ولا أريد من حجة على هذا غير تقرير خورتشوف؛ وما يبدو لي أساسيا، هو أن النقد الذي قام به ستالين ليس له من معنى إلا إذا كان اغتراب السياسة اغترابا مستقلا ، غير قابل للاختزال في اغتراب المجتمع الاقتصادي.وإلا ّ، فكيف يمكننا نقد ستالين والاستمرار في استحسان الاقتصاد الاشتراكي والنظام السوفيتي؟ فلا إمكان لتقرير خورتشوف دون نقد للسلطة وعيوبها.ولكن بما أن الماركسية لا تترك مكانا لإشكالية مستقلة للسلطة، نلجأ إلى الحكاية وإلى النقد الأخلاقوي. لقد كان توقلياتي صريحا جدا يوم أن قال إن تفسيرات خورتشوف لا ترضيه وانه يتساءل كيف أمكن أن توجد ظاهرة ستالين في النظام السوفيتي. ولا يمكننا أن نمنحه الجواب على هذا التساؤل ، لأن الجواب لا يمكن أن ينتج إلا عن نقد للنظام الاشتراكي الذي لم يحدث والذي قد لا يحدث في إطار الماركسية، على الأقل بموجب أن الماركسية تختزل كل أشكال الاغتراب في الاغتراب الاقتصادي والاجتماعي.
أود أن يكون واضحا مرة واحدة إلى الأبد أن مبحث الشر السياسي الذي وقعت إثارته لا يعبر بالمرة عن نزعة"تشاؤمية " سياسية و لا يبرر أيّ "انهزامية " سياسية. زد على ذلك، فالنعوت "تشاؤمية" "وتفاؤلية" لابد أن تستبعد من حقل التفكير الفلسفي. والتشاؤمية والتفاؤلية هي أمزجة ولا تعني إلا علم الطبائع أي أنه لا دخل لها هنا. غير أن الشفافية إزاء شر السلطة لا يمكن أن تنفصل عن تفكير شامل في السياسي؛ بيد أن هذا التفكير يكشف أن السياسة لا يمكن أن تكون مجالا لأعظم شر بموجب مكانتها البارزة في الوجود الإنساني.إن عظمة الشر السياسي هي بقدر الوجود السياسي للإنسان. وإنه يجب، أكثر من أي شيء آخر، على تأمل في الشر السياسي يقربه من الشر الجذري والذي يجعل منه التقريب الأقرب ما يكون منه، أن يظلّ غير قابل للفصل عن تأمل في دلالة للسياسة هي جذرية بحد ذاتها.وكل اتهام للسياسة بالسوء، اتهام في حد ذاته باطل، مغرض، سيء، سها عن حذف هذا الوصف في بعد الحيوان السياسي. إن تحليلا للسياسة كمعقولية للإنسان شغالة، ليست ملغاة، ولكن مفترضة باستمرار من قبل تأمل في الشر السياسي. بل إن الشر السياسي على النقيض، لا يكون جديا إلا لأنه شر (او داء)هذه المعقولية، الشر المخصوص لهذه العظمة المخصوصة.
إن النقد الماركسي للدولة بشكل خاص لا يلغي تحليل السيادة، من روسو إلى هيجل، إلا أنه يفترض حقيقة هذا التحليل.فإذا لم يكن هناك حقيقة للإرادة العامة (روسو)، وإذا لم يكن هناك غائية للتاريخ عبر " إجتماعية غير قابلة للاجتماع" وبواسطة هذه "الحيلة للعقل" التي هي المعقولية السياسية (كانط). وإذا لم تكن الدولة ممثلة لإنسانية الإنسان، فلا خطر للشر السياسي. ذلك لأن الدولة هي تعبيرة ما لمعقولية التاريخ، انتصار على أهواء الإنسان الخاص، على المصالح"المدنية" وحتى على المصالح الطبقية، إنها عظمة الإنسان الأكثر عرضة، المهددة أكثر ، والأميل إلى الشرّ. إن "الشر" السياسي، في معناه الحقيقي، هو جنون العظمة، أي جنون ما هو عظيم ـ عظمة وإثم السلطة! حينئذ لا يمكن للإنسان تجنب السياسة تحت طائلة تجنب إنسانيته الخاصة. يكون الإنسان، وعبر التاريخ وبواسطة السياسة مواجه لعظمته ولجرمه.
كيف لنا أن نستنتج" انهزامية" سياسية من هذه الشفافية؟ إن ما يؤدي إليه هذا التفكير هو بالأحرى اليقظة . يلتحق التفكير هنا، وقد استوفى دورته، بالراهنية ويتقدم من النقد إلى الممارسة.
الحقيقة والتاريخ ( بول ريكور) ص 298 -306
دار سيراس للنشر 1995