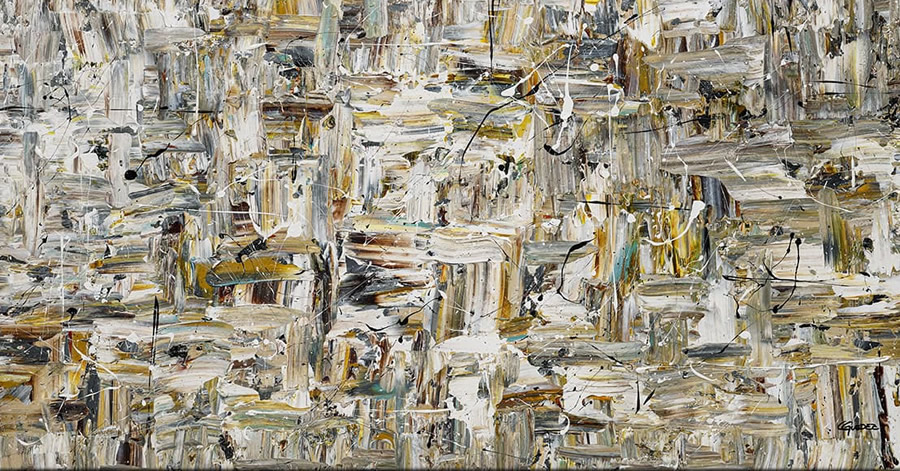إن الحديث عن تجديد الخطاب الديني في الفكر العلماني الحداثي يدعونا للوقوف على عنصرين مهمين أعتبر أنهما المكون الأساس لخطاب التجديد لدى التيار العلماني، أما أولهما فهو الاجتهاد؛ ماذا نقصد بالاجتهاد، وما هي حدوده وأبعاده؟
والعنصر الثاني، و هو المصلحة؛ ماذا نقصد بالمصلحة وما هي حدودها وأبعادها؟
إن الانطلاق في تحرير هذه الورقة من هذين العنصرين سيصل بنا في الأخير إلى النتيجة المطلوبة، وهي الوقوف على أبعاد دعوى تجديد الخطاب الديني وأهداف هذا المشروع.
لقد تعمدت أن أبدأ بالاجتهاد قبل التجديد، لأن الاجتهاد يعتبر مدخلا للتجديد في الفكر الحداثي، على اعتبار أن التجديد لا يمكن أن يتم إلا بالاجتهاد، لذلك لا بد من تحديد معنى الاجتهاد أولا إذ من خلاله يمكن أن ندرك حقيقة التجديد بمعناه الحداثي.
لست أريد أن أتتبع أصول هذا المصطلح الأصولي المحض بقدر ما أريد أن أنطلق من تحديده لدى علماء الأصول، ثم مراحل تطوره إلى أن تغيرت معالمه ودلالاته لدى الفكر الحداثي، وذلك حتى لا نكون متسرعين في إصدار أحكام مسبقة حول الموضوع.
لقد عرف مفهوم الاجتهاد تطورا كبيرا داخل الحقل المعرفي الديني ذاته، إذ أنه انتقل من كونه معنى من معاني القياس كما نجده مع الشافعي، فالاجتهاد عنده لا يخرج عن دائرة القياس حتى قال: " والاجتهاد القياس"[1]، وحتى إذا تجاوزه فإنه لا يتعداه إلا للقياس الخفي (الاستحسان)، " ولم يكن دالا على بذل الجهد لاستنباط الأحكام من النص وفي ذاته"[2]، وهذا المعنى الأخير لا نكاد نجده إلا مع تطور هذا المفهوم عند الأصوليين خصوصا بعد القرن الخامس الهجري إذ أنه أصبح بمعنى " استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية"[3]، وبذلك نجد أن معنى الاجتهاد قد تجاوز القياس إلى أن أصبح يطلق على النظر في دلالات النص والبحث في أبعاده ومقاصده، خصوصا إذا كان النص ظني الدلالة. وبالتالي فإن دائرة الاجتهاد قد اتسعت مع تطور علم الأصول منذ الشافعي إلى مابعد الشاطبي، وإذا رجعنا إلى الخطاب العلماني فإننا نجد أن وجه المطابقة بينه وبين الأصوليين في تفسير معنى الاجتهاد لا يختلف في ظاهره، إلا أنه أصبح من الضروري عندهم رفع تلك الشروط التي وضعها الفقهاء للاجتهاد، وترك المجال مفتوحا لكل التيارات الفكرية على اختلاف توجهاتها الإيديولوجية، وذلك من خلال " حل مشكلة شروط الاجتهاد [...] تلك الشروط التي وضعها العقل الفقهي منذ أكثر من ألف عام واعتبارها ضوابط وقواعد للاجتهاد حتى في العصر الحالي وفي كل العصور"[4]، فالاجتهاد في الفكر الحداثي مختلف في عمقه عن معناه الشرعي الذي عرفه الفقهاء، إذ أصبح الاجتهاد بمعنى (التأويل الجديد للإسلام)، " وفي اعتقادنا فإنه حان الوقت لدعم ما يسمى "إسلام التأويل الجديد" لأنه يحاول فتح باب الاجتهاد مرة أخرى [...] وإسلام التأويل الجديد يحتوي على تيارات مختلفة واتجاهات عديدة"[5] ، وبهذا المعنى يصبح الاجتهاد وتأويل النصوص الدينية متاحا للجميع فضلا عن أهل الاختصاص من فقهاء وعلماء، وإذا كان الاجتهاد من المنظور الحداثي بهذا المعنى فإننا نقول؛ إن الخطاب الحداثي لم يستوعب ـــ حتى الآن ـــ معنى الاجتهاد كما قررته المنظومة الفقهية، ولم يقف على معانيه وأبعاده وإن حاول ترصدها، ثم إن الادعاء بسد باب الاجتهاد أمر غير مسلم به، وأي اجتهاد يقصدون؟
إننا نعلم علم اليقين أنهم يقصدون بذلك إسقاط العمل بالنص وإبداله بالمصلحة، وإذا فرضنا ذلك جدلا، فإننا لابد أن نتبين أولا حدود المصلحة ومايقصد بها في عرف الحداثيين، ثم ماذا يقصدون بتقديم المصلحة على النص؟
لا يخفى علينا جميعا أن التشريع الإسلامي يتميز بكونه تشريع يسعى إلى ترسيخ البعد المصلحي الذي يحقق الأمن والأمان والاستقرار للجنس البشري، كما أنه لا يخفى علينا كذلك أن المصلحة مقيدة بضوابط وشروط توجهها، وأنها غير متروكة على إطلاقها، إلا أن التيار العلماني يسعى إلى إبدال المصلحة من معناها الشرعي إلى معنى آخر تكون فيه المصلحة مؤسسة على مجرد العقل المحض، بدعوى أن الإسلام جاء لأجل تحقيق مصلحة العباد، وهذه المصالح تتغير بتغير الزمان والمكان، ومادام أن المجتمع الإسلامي قد تطور فإنه لابد أيضا أن نطور مفاهيمنا ومناهجنا في التعامل مع الخطاب الديني (القرآني)، وأن نتحرر من تلك الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء بدعوى أنها محكومة بواقع زماني مغاير لواقعنا المعاصر المنفتح على الحداثة الغربية.
" لقد حرص الخطاب الحداثي على إبراز فكرة أولوية المصلحة، بِعَدِّ النص خادما لها وساعيا إلى تحقيقها، والمصلحة هي الأساس وهي المقصد من التشريع ومن النص نفسه"[6] ولا أحسب أنهم أتوا بشيء جديد، ذلك أن الفقهاء أنفسهم كانوا يبحثون في الأحكام الشرعية عن بعدها المصلحي، وهذا واضح في تنزيلهم للأحكام حسب الأحوال والزمان والمكان والعادات...، إلا أن الفروق بين الفريقين أن الفقهاء كانوا دائما يحاولون أن يجعلوا النص والواقع يسريان على التوازي، أي بشكل أفقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حاكمية النص، بينما العلمانيون ينظرون للنص القرآني نظرة التعالي، ويجعلون الحاكمية للواقع، بل إنه إذا تعارض الواقع عندهم مع النص يقدم الواقع ويلغى النص، ولا ضير عندهم في ذلك أبدا، بل هو عين الصواب.
إن تجديد الخطاب الديني في الفكر العلماني ينطلق من البحث في المصلحة التي يجب أن لا تستنبط من النص نفسه، بل أن يوجه النص ليكون خادما لتلك المصالح التي نريدها لا التي يريدها الشارع، وبذلك " فتكون الأغراض الضيقة التي انطلق منها أوهمته بأن المصلحة المستخرجة من مظان الشرع هي المصلحة الحقيقية المقصودة، في حين أنها ليست كذلك."[7]
إذا كانت المصلحة من المنظور الشرعي خادمة للخطاب مبينة لمقاصده الشرعية التي يجب أن تكون أفعال المكلفين موافقة لها، فإن الاتجاه العلماني يرى عكس ذلك تماما، إذ أن النص عنده هو الذي يجب أن يخدم المصلحة و يُوجَّه بحسبها، حيث أنه إذا تعارض النص عندهم مع المصلحة تقدم الأخيرة دون النظر في الشروط المعتبرة في تقديم هذه المصلحة وترجيحها، مستندين في ذلك إلى مجموعة من النصوص المنقولة عن الشاطبي والطوفي والعز بن عبد السلام وغيرهم، بدعوى أنهم كانوا علماء متنورين في تقديمهم للمصلحة، ولم يبينوا معنى المصلحة عند هؤلاء العلماء، وكذلك معنى النص،[8] فيكون "الدين عندهم فرعا للمصلحة، أي إنه يستعان به من حيث كونه مؤثرا في تنفيذ وجوه المصلحة المعتبرة لديهم"[9]، وكل الأحكام الشرعية التي لا توافق المصلحة بهذا المعنى يجب ردها وإعادة النظر فيها وإبدالها بأحكام أخرى أكثر حداثة وانفتاحا، بل وتحقيقا للمصلحة بدعوى الاجتهاد والتجديد.
نستنتج من ذلك مجموعة من الملحوظات كالآتي:
أولا: إن المعايير الزمنية التي يقيمون بها المصالح والمفاسد معايير ضيقة ومحدودة.
ثانيا: أنها مقومة باللذة فقط.
ثالثا: اعتبار الدين عندهم فرعا للمصلحة.[10]
خلاصة:
من هنا يمكن أن نستنتج بأن دعاوى العلمانية لتجديد الخطاب الديني ماهي في عمقها إلا نسف للدين الإسلامي وإسقاط للعمل بأحكامه المبنية على النصوص القطعية، كأحكام الميراث، والزنا، والربا...، وإلا فما معنى القول بأنه يجب وضع قطيعة مع الماضي وكل ما أنتجه من تراث، والتأسيس لإسلام جديد أكثر حداثة كما يدعو له محمد أركون، وعبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، وهشام جعيط، وغيرهم من أنصار الحداثة، ألم يانِ لهؤلاء أن الإسلام أعمق بكثير من أن ينظر إليه بهذه النظرة التقزيمية، ثم ماهي جهودنا نحن اليوم كباحثين في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية في سبيل الدفاع عن أحكام الشريعة وبيان واقعيتها المستمرة؟
إنها أسئلة تستدعي منا وقفات وتأملات تكون أكثر عمقا وجرأة في تعاملنا مع مناهجنا الإسلامية التي بإمكاننا أن نحقق بها استقلاليتنا الفكرية والتحرر من التبعية .
بيبليوغرافيا البحث:
الشافعي، محمد بن ادريس
الرسالة/ اعتنى به – د.ناجي السويد- المكتبة العصرية-ط.2015-بيروت-لبنان
الغرناطي، محمد بن جزي
تقريب الوصول إلى علم الأصول/ت.عبد الله محمد الجبوري-دار النفائس-ط.الثالثة-2019 – الأردن
السليماني، عز الدين
النص القرآني والإجراء العلماني للمقاصد/أفريقيا الشرق- ط.2018-الدار البيضاء-المغرب
الصولبي، حميد
الفقه والسياسة/المطبعة والوراقة الوطنية- ط.الأولى2014/ مراكش-المغرب
الجلاصي، بثينة
النص والاجتهاد في الفكر الأصولي/ رؤية للنشر والتوزيع-ط.الأولى2011/ القاهرة- مصر
أبو المجد، عبد الجليل، و حارث، عبد العالي
تجديد الخطاب اللإسلامي وتحديات الحداثة/ أفرقيا الشرق- ط.2011/ الدار البيضاء- المغرب
يحيى، محمد
الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر/ أفرقيا الشرق-ط.2010/ الدار البيضاء- المغرب
[1] محمد بن ادريس الشافعي/ الرسالة – ص192
[2] يحيى محمد/ الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر- ص9
[3] ابن جزي الغرناطي / تقريب الوصول إلى علم الأصول – ص141
[4] عبد الجليل أبو المجد وعبد العالي حارث/ تجديد الخطاب الإسلامي وتحديات الحداثة – ص28 بتصرف
[6] د. عز الدين السليماني/ النص القرآني والإجراء العلماني للمقاصد – ص95
[7] د.حميد الصولبي/ الفقه والسياسة – ص149
[8] ينظر في ذلك على سبيل المثال بثينة الجلاصي/ الاجتهاد والنص في الفكر الأصولي من تقديس النقل إلى تسريح العقل
[9] د.عز الدين السليماني / النص القرآني والإجراء العلماني للمقاصد – ص97