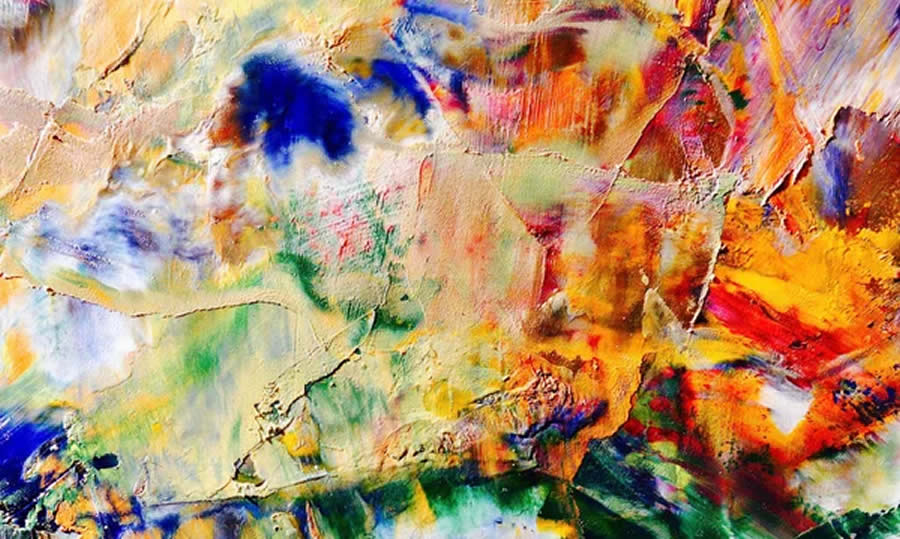ليس اللجوء مجرّد ظاهرة اجتماعية أو نتيجة حتمية لنزاع سياسي؛ ولا هو ملفّ حقوقيّ يمكن تدبيره بقرارات المنظمات الدولية أو بلاغات التضامن الموسمية. لا، إنّ اختزال أزمة اللاجئين في أبعادها الإدارية أو الإغاثية لا يفعل سوى تعميق الجرح، لأنّه يتعامى عن الطابع البنيوي لهذه المأساة. فاللاجئ ليس شذوذاً عن النظام العالمي، بل هو نتاجه المباشر، مرآته المعتمة، وضحيّته التي تفضح هشاشته.
من هنا، يكون دور الفلسفة غير قابل للتأجيل، لأنّ الفلسفة، حين تخرج من برجها العاجي وتتمرّد على مقامها الأكاديمي، تصبح فعلاً مقاوماً، وموقفاً تحررياً، وصوتاً للذين لا صوت لهم. إنّها، كما أرادها بعض حكمائها، صوت المقموع في حضرة المنتصر، وصرخة المعنى في وجه السيولة التي تحوّل الإنسان إلى فائض وجوديّ.
الحديث عن اللاجئ، إذن، ليس حديثاً عن ضحيّة، بل عن جهاز إنتاج للضحيّة، عن منظومة تصنع المنفيّ كما تصنع البضائع، وعن حداثة لم تعد قادرة على توفير مأوى حتى للإنسان الذي أنتجته.
ليست بداية أزمة اللجوء كما توهّم البعض مرتبطة فقط بتاريخ الهجرة من المستعمرات نحو المركز الأوروبي، بل كانت منذ بداياتها الأولى دليلاً على انهيار العلاقة العضوية بين الفرد والمكان، بين الذات والتاريخ، بين الهوية والوطن. لم تكن المسألة مسألة انتقال جسدي، بل تفكك رمزي، وتشظٍّ وجوديّ جعل من الشتات شرطاً إنسانياً جديداً.
لقد افتتح اللاجئ، من موقعه المنفي، عصراً لم يعد فيه الانتماء بداهة، ولا الهوية ثباتاً، ولا الوطن حماية. ومن هنا فإنّ الشتات لم يكن حالةً طارئة بل تحوّل إلى منوال وجوديّ جديد، كما بيّن باومان حين أشار إلى أنّ العيش مع الغرباء صار “شأناً يوميّاً”. لم يعد الغريب آخرَ طارئاً، بل هو الوجه الجديد للذات نفسها وقد فقدت كل يقين وكل مركز وكل سياج رمزي.
الحداثة السائلة، كما نعتها باومان، أفرغت المجتمعات من بنياتها الضامنة، فحوّلت الفرد إلى وحدة معزولة في بحر من التحوّلات. وهذه السيولة لم تكن إلا تعبيراً عن انهيار الدولة الحديثة، لا باعتبارها جهاز قمع، بل باعتبارها آخر مؤسّسة كانت تعد الإنسان بحقّ في الحماية. أمّا اليوم، فالسلطة تنسحب، والمؤسسات تتآكل، واللاجئ يُترك عارياً إلا من اسمه وذاكرته.
إنّ الحديث عن اللجوء لا يستقيم دون الإشارة إلى تلك البنية العالمية التي تُنتج التهجير كما تنتج الثروات، والتي تجعل من التنقّل ترفاً للغرب ومنفىً للشرق. فالعولمة لم تكن أبداً وعداً بالحرية، بل نظاماً معولماً للتمييز والتنقّل الانتقائي. “السرعة”، كما يقول باومان، لم تعد ميزة تقنية، بل أصبحت أداة سيطرة، إذ تمنح القوي قدرة الإفلات وتترك الضعيف عالقاً في طين الجغرافيا.
تستخدم القوى العولمية “اشتراكية التباعد”، تبتكر وسائل الانفصال لا اللقاء، وتجعل من حركة اللاجئين عاراً لاجتماعات القبائل المتحاربة في الدول الفاشلة. هكذا يترك الهارب من الجحيم ليُستقبل في الجحيم الآخر: جحيم الحقد الاجتماعي، والنبذ القانوني، والتسييج السياسي.
اللاجئ لا يدخل مجرّد حدود جغرافية، بل يدخل فضاء الشك، فيُحوَّل فوراً إلى تهديد، لا بسبب ما فعله، بل بسبب ما يمثّله: الغريب، المختلف، غير القابل للإدماج في نظام يسعى إلى التجانس القسريّ باسم الأمن.
لقد عبّرت حنّة آرنت بدقّة عن هذه الوضعية حين قالت إنّ اللاجئ “بلا عالم”، ليس فقط بلا وطن، بل بلا اعتراف. اللاجئ ليس فاقداً لحقوقه لأنه خرق القانون، بل لأنه لم يعد معترَفاً به كـ”شخص”. هكذا تتحوّل الحقوق من كونها طبيعية إلى كونها مشروطة بالانتماء، وهكذا يصبح وجوده بحدّ ذاته مشكلة سياسية.
في لحظة ما، تصبح إنسانيتك مرهونة بجواز سفر، بصفة قانونية، بمكان إقامة. وفِي غياب ذلك، تخرج من العالم، تصير فائضاً بشريّاً، حطاماً في بحر السياسات العقيمة. ولذلك فإنّ سؤال الهوية ليس ترفاً فلسفياً، بل هو مسألة حياة أو موت. والهوية ليست معطى ثابتاً بل هي جرح مفتوح، ذاكرة مقاومة، ورغبة في أن تكون حيث لا يريد لك النظام أن تكون.
الخوف السائل – ذلك المفهوم المفتاح عند باومان – يشرح كيف تحوّل اللاجئ من كائن يحتاج الحماية إلى تهديد صامت. إنّ ما يخيف المجتمعات الحديثة ليس اللاجئ في ذاته، بل رمزيّته: هو الفشل المتحرّك لنظام يدّعي الكفاءة. ومن هنا فإنّ سياسات الدول لا تتعامل معه كمحتاج بل كمشتبه به، فتسارع إلى “احتوائه” لا رحمة به، بل حماية لنفسها منه.
في المجتمعات التي تسكنها الهشاشة، يصبح اللاجئ كبش فداء جاهزاً، يحمّله الخطاب القوميّ مسؤولية الفقر، والبطالة، والعنف. يتغذّى هذا الخطاب على الخوف، ويعيد إنتاجه إعلامياً وسياسياً، ليبرّر الإقصاء والعنف باسم الهوية الوطنية. هكذا تُخاض الحروب الرمزية ضدّ من لا يملكون حتى حقّ الرد.
لقد تحوّل اللاجئ إلى “مفعول به دائم”، لا حق له في الفعل ولا حتى في التمثّل. تصوّره السلطة كخطر، ويقدّمه الإعلام كرقم، وتختزله السياسة كملفّ. إنّه الغريب المستمر، الذي لا يُحتمل لا بسبب فعله، بل لأنّه يعكّر صفو التجانس الذي تتوهّمه الدول لنفسها.
في قلب هذا الواقع، تنكشف الحداثة على حقيقتها: ليست مشروع تحرّر، بل جهاز إنتاج للتمييز. ليست وعداً بالكرامة، بل نظاماً صارمًا لفرز البشر. ليست قطيعة مع البربرية، بل طريقة جديدة في إدارتها.
ومع ذلك، فإنّ المعنى لا يُستسلم. ففي قلب هذا النفي الكونيّ للإنسان، تظهر مقاومات صغيرة، أصوات هامشية، محاولات لاستعادة الحقّ في الحضور. حتى اللاجئ، وهو في أقصى درجات الهشاشة، يحمل في صمته رفضاً للمنفى. ومهما بلغ العراء قسوته، تبقى إمكانية استعادة المكان والهوية قائمة، لا كمُعطى، بل كمشروع حياة.
فاللجوء ليس فقط مأساة، بل هو أيضاً سؤال فلسفي: هل يمكن أن تكون إنساناً دون مكان؟ هل يمكن أن تحتفظ بكرامتك وأنت منفيّ عن كل سياق؟ وهل تستطيع السياسة أن تستعيد بُعدها الأخلاقي في زمن السيولة والمصلحة؟
ربما لا نملك جواباً نهائياً. لكنّ مجرّد طرح السؤال هو فعل مقاومة. ومَن يسأل من موقع اللاجئ، هو في قلب الفلسفة، في قلب المعنى، في قلب العالم الذي رفضه.
“نحن خسرنا موطننا، وذلك يعني ألفة الحياة اليومية. نحن خسرنا عملنا، وذلك يعني الثقة في أننا مفيدون في هذا العالم. نحن خسرنا لغتنا، وذلك يعني طبيعة ردود الفعل، وبساطة الإشارات. نحن تركنا أقاربنا في الغيتوهات، وأصدقاؤنا قُتلوا في المحتشدات، وذلك يعني تمزّق حياتنا الخاصة”
(حنّة آرنت)