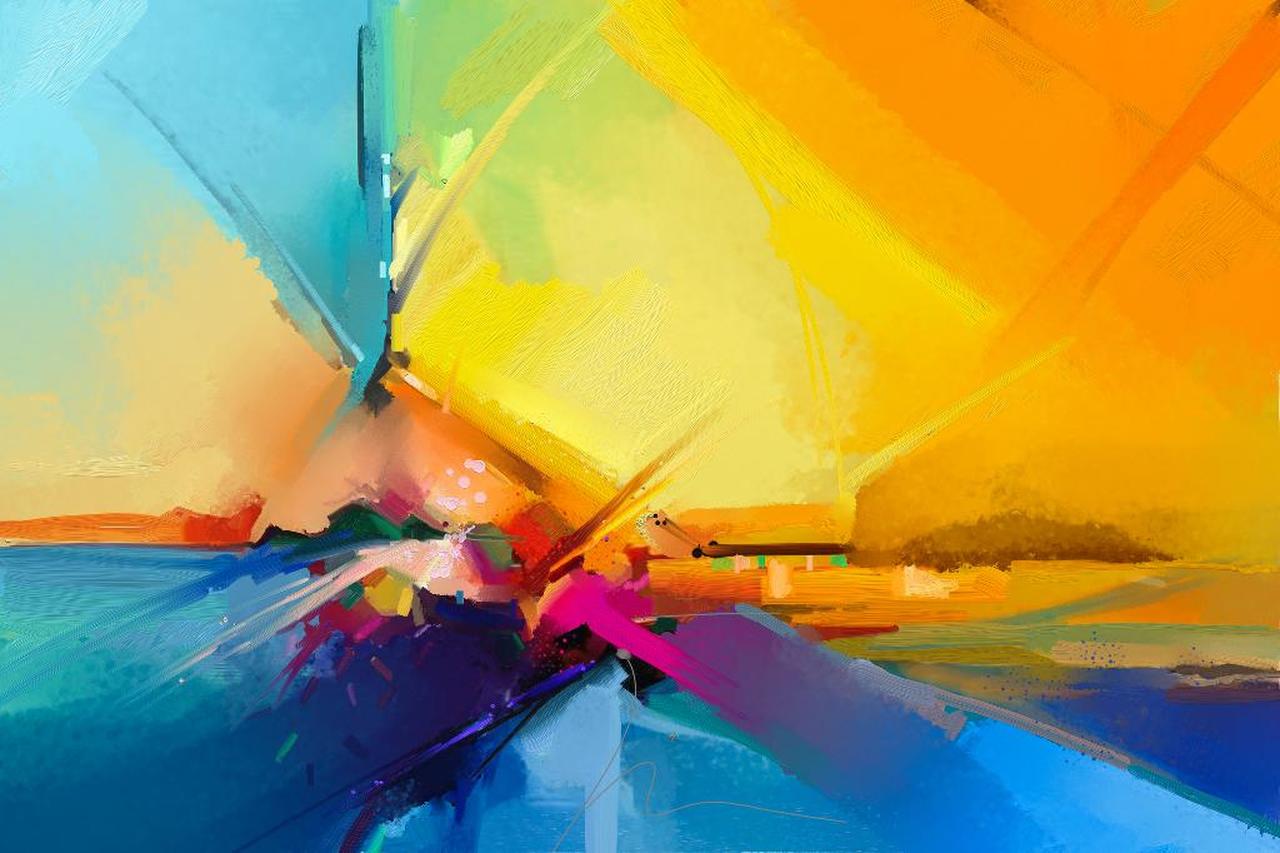مفتتح:
صارت بنينة الكلام وتنظيم الكتابة وإثخانها بالمقصديات وحيل اللغة...والتناصات والمضمرات من مشاغل التنظير والتحليل النقدي الحديث ..ولم تعد خطورة الخطاب كشبكة من الأنساق المشكلة بحرفية وذكاء مقصورة على فئة النخبة التي تتداول صيغه.. بل انتبه منتجوه إلى قوة تأثيره على الجماهير وفي مجالات شتى. ..خاصة ووسائل التواصل المعاصرة أتاحت الفرصة لمنتجين جددا ومستهلكين من نوعيات جديدة في البروز..هذا الحوار يتناول بعضا من هذه القضايا وينعطف إلى غيرها ..في سياقات شديدة الإمتاع والإفادة.
1- السؤال الأول: لعل خطورة كل خطاب هي في بنية مضمراته. كيف واجه النقد تفكيك هذه المضمرات؟
الإجابة: أستطيع أن أقول لكم، انطلاقا من قراءاتي المتواضعة في مسار ثقافتنا العربية الإسلامية قديما وحديثا، ثم انطلاقا مما قرأته وأقرأه باستمرار عن الآخر الذي يقرأنا باستمرار ولا ينفك يكتب عنا ويتابعنا في أدق ما نفكر فيه؛ أستطيع أن أقول لك انطلاقا من هذين المُعَطَيَيْنِ المتقابلين، بأننا بعيدون كُلَّ البُعْدِ عن مثل هذا المقصد: أن نَبْلُغَ تفكيك المضمرات العميقة التي تحملها الخطابات المعاصرة؛ سواء تلك التي يكتبها العرب من المبدعين، أم تلك التي يكتُبُها الغربيون.. وهذه بالذات أؤكد لك أننا نادرا ما نعرفها، وإذا عرفنا البعض منها، فإننا نادرا ما نُقْبِلُ على قراءتها، فبالأحرى أن نُفَكِّكَ مُضْمَراتها.
ومن الأسباب التي قَوَّضَتْ هذا المسعى، سواء تعلق الأمر بالخطابات المكتوبة باللغة العربية أم تلك التي أنتجها أصحابها بلغات أخرى (الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو غيرها من لغات جنوب شرق آسيا..)، ضعف القارئ العربي في الإلمام باللغات؛ وهي المفتاح الأول إلى فتح مغالق تلك الخطابات، ثم تأتي بعد ذلك أدوات قراءة الخطاب؛ وهو ما لم نمنحه الأهمية الأساس في تعلماتنا، وكذا تعلمات أبنائنا..
طبعا لا ينسحب هذا الأمر على جميع الدارسين العرب، فهنالك من يمتلكون اللغة، ويحوزون أدوات تفكيك الخطاب، إلا أنهم قلة قليلة، في مقابل ما يُنْشَرُ كلَّ يوم من أشكال الخطاب، وهي ملغومة تُضْمِرُ في بطونها ما لا حصر له من الأفكار؛ سواء ما يفيد منها ثقافتنا ويساهم في تطورنا، أم ما يسعى إلى هدم حضارتنا وإخضاعنا.. والغريب في الأمر أن كثيرا من (المثقفين) يسعون جاهدين إلى إشهار والترويج لعدد من الخطابات (المسمومة)، وهم لم يكلفوا أنفسَهُم حتى عناء قراءتها، فبالأحرى تفكيك مُضْمَراتِها والكشف عن مقاصد مؤلفيها.. إن الأمر في غاية الخطورة، وهذا ما يجعلنا نختلف عن غيرنا، أولئك الذين يعملون جاهدين على قراءة ما يكتُبُهُ مفكرونا من خطابات، ويسعون سعياً حثيثاً إلى فهم ما تنطوي عليه من الأفكار، بينما لا نقوم نحن بذلك..
ومن هنا، يبقى النقد العربي، أو لِنَقُلْ مناهج القراءة في ثقافتنا، دون التطلعات التي وجب أن تكون عليها.. إننا الأمة التي أمر الله سبحانه وتعالى رسولَهُ الكريم (صلى الله عليه وسلم) بفعل (اِقْرأْ)؛ والأسف أننا بقينا الأمة التي لا تقرأ، وهذا لَعَمْرُكَ ما صَنَعَ الفرقَ بيننا وبين غيرنا؛ حين أمْسَكْنا عن ممارسة هذا الفعل بكل ثقة ومسؤولية وتفانٍ.. ولا زالت القراءة وستبقى الحاجز بيننا وبين بلوغ مُضْمَرات أيِّ خطاب أيّاً كانتِ الجهةُ المُنْتِجَةُ له، أو مجال اشتغاله..
2)- السؤال الثاني: توارى الخطاب الشعري أو كاد، فيما علت راية الخطاب الروائي. ما السر من وراء هذا المُتَغَيِّرٍ؟ هل يتعلق الأمر بمكونات قبلية موجودة في تشكل الخطاب الروائي؟
الإجابة: هنا بالذات، لا بد من العودة إلى تاريخ الشعر العربي والأدب العربي بعامة؛ كي نفهم ما الذي حصل؟ وما السبيل إلى تفسير هذا الأمر؟ ذكر أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ (ت. 255 هـ) (رحمه الله) في كتابه (الحيوان)؛ وهو بصدد حديثه عن تَمَيُّزِ الأمم القديمة؛ بأن العرب برعوا في الشعر والبلاغة وفنون القول؛ وهو ما اعتمدوا عليه في تخليد مآثرهم، وذكر أيامهم وأنسابهم.. وحين جاء إلى الحديث عن أولية الشعر العربي، قال بأن الشعر حديث الميلاد، صغير السن؛ عُمُرُهُ خمسون ومائة عامٍ، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام..
وذكر أبو عمرو بن العلاء (ت. 154 هـ)، وهو من أهل العلم بالشعر، بأن الشعرَ علم قوم لم يكن لهم علمٌ أَصَحُّ منه، وكذلك تابعه في هذا الاهتمام والإعلاء من شان الشعر الكثير من العلماء العرب القدامى.. غير أن هذا الذي عرفناهُ فيم لُقِّنا إياه، مخالف تماما لأمور أخرى، عرفناها فيما بعد، حين اطلاعنا على ذخائر العرب؛ ثَبَتَ لنا من خلالها أن الشعرَ كان فقط غيضاً من فيضٍ مما أنتجته العقلية العربية الإسلامية القديمة؛ بل والأدهى من ذلك أن العرب أودعوا في جنس النثر، من علمهم وفكرهم، ما لم يودعوه في معلقات الشعر وأوابد القصائد..
لماذا أذكر لك هذا؟ لسبب بسيط مفادُهُ أن العرب المسلمين اهتموا بالقوالب الحكائية، من أخبار وأنساب وحكي وغيره، أكثر من اهتمامه بالشعر. والذي ضَلَّلَ الكثيرين بخصوص هذا الأمر، الكثرة الكثيرة من الشعر، في مقابل قلة المنثور. وفي المقابل نجد أن تلك الكثرة الكثيرة من الشعر لم تتضمن إلا أمورا قليلة من الفكر والعلم، في حين أن القلة القليلة من النثر هي التي حَوَتْ فكرَ العرب وشهدت على استوائهم وبُعْدِ نظرهم في أمور شتى من مجالات المعرفة.. ويمكننا في هذا الصدد، العودة إلى كتب التاريخ والأنساب والتصوف، وكتب الفقه والأصول والكلام، بالإضافة إلى ما ألفه العرب في مجال الحكي والخبر والمقامات وأنواع القصص..
من هنا، إذن، لا أستغرب، ولا داعي لاستغراب أيٍّ كان إذا رأى بأن مساحة الشعر، في عصرنا الحالي، تتقلص لصالح مساحات احتلتها الرواية والأجناس السردية على حساب الشعر. هذا من جهة العودة إلى تأصيل هذه الفكرة. ومن جهة ثانية، لا بد من استحضار حضارة العصر التي لم تعد تَسْتَسيغ التعبير بالقوالب الشعرية عن مكنوناتها وهمومها؛ انطلاقا من أن المتلقي لم يَعُدْ يقرأ هذا الجنس الجميل الآسِرَ، وبالتالي قلت الكتابة الشعرية أو الإبداع بالقوالب الشعرية، ونما الإبداع بالقوالب السردية التي تبقى مساحتها أوسع وأرحب..
ودعني أقول لك، في ختم الإجابة على هذا السؤال، بأن القارئ العربي، للأسف، لم يعد يهتم لا بالمنثور ولا بالمنظوم؛ سواء اتسعت المساحة للأول وضاق الفضاء بالنسبة إلى الثاني؛ وَمَرَدُّ كُلِّ هذا إلى مشكلتنا العويصة: أننا الأمة التي لا تقرأ، سواء كتَبْتَ لها بماء الذهب شعرا أم سرداً..!! أما الذين يقرؤون من أمم أخرى، فإن مبدعيها، من النساء والرجال، لا زالوا يكتبون الشعر بكثرة، كما يكتبون السرديات بكثرة، ما دام في الأفق قارئ ظمآن إلى ما يُكْتَبُ..!!
3)- السؤال الثالث: عندما نذكر الخطاب فنحن- وأنتم أهل المعرفة- نتحدث عن نتاج علوم متداخلة: لسانية وبلاغية وفلسفية وعصبية ونفسية.. ومع تنوع مسارات الخطابات وأنواعها، نتحول إلى فرائس لمقصديات متوحشة في عالم تكاد تنعدم فيه البراءة! ما تعليقكم؟
الإجابة: هذه واحدة من الفراغات التي لم نُحْسِنْ مَلْأَها إبان تلقينا تعلُّماتنا الأولى. وهو الأمر نفسه الذي يُمارَسُ اليومَ على تلامذتنا في المدارس، وطلبتنا داخل الجامعات المعاهد العليا.. المشكلة، يا سيدي، كامنة بالذات في نوعية المعرفة التي نمنحها لمثقفينا، والكيفية التي نمنحهم بها تلك المعرفة، ثم أساليبنا في تفكيك الخطابات التي نقرأها؛ بُغْيَةَ إغناء المعارف التي نتلقاها..
لا أحد، اليوم، مَعْذور، بجهله أساليب قراءة الخطاب؛ أيّاً كان ذلك الخطاب. أنا لا أتحدث هنا عن عامة الناس؛ هؤلاء معذورون في هذا الشأن، والمسؤول الأكبر عليهم هو المثقف العالِمُ الذي هو مُطالَبٌ بأن يقرأ للآخرين الخطابات التي تروج في المجتمع، وقد تُسَمِّمُ أفراد ذلك المجتمع.. لِمَ يوجد في المجتمع أطباء متخصصون في علم الأوبئة؟ طبعا لمحاربة كُلِّ وباء يدخل المجتمع.. ولكن كيف تتم تلك المحاربة؟ تَتِمُّ محاربة أنواع الأوبئة، أولا عن طريق اليقظة الدائمة لأهل الاختصاص في المجال، وبعد اكتشاف الوباء تحت مرحلة البحث والنظر وتَعَرُّفِ الأسباب. ثم ينتقل المختصون إلى مرحلة وصف أنواع العلاج؛ من أمصال وتلقيحات وأدوية ناجعة..
ذاك هو، بالكمال والتمام، عمل المثقف داخل المجتمع. إنه المسؤول الأول والحارس المُتَيَقِّظُ الأمين لكل أنواع الخطابات التي تُنْتَجُ داخل المجتمع، أو تلك التي يَتِم تصديرها إلى مجتمعاتنا. فهو الذي يملك الأدوات والمعارف التي بمقدورها تفكيك الخطابات وقراءتها وتَعَرُّفِ ما تنطوي عليه من حَسَنٍ أو قبيحٍ. فإذا كان المثقفُ، وهو الذي يُعَوَّلُ عليه، غيرَ مالِكٍ لِكُلِّ هذا، بَقِيَ المجتمع، وسائر أفراده، عُرْضَةً للتدجين والتَّسْميم والاستلاب؛ بل وفي أحيان أخرى كثيرة شَقُّ عصا الطاعة على مجتمعه وأنظمته وعاداته وتقاليد وأنماط التفكير السائدة فيه..
4)- السؤال الرابع: حال الوعي بتقنيات الخطاب وسبل تأويله في العالم العربي.. هل هي في نظركم مطمئنة معرفيا؟
الإجابة: سبق لي من خلال جميع ما أجبت عليه من أسئلتكم أنْ عالجتُ هذا الأمر. وأضيف إليكم، في هذا الصدد، أننا في عالَمِنا العربي الراهن نعاني من مشاكل كثيرة. لا أقصد هنا مشاكل الفقر والصحة والديمقراطية ونقص الموارد والتَّبعِيَّة للغالِبِ حضاريا، كما قال ابن خلدون (ت. 808 هـ) (رحمه الله) في مقدمة تاريخه الذي لا أحد منا تقريبا قرأه أو حتى اطَّلَعَ عليه، ولكنني أقصد معاناتنا الفظيعة من مشكلة التعليم وزرع بذور الوعي السليم ومناهج النظر الفاعلة، بعيدا عن كل اختلافاتنا ومذهبياتنا التي فَرَّقَتِ العرب، ومنذ أمَدٍ بعيدن مِلَلاً ونِحَلاً..
التعليم، يا سيدي المحترم، هو الخلاص بالنسبة إلى كل أُمَّةٍ، ترغَبُ في أنْ يكون لها مقعد في الصفوف الأولى من المتميِّزين.. وطبعا ليس أيُّ تعليم، وإنما هو التعليم الذي ينطلق من منابع الأمة الصافية وانتظاراتها، سواء الدينية منها، أم الاجتماعية، أم السياسية، أم الفكرية.. نحن في حاجة إلى تعليم يمكنُنا من الأدوات ومناهج القراءة، وكثير منها موجود في معارفنا، بالإضافة إلى ما أنتجه الآخرون؛ وهو مناسب لنا لصُنْعِ إقلاعِنا كما صَنَعَتْهُ دُول صغيرة جدا، كانت في أدنى مراتب الفقر والقهر؛ فكان التعليمُ مُنْقِذَها من كُلِّ ما كانت تعانيه؛ وهنا بالذات أشير إلى دول مثل الكوريتيْن الشمالية والجنوبية، وسنغافورة، واليابان الخارجة من حرب مُدَمِّرَةٍ أتَتْ على الأخضر واليابس..
هذا التعليم المتميز الذي يقوم على مناهج ورؤى وأدوات ووسائل وأخلاق، هو الذي سيمكن الإنسان العربي، الآني أو الآتي، من تَأَوُّلِ ما يُنْتَجُ بدارِهِ من خطابات؛ بل وسيكون، بعد حين من الزمن، قادرا على إنتاج خطابات في مستوى منافسة الآخرين..
5- نحن الآن تحت أنظار قراء موقع "أنفاس " الكرام ..بماذا يود الدكتور مصطفى سلوي أن يختم هذه الحلقة من هذا الحوار؟
انطلاقا من كل هذا، ولا أريد أن أكون متشائما، وأنا في الأسطر الأخيرة من هذا الحوار الجميل الشائق الذي أشكركم عليه خالص الشكر، كما أشكر هذا المنبر الكريم الذي خَصَّني بهذه المساحة؛ قلت لا أريد أن أكون متشائما، ولذلك أقول: أنا من الذين يأملون الخير في هذا الجيل، بالرغم من كلِّ ما يُقالُ عنه، إذا وفرنا له الأرضية السليمة، والأدوات، والرؤية الواضحة؛ وكُلُّ هذا يحتويه (تعليم) له مواصفاته القبلية؛ تلك التي تجعل من هذا الجيل والأجيال التي ستأتي بعده، أمة صاعدةً؛ لا تعيش فقط لأجل أن تعيش، ولكنها تعيش لتنافس وتُسابِقَ الآخرين.. وليس هذا بالأمر العزيز على أمة الخمسة عشر قرنا من المعارف والمناهج؛ فقط هي العزيمة، والإرادة الصادقة، والرؤية الواضحة، والوسائل التي تُمَكِّنُ من النهوض، بالإضافة إلى الأخلاق العالية المقترنة أساسا بحب الوطن والسعي لنهضته وتفوقه..