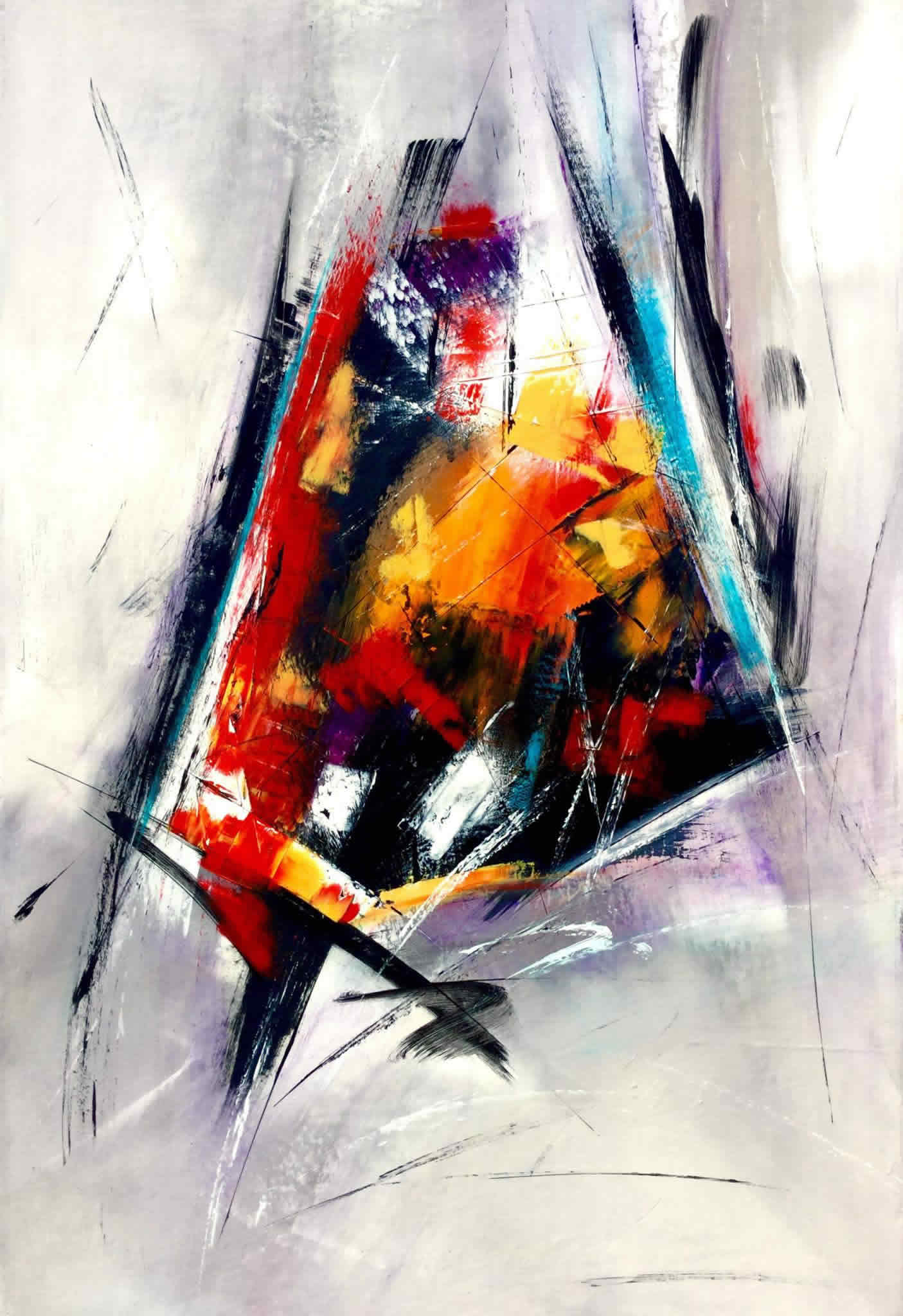بداية لا يمكن لأحد أن ينكر ما لوسائل التواصل الاجتماعي من دور في انتشار المعلومة ومشاعيتها، إذ أصبحت المعلومة مشاعة بين كل الطبقات وفي كل الأزمان الأصقاع والبقاع.
ثم إنه لا ليس بإمكان أحد - إلا جاحد - أن ينكر ما كان لها من دور في اندلاع الثورات – المجهضة في أغلبها، والناجحة نسبيا في بعضها- حيث كانت الوسيلة الفعالة لتكسير الخوف بداية والتحرر ثانيا والحرية الموقوفة التنفيذ ثالثا، إذ لولا تلك الوسائل لكان الواقع العربي على الخصوص والعالم بشكل عام قد زاد قهرا واستبدادا وتنكيلا دون علم من أحد إلا ما تسرب من عين الإبرة من خبر.
وانطلاقا من قول "نتشه" على أن الحقيقة مزعجة، لذلك يفضل الجميع البحث عن الحقيقة التي لا تزعجه، وليس هناك من فضاء بإمكانه أن يوفر هذه الإمكانية سوى فضاءات التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي أصبحت دون منازع الفضاء المفضل لتسوق الحقيقة، لأن العرض جد متوفر.
ثم إن هذه الوسائل قد أتاحت لعامة الناس على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية والمجتمعية إمكانية التعبير عن آرائهم وينشروا ما يحلوا وما لا يحلوا لهم من أفكار وأخبار قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة فذاك غير مهم كل ما هنالك هو النشر لأجل النشر.
انطلاقا من هذا العنصر الأخير تأتي أهمية هذا المقال الذي سيحاول تأمل العرفة التواصل-اجتماعية وما يعتريها من نواقص تجعل من الحقيقة الضحية الوحيدة. هذه الأخير التي كانت إلى يوم قريب لا يصل إليها إلا الأشداء لتصبح اليوم كدمية يتلاعب بها بين فاعلين كثر ومختلفين، في الوقت التي كانت تحدد قائمتهم وبعناء شديد، ولن يحظى أي كان بشرف البحث عنها واللقاء بها. إن الوضعية هذه جعلت الرؤية وطريق الحقيقة مضطربا وشاقا وذلك لغزارة "الحقائق" وتعددها بتعدد المنتجين لها، وخلفية كل من منهم من إنتاجها، ثم كذلك نظرا لغياب الرقابة وانتفاء القيود على تلك الفضاءات على خلاف ما كانت تتميز به طريق الحقيقة فيما قبل إذ كانت كلها ضوابط منهجية وعليمة وثقافية ومجتمعية جعلت من الحقيقة حصنا منيعا لا يسهل على أي كان، إن هذه الوضعية تجعل الإشكال الطبيعي ينبثق وهو كيف السبيل إلى الحقيقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل أصبحت الحقيقة مبتذلة لهذه الدرجة، إذ أصبحت خاضعة للمزاد "الفايسبوكي" و"التويتري" و"الأنستغرامي" ...؟ ألهذه الدرجة أصبحت الحقيقة تقاس بقدر قدرتها على الإنتشار وتحقيق "البوز"؟ أين الشرعية العقلية والمنطقية والتجريبية والواقية والعلمية ... التي كانت الحقيقة والباحث عنها يخشون اختبارها؟ أين القيمة المقدسة التي كانت للحقيقة -بغض النظر عن مجالها ومنتجها-؟ وأين وأين ...
إن الحقيقة عاشقة التخفي ومغرمة به، وذلك سبب صراعها مع أضدادها وكذلك سبب إتعابها للمغرم بها والباحث عنها، إنها تتعبه لكي يسعد بلحظة اللقاء وينتشي بلحظة الانكشاف والقبض على بعض أطرافها، وبذلك تتحقق لها غايتها وتمنح لنفسها القيمة اللائقة بمقامها. لكن للأسف أصبحت اليوم "عاهرة" تتجول بين أوكار رقمية فهذا يعجب بها بالضغط على أيقونة ( Jaime) وهذا يحبها بالضغط على (J’adore) وهذا يبكي عليها بالضغط على (Triste) وهذا يستهزأ منها وذلك بالضغط على أيقونة (Ha Ha Ha) ...
إن الحقيقة وإن كانت إلى يوم قريب يسافر من أجلها ولأجلها فهي اليوم تعرض نفسها على كل الناس حتى الذين لا يرغبون فيها، فمنهم من يفتح الباب ولو شق منه لرؤيتها ومنهم من يشفق لحالها فيدخل عليها لأنه تأثر بمفاتنها، لكنه سرعان ما يجدها بمنظر بشع تبعث على التقزز والنفور فينفر منها وقد يقرر هجرانها.
إن الوضعية هذه، أكيد، ستكون لها نواتج نفسية تربوية اجتماعية حضارية ... هذه النواتج هي التي يمكن أن نجيب عنها من خلال السؤال التالي: ما طبيعة الإنسان الذي سيعيش في ظل غياب حقيقة يمكنه الاستناد عليها ولو مؤقتا؟ ما مصيره في ظل حقائق أشبه بالعاهرات؟ أيمكنه أن يدرك معنى الحقيقة؟ أم أننا نعلن موت الحقيقة؟، بالجملة إن موت الحقيقة بمعانيها السامية يعني موت الإنسان، الكائن المنتج للحقائق مطلقة كانت أو نسبية، إنه الباحث العاشق لها مهما كانت وحيثما كانت. لأن الإنسان دون حقائق أو على الأقل دون عناء وشوق ومكابدة وحينين لبلوغها هو بلا معنى.