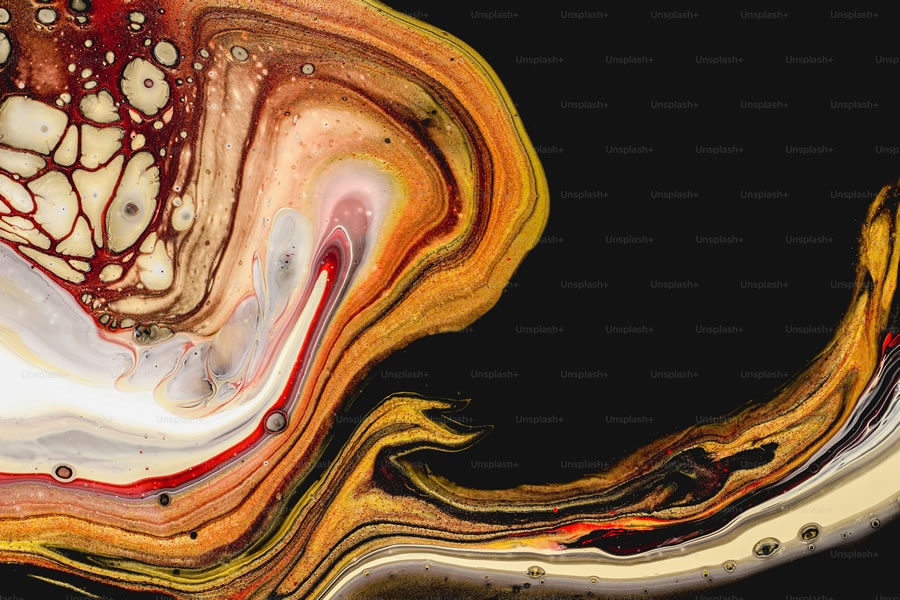شعرها مشدود إلى الوراء على شكل ذيل حصان يتدلى كشلال ماء بلونه الخرنوبي الجميل، تبعثر ما تناثر منه فوق عنقها وكتفيها. كانت بين الفينة والأخرى تخلل أصابعها في خصلاته لتعيده إلى الوراء، فيرتمي فوق كتفيها.
تذرع رواق المحكمة بتصميم عجيب، في يدها اليمنى حقيبة جلدية سوداء منسجمة مع لونيْ تنورتها القصيرة وحذائها ذي الكعب الرقيق العالي. وباليد اليسرى أمسكت ملفا كرتونيا ضاجا بالوثائق والمستندات والشهادات وتقارير الخبراء والفنيين.
تمشي محدثة ضجة بدقات حذائها ذي الكعب الحاد، الدقات الموقّعة تلفت أنظار العابرين إليها. تتجه نحو مكتب معلوم دأبت التردد عليه منذ اتخذت قرارها بأن تسترد ما يحاول الآخرون اغتصابه منها. عرفت التفاصيل المؤدية إلى ذلك المكتب، وتدربت على مسك مقبض الباب النحاسي اللماع. صارت تدخل دون استئذان. كانت في البداية تطرق على الخشب الأبنوسي ثلاث طرقات موقعة. تنتظر كلمة "تفضل" لتعبر الباب بكامل أناقتها وتغمر المكان بضجيج عطرها وأنوثتها التي لم تقدر الهزات على محو آثارها.
تمشي وفي رأسها أتون يتأجج وبركان من الغضب ما زالت حممه تتآكل في جوفه باحثة عن فتحة مؤدية إلى الفوهة لتنفلت الحمم من الجوف فتلتهم كل ما يقع في طريقها. هي تدرك أنه إن انفتحت الفوهة واندفعت الحمم فإنها ستلتهم كل ما يعترضها. في جوفها وبين جنبيها تستعر مساحة ممتدة من الحقد والنقمة والكراهية. صار كل شيء أمامها عابسا بلون الحزن المكدس على قلبها.
زارت مكاتب كثيرة لخبراء محلفين وغير محلفين، ومنحوها شهائد وتقارير. وأضافت إلى كل شهادة شهادة تؤكد صحتها ومختومة وموقعة. بعض التقارير يقسم أصحابها ويوقعون أن تلك الوثائق لا لوثة فيها ولا تدليس.
أحضان الوطن مفتوحة لي، ولكن قلبي لا يزال غريبًا – قصة: سارة صديقي
سلّمت ورقة اختبار اللغة العربية للمعلمة الواقفة بجانبي، فخربشت في ورقة التوقيع بسرعة، ثم حملت أغراضي وخرجت بخطوات بطيئة، أجرّ قدمي جرًّا. وقفت أعلى الدرج وتنهدت تنهيدة طويلة. كانت صديقتي سلمى تنتظرني في الساحة الخارجية، نظرت إليها ونظرت إليّ، جلسنا لدقائق معًا، ثم خرجت بعد أن سمعت اسمها عبر جهاز الميكروفون. ودّعتها غير مصدقة أن هذا سيكون آخر لقاء بصديقتي الحبيبة.
كنت قد طلبت من والدي أن يتأخر قليلًا حتى أشبع نظري بزوايا المدرسة. جلست أتأمل وجوه التلميذات اللواتي اعتدت رؤيتهن طيلة أربع عشرة سنة، كبرت معهن وعشنا تجارب الطفولة معًا. قد نختلف كثيرًا، ولكن شيئًا ما في العِشرة الطويلة يجعل الفراق مؤلمًا. أحسست بشعور غريب، وكأنه ألم في قلبي.
سمعت اسمي، ثم وقفت وألقيت نظرة الفراق الأخيرة، وارتديت عباءتي ونقابي ببطء، لعلي أطيل دقائق الوصول قليلًا. تنهدت مرة أخرى، ولما ركبت السيارة التفت لرؤية الباب، كانت تلك المرة الأخيرة التي أراه فيها يبتعد عني وأبتعد عنه.
مرت فترة ليست بطويلة، وعدت إلى وطني. اليوم هو يوم جديد. تباطأت اليوم مرة أخرى، ولكن هذه المرة لعلي أبطئ ساعة اللقاء الجديد. ذلك الألم عاد إليّ مرة أخرى، وكأنني تلميذة في الصف الأول الابتدائي. يا ليت سلمى معي اليوم! تمنيت لو أرى ابتسامتها الجميلة وأستمع إلى أحاديثها الممتعة. مسحت بسرعة دمعة صغيرة تسللت إلى وجهي قبل أن يراها أحد.
ارتديت عباءتي وجلست في السيارة. من هم هؤلاء؟ ومن أساتذتي؟ وأين مؤسستي؟ لقد اختلف الطريق، واختلف الباب، واختلفت الوجوه. أين سلمى؟ أين الفصل؟ وأين تلميذات الفصل؟
قلب الشاعر - شعر: منى مرسل
تحجرٌ في حلم وحيد
يحرسه الخوف من الحياة
يقبض الرماد عليه
صهوة قلبه
ويتضاءل كشبهةٍ تطرق سحابة بوح
ثم تجرح اكتمالها
فتور الذاكرة.
تتآمر العربات على سفك طرقاته
يتآكله زمنٌ مؤقت
بمزاجية البحر
لا تقرأ هذا الإعلان – نص: فراس ميهوب
معروض للبيع، فمن يشتري؟
وطن عمره آلاف السنين، كتبت فيه أول أبجدية، في قلبه بنيت حضارة صحرواية، أعمدة طويلة، مسارح رومانية قديمة، أسواق عريقة رائعة، مدفن أول نبي.
بحرٌ جميل، جبل شامخ، أنهار طويلة، وسهول خيرة.
وطن قدماه سومريتان، قلبه عربي، ورأسه تائه بين الأمم.
فقد نصف أرضه في صراع الأمم، ينتظر ضياع النصف الآخر في فتنة الأهل.
من يشتري وطنا؟
غلبه التنافر والتناقض، كفرت به الأديان، و جننته الأفكار، وثملت عينيه القوميات.
من يشتري وطنا؟
أرضه غنية بالنفط، وبحره يطفو على الغاز، وشعبه جائع، ضائع.
فيه ألف قبيلة، ولا يوجد فيه مواطن واحد.
حدوده الرماح المتصارعة، والدماء المسفوكة.
من يشتري وطنا؟
حديث رجلين – قصة: أمينة شرادي
كانت عيادة الطبيب غاصة بالمرضى. كل ينتظر دوره. كانت هناك حالة من الصمت التي خيمت على المكان. لا تسمع سوى صوت التلفاز المعلق أعلى الحائط كأنه رقيب على حركة كل واحد منهم. في الجانب الأيسر من قاعة الانتظار، كان رجلان، منسجمين في حديث طويل. لا يعيران أي اهتمام لأي حركة داخل القاعة. كانا ينتظران أيضا دورهما.
كانا يلبسان لباسا تقليديا. يبتسمان تارة وتارة يصمتان. أحيانا ترى أيديهما في صراع مع الكلمات كأنهما في مرافعة وكان كل واحد منهما يريد أن ينتصر.
قال الأول صاحب الجلباب الطويل وداكن اللون ورفيع الجسد وحاد النظرات:
-لقد أصبحت المعيشة لا تطاق. لا يحتمل ما نعيشه اليوم.
ابتسم الثاني، قصير القامة، بجلبابه الفضفاض وطيب الملامح:
-صحيح، في السابق، كنت أستطيع أن أشتري الخضر واللحم بمائة درهم.
أجابه الرجل الأول وهو يضرب كفا بكف:
- تقاعدي لم يعد يكفيني حتى لمسائلي الشخصية. حتى تكلفة زيارة هذا الطبيب لم أستطع دفعها. لولا مساعدة ابني المسكين الذي يشتغل في احد المصانع.
ابتسم الرجل الثاني وقال له:
ولدك طيب معك. الله يخليه لك.
استوطن الصمت المكان. نظرات غامضة وغير راضية لا على الانتظار الذي طال ولا على وضعيتهما.
ثم أردف الرجل الثاني وقال له:
أتدري كم وجدت ثمن زيت الزيتون اليوم؟ لا تصدق.
- كم؟
- مائة وعشرون درهما. انه الجنون. يظلون يغنون في الإذاعة والتلفاز بأهمية الزيت البلدي وضرورة استهلاكه. كيف يمكن ذلك اليوم؟
وتجهم وجهه بعدما كان شعلة من الفرح والرضا. ونظر الى الأرض كأنه يبحث عن شيء فقده.
سأل الرجل الأول السيدة التي في الاستقبال عن دوره. أجابته بانه سينتظر قليلا.
فرك يديه ومسح وجهه ولحيته واستغفر الله. ثم قال للرجل الثاني:
- لم أعد أستطيع شراء زيت الزيتون. انه غالي جدا والمسكين في هاذ البلاد يضيع.
- إذا رغبت نشترك في لتر واحد ونتقاسمه بيننا حتى لا نحرم منه.
المعادلة الصعبة – قصة: محمد محضار
" معظم حياتنا مصادفات، ترتبط بأحداث لا علم لنا بوقائعها، وإن كُنّا نسعى لِتدبّر أَمرها بترتيب سياقاتها، هي الحَياة هكذا فَهْمها عَصِي على المرء مهما ادّعى القدرة على حل شفرتها وتفكيك مخرجاتها، وأنا طيلة سنوات عمري الماضية عشت فصولا مترابطة ألهتُ وراء وَهْمِ الإحَاطة بِشَواردها وأَلجِمَتها، لكنني فجأة وفي لحظة سَهْو غريبة وجدتني أزيغُ عن جادة الصواب وأفقد البوصلة، فبعد أن كنت " رأسا" صرت "قدمين".
أنا علال بن مثقال المفوض القضائي الذي كان يطرق أبواب الناس حاملا لهم استدعاءات المحاكم، وأُوافِيهم برسائل التَّبليغ والإشهار، ويتهافت المتنازعون على طلب خدماته، أفقد على حين غرَّة هذه الصفة، وأنقلب إلى مشبوه متورط في قضية تَزوير مُلفّقة انتهت بي إلى العزل، بعد الصَّدمة جاءت الصَّحوة، وإذا بِي دون مورد عيْش، وقَلبتْ لي الأيام ظَهر المجن، وانفضّ من حولي المتهافتون، وطلبت عَقيلتي الطَّلاق وهي غير نَادمة، وعندما ناقشتها في الأمر صَمَّتِ الأذان، فكأنها الحَجر الصَّلد، لا جواب ولا تجاوب، إلا الخذلان وخيبة الأمل، قتلتني بدم بارد ولم تَرْع عشرة ولا تذكّرت ما فات بيننا من محبّة ومودة، فارقتها وآلتْ إليها حضانة ابنتينا، ومضيت إلى حال سبيلي أبحث عن مخرجات لوضعي المتأزم علّني أعثر على ما يعيد لنفسي نقاء وبساطة الأمس ويضمن لي فرصا جيدة تُجنبني براثن الانهيار"
كانت الظروف أقوى من علال بن مثقال، ولم ترحم ضعفه، واضطرته للنزول درجة ثم درجات، وحتى يستطيع أن يضمن لنفسه سيرورة مأمونة، رضِي بالعمل حارس أمنٍ خاص لضيعة واحد من علية القوم، معروف بأنه رجل أعمال وسياسة، استقل بمسكن ملاصق لمدخل الضيعة يحرس بابها، ويراقب الداخلين والخارجين، ويقدم يوميا تقريرا سرّيا لمُسيِّر الضَّيعة وهو كهل ضخم الجثة يتعامل بصرامة وحزم مع كل المشتغلين تحت إمرته ، ولا يتردد في معاقبة كل من يخرج عن السطر من منظوره، كان شعاره الدائم:" شوف واسكت، واللي تكلم يرعف"، كان على علال القبول بهذا الوضع والرضى بهذا المستجدّ، فهو صامت يرى ويسمع ولا يتدخل في أمر، البندقية الخماسية على ظهره وحزام الذخيرة يُمنْطِقُ وسطه، وهو أشبه بمقاتل يذرع المكان يحفظ الأمن و يحمي الدِيَّار، وينفذ التَّعليمات الصَّادرة إليه من مشغليه الذين أطعموه من جوع وأمنوه من خوف في زمن تنكر فيه له الجميع.
غربان بيض فوق الشام – نص: فراس ميهوب
دمشق في خاطر كل سوري هي الجامع المشترك لأحلامهم، وخيباتهم، يفتخرون بالإقامة فيها، ولو كانت في بيت متواضع مستأجر في دف الشوك أو القابون.
تمرُّ كل الطرق إلى دمشق بالصحراء الحقيقية أو المجازية.
ترى فيها بعض الأحياء الراقية، ولكن ينجذبُ نظرك إلى مساكن الديماس التي يتكدس فيها البشر كسردين مرتب، أشبه ما يكون بأحياء الفقر في ريودي جانيرو.
لا تثور دمشق، ولا تتغير بسهولة، هي كسوقها الأشهر -الحميدية- تشتري كل البضائع وتبيعها بنصف الثمن المعلن.
تستقبلُ الثائرين المنتصرين برؤوسهم الحامية، وتودع المهزومين بقلب بارد.
هي أرض لكل لاجئ، فلا يمضي فيها أربعين يوما حتى يعتقد أنه أطلَّ عليها من قاسيون، وعندما تودي به الأقدار إلى القارعة يصير جزءا من ماض رحل كأنه لم يوجد ولم يعش بها قط.
تعطي دمشق سكنا و أمانا بسهولة لكل من يطرق بابها، لكنها لا تمنح قبرا لأحد إلا بصعوبة بالغة.
ما أكثر من اشتهى وهما فلحق به في دمشق، وما أكثر من باعته من الميدان وحتى المالكي والمزرعة.
في دمشق يعرف الجميع أين يقع القصر الرئاسي، ومقر رئاسة الوزراء، بل تعرف الشوارع بمقرات الأفرع الأمنية، حتى فلسطين فيها تحولت إلى فرع أمني، لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بغدٍ ما فيها.
بعيدا عن القُبح، قريبا من الجَمال – نص: عبد الهادي عبد المطلب
"الجمال يولد بأشكال عديدة، فقط غيّر زاويتك وستراه في كل مكان" (س. فرويد)
الجمال مفتتح كل بداية، ومفتتح الوجود جمال.
1 ـ بعيداً عن التعقيد..
بعيدا عن الفلسفة وشطحاتها، وأسئلتها المقلقة حول الوجود والموجودات، وهي تزيد الجمال تعقيدا حين تحاول تفسيره تفاسير تُرضي الآلهة، وتُسكنه كتب وحكايات الملاحم والبطولات، بعيدا عن الشعر وهذيانه حين يتغنى بالجمال كلمات وصورا تُخندقه ولعا وشوقا وحرقات ودموعا ولهفة، تموت خنقا داخل الدواوين وعلى الأوراق.
بعيدا عن تلاوين الرسامين وشخبطات ريشاتهم المسافرة في اللون، وهي تُحيل الجمال خطوطا وخربشات تزيده تعقيدا حين تصبغه بأسماء المدارس، تكعيبا وتجريدا وواقعا، تعتمد اللون وضرب اللوحة، ثوبا أو حريرا، قاموسا وفنّاً.
بعيدا عن سرحان المريدين والعابدين والحالمين الباحثين عن الجمال في حلقات الذكر والتمسُّح بالأعتاب والتبرك باللحود والكرامات، بعيدا عن كراسي المدارس والمعاهد التي تُقزّم الجمال في جُمل وكلمات جوفاء تزرعها في قلوب المتعلمين كلاما وتمارين وأنشطة، بعيدا عن مراتع القُبح الذي غطى أبسط تفاصيل حياتنا، حتى أنمحى الجمال منا وفينا ومن بيننا، وأصبح غريبا، عملة نادرة، بل مفقودة، فلا نجده إلا مخبوءاً تحت مُسمّيات العيْب والحياء.
بعيدا عن النظرة القاصرة للجمال التي تراه في حوَر عينٍ أو زُرقتها، أو أهداب ناعسة، أو قدّ ميّاس أو نهدٍ كاعبٍ نافرٍ يثير الشَّهوة، بعيدا عن التعقيد والتّصنّع، والرياء والتظاهر والتفاخر الكاذب، فتلك نظرة كسيحة للجمال، بائسة وجيعة تبخس سر الجمال، وقيمة الجمال، لأن الجمال في حقيقته المثلى، قيمة تسمو بالإنسان والوجود.
2 ـ قريبا من الجمال..
نظرة إلينا، إلى محيطنا، إلى واقعنا، إلى ما نحن فيه من دُنُوٍّ من القُبح، تحكي بما لا يدع مجالا للريبة والشك، أن الجمال عندنا ـ للأسف ـ تقليدٌ أعمى، تظاهرٌ كاذب، امرأة بمواصفات دنيئة، وما سوى ذلك، عادي، لا جمال فيه، تلك نظرة فيها حوَل، عوَر، فيها عمش، نظرة بائسة لا تسبر غور الأشياء، ولا تنفذ عمقها لتستخرج لبها.