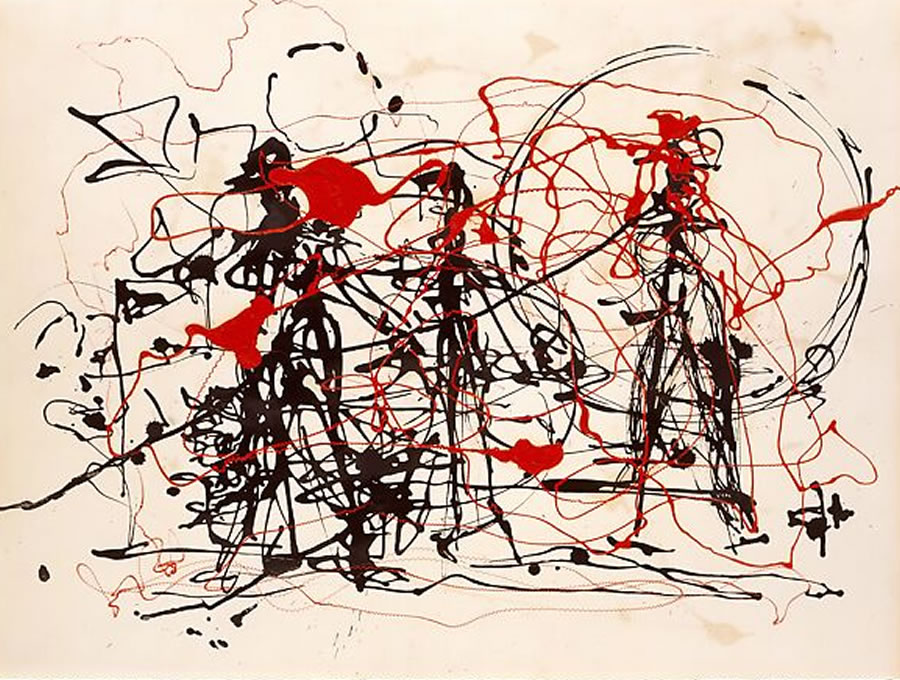وقفت بين يدي معلمي الذي حدجني بنظرة ثاقبة اخترقت ثيابي وجسدي وأربكتني. قلّبني ببصره الحاد، صعّده وصوّبه. حدّق في شعر رأسي المموّج، وفي أسمالي البالية المرقعة بخيوط غليظة منفّرة. دقق النظر في ميدعتي باهتة اللون من القِدم وقد نُزعت أقفالها وجيبها الذي على اليمين. ثم نزل قليلا فتركز بصره على سروالي المتشح باللون الرمادي لما التصق به من تراب وعرق. وانتهى أخيرا إلى حذائي الذي انكشفت في مقدمته بعض أصابع قدمي، ذاك الحذاء الذي رافقني سنتين كاملتين وكنت أشده بخيطين كلٌّ بلون محاولا جعلهما لونيْ فريقي المفضل.
عندما أنهى المعلم العبث بي بسهام نظره دون أن ينطق بكلمة واحدة رمى كراسي الذي كان يقلبه بين يديه على وجهي. آلمتني الضربة لكني لم أتزحزح عن مكاني خوفا من إغضابه. تسمرت دون بكاء، كتمت ألمي وتجلدت. لعل أكثر ما آلمني أن أرى كراس العبادات بما خُطَّ على صفحاته من آيات قرآنية مقدسة وأحاديث نبوية شريفة يتدحرج بين الطاولات وتتقاذفه أقدام رفاقي. ثم صرخ في وجهي وهو يشير بسبابته إلى المقعد الأخير "ذاك مكانك، الزمه حتى آخر يوم من السنة الدراسية".
اتجهت نحو المكان الذي حدده لي معلمي وقلبي يخفق خوفا كقلب عصفور صغير وقع في فخ نصبه له صبي شقيِّ. سرت متعثرا في خوفي وارتباكي. أحسست بنظرات رفاقي تخترق جسدي النحيل مثل سيوف حادة. وصارت قهقهاتهم نواقيس تقرع رأسي. وغلى الدم في عروقي وفكرت في أن أصرخ في وجوههم وأن ألتفت إلى معلمي وأشتمه، لكن خوفي من غضبه ألجمني. طالت بي المسافة وشعرت بالعرق ينز من كل مسام جسدي وتغمر حباته وجهي وكل جسمي. تبللت ملابسي ولم أعد أعي أين أضع قدمي فاصطدمت مرة بطاولة، ومرة أخرى بقدم أحد الرفاق الذي أراد إسقاطي عنوة فتهاويت وكدت أسقط لولا أن تداركتني طاولة استندت على حافتها.
لم يكترث معلمي بما كنت أعاني، ولم يمنع التلاميذ من العبث بي. لم يكترث بضعفي وعجزي، ولم يأبه ليتمي وفقري. لم يكترث بي عندما قلت له إنني أنام وأختي ووالدتي في ما يشبه الغرفة جاد بها علينا دَعِيُّ كَرَمٍ طمعا في جسد والدتي. في تلك الغرفة، إن جاز أن نسميها غرفة، كنا نطبخ ونأكل ونسهر وننام. لم ينزعج عندما أخبرته أننا نأوي إلى فراشنا عندما تغرب الشمس، فليلنا يبدأ عند الغروب. لم يحفل بارتعاشه شفتيَّ وأنا أعترف له أنني أهملت حفظ الآيات التي كلفنا بها لأننا لا نملك شموعا في بيتنا.
الفكرة المجنونة – قصة: محمد محضار
فكّرَ، ثُمَّ اخْتمرت الفكرة في رأسه حتى صَارت ذات بُعد عميق يعكس رغبته القويّة في المرور من أحلام اليَقظة إلى مرحلة الوعي بحدود رغباته ومدى إمكانيّة تحقق ذلك في العالم الواقعي، عندما أسَرّ لصديقه بالفكرة التي أصبحت تسيطر على عقله وتضغط على تفكيره بإلحاح لا يُمكن تجاهله أو غضُّ الطَّرْفِ عنه، لم يَتردّد الصّديق في نعتِ فِكرته بالمَجْنونة وغَيرِ المَقْبولة، لكنه لم يتقبّل منه القول، واعْترض على كلامه قائلا:
-فِكرتي عميقة وليست مجنونة، لأنها ستعيد لحياتي نكهتها، وتمنحني فرصة جديدة للاستمتاع بتجربة ناجحة.
ابتسم صديقه وقال بصوت ساخر:
-أنت تسوغ لِنفسك ما تراه يَستجِيب لأهْوَائِك ويَخدُم مُغامرتكَ غيرِ المأمونة العواقب.
تحسّس شَعْرَ رأسه، وزَوّى ما بينَ حَاجبيه وهتف بصوتٍ غاضبٍ:
-ما أنا مُقْبل عليهِ هو عَينُ الصّواب، وسَلوة الفؤادِ وغاية النّفْسِ
-بل هو الجنون عَينه، يا صَاح
تَوقَّف الأمر عند هذا الحدّ، وقرر أن يتجاوز الدّخول في جدل لن يغير من الأمر شيئا.
زاد ثقل الفكرة على رأسه، وأحس بأنه يَحسنُ به تقاسمها مع شخص أخر يفهمه ولا يخذله، وبعد تمحُّص و تأمّل لم يخطر بباله إلا شقيقه الأصغر فهو من ذَوي القربي وقد أوتهما نفس البطن ورضعا من نفس الثدي، ويمكنه أن يستأنس برأيه، لم يتردد في الاتصال به وألحّ عليه في الحضور قائلا: " نلتقي بعد ساعة من الأن بنادي فضاء الحرية لرجال التعليم " حاول شقيقه الاسْتفسَار عن سبب الإلْحَاح، لكنه تجاهل طلَبه وقال له بصوت جَازم : "هذا ليس وقت استفسار أيها العزيز".
هَسِيسُ ٱلْجُنُون – نص: ناصرالسوسي
ٱلأَنَا وَظِلُّهَا:
-1-
قُبَيل الفَجْر دَاهَمَتْني مَنَامَة.
فقد رَأَيتُ فِي مَا يَرَى النَّائِم أَضْغَاثَ أَحْلاَمٍ لمْ أعْهَدْ مِثْلها مِنْ قَبْلُ..
عَلَى إِثْرِهَا صَحَوْتُ مَذْعُورًا وَالظَّمَأُ ينالُ منِّي إذ أَحْسَسْتُ بِتَجَفُّفِ حَلْقِي. أَطْفَأتُ غُّلَّتِي بِمَاءٍ معْدني فَٱبْتَلَّتْ أَحْشَائِي.
ٱجْتَاحَنِي عَرَقٌ غزيرٌ وأنا أَتَفَكَّرُ في صُوَرِ رُؤْيَايَ، وَأُقَلِّبُ رُمُوزَها الَّتِي تُقْتُ قَدْرَ مُكْنَتِي إلى ٱلتِقاطِ بعض مَعَانِيهَا وَتَفَهُّمِ قَدْرٍ مِنْ دَلاَلاتِها.
-2-
فِي كُلِّ صباح، ألْبَثُ مُسْتلْقِيًّا، لِوقْتٍ قَدْ يَطُول أويَقْصُر، كَدَيْدَنِ "روني ديكارت" وهو تلميذٌ في مدرسة "لاَفْلِيشْ" ٱلْيَسُوعِيَّة. على سَرِيرِي أَظَلُّ أتأرْجَحُ بين خَدَرِالكَرَى وٱستشباحاتِ يَقَظَتِي. وفي مَضْجَعِي أيضًا أسْعَى جَاهِداً إلى ضَبْطِ بَوْصَلتي المُرْتَجَّة ٱلَّتِي تَجْعَلُنِي، على النَّقِيضِ مِنْ "يُوهَان غُوتُه"، أَرَى الشَّرقَ غَرْبًا، والغَرْبَ شَرْقاً..
يَا لَأَوْهَامِي
مَنْ أُصَدِّق يَاإلَهِي فِي غَمْرَة تَيْهِي وَجُنُونِي؟!
أَنَايَ المُمَزَّقة بَيْنَ الأَحلاَمِ وَاليَقَظَة، أمْ آخَرُهَا المُضَاعَف الَّذِي يُكَابِدُ كَ "الفَتَى فِيرْترْ" وَاقِعاّ شِرِّيراً هَشَّمَ حَيَاتَهُ فَحَوَّلَهَا إلى مَأسَاةٍ خَالِصَة ؟..
يَالَهَلْوَسَات سَمْعِي!
العجوز والموت – قصة: محمد محضار
أغلقت باب بيتها، وسدت نوافذه بإحكام، ثم تحصنت بالداخل وقد اطمأن قلبها إلى أن الموت لن يصل إليها، ولن يستطيع أن يفاجئها. الكثير من معارفها رحلوا على امتداد السنوات الماضية، أغلبهم اِقْتَنَصَهُ الموت في غفلة منه وهي لا تريد أَنْ تُفاجَأَ مثلهم. لهذا ملأتْ كَرَار بَيتها بكل الموادِّ الغذائية التي تَحتاجها، وقَرَّرت أن لا تغادره البَتَّة. منذ أسْبوع طرق باب بيتها مُوظفون حُكوميون تابعون للبلدية وأخبرُوها بضرورة إخلاء مسكنها لأنه آيل للسقوط، لكنها واجهتم بشراسة:
-لن تنطلي عليّ حِيّلكم أيّها اللُّؤماء أنتم رُسلُ الموت تُحاولون جَرّ رِجْلي لِمغادرة بيتي فيَصطَادني.
-أَغلب السُّكان رَحلوا يا حَاجّة، بُيوتُ هذا الحي ستنهار لأن الشُّقوق تعتري كل الأبْنِيّة.
-تَكذبون! أنتم تريدون بِي شَرّا
-ذَنبك على نفسك، نَحن قمنا بِواجبنا
للموت أعوانٌ، وعيون ترصد الضَّحايا وتُعِدّهم لليَوم المَوْعود، وهِي لن تَنْخدعَ بهذه السُّهُولة وتُصبح لقمة سَائِغة للموت يقتنصُ روحها ويحْرِمها من نعمة الحياة على حين غَرّة. هِي فعلا بَلغتْ من العُمر عتيّاً، وَتُعانِي مِن ضَغط الدّم، واِرتفاع نسبة السُّكري، وآلَام مرضِ النَّقرس، لكن هذا ليس مبررا يَشفعُ للمَوت فَعْلتَهُ.
أفاقت من سَحائِب أفكارها على صُراخ وضَجيج قَوِي بالخارج، تَردّدتْ لحظةً ثمّ اِقتربتْ من الباب الخَشبي المَتِين، ووضعت عَينَها على العَين السِّحرية، رأت شَابّا ملقى على الأَرضِ وهو يَنزِف دَماً.
كانت ملامح وَجْهِه تنِمُّ عن معاناة فَظيعة من الآلام. وكان يَصْدرُ عنه صَوتُ أنينٍ مُمِضّ. عَادت أدراجها وجلستْ على الأريكة الوحيدة التي تملك." لَا شأن لها به، هناك رِجال أمن وإسعاف بالبلد وهم المسؤولون عن حماية أرواح المواطنين ورعاية الجرحى والمُصابين منهم، هِيَ مُجرد سيِّدةٍ عَجوز، مِنَ الأفضَل لها أن تَبتعدَ عن المشاكلِ ".
زادت حِدّةُ الأنين، أصْبحتْ تَطرقُ أسماعَها بقوة وهي جالسة في مكانها، تَقَطّع من الزمن رَدحٌ، وهِي ساكنة تُفكّر، لَكنها في أخر المطاف قامت من مكانها واتجهت مرة أخرى نحو البَاب، نظرتْ عبر العين السحرية، كان الشاب ما يزال مُمدّدا في مكانه وهو يَتَوجّع، لم تتردد هذه المرة، فَتحت البَاب واقتربتْ منه، سالته بصوت أجش :
خيبات – د. الحسين لحفاوي
يداه مغموستان في الطين اللزج تقلبانه برشاقة وخفة ودراية. وقامته المديدة تستوي تارة وتنحني أخرى في لعبة لا يتقنها غيره. شمر قندورته وربط طرفها إلى زناره فانكشفت ساقان رقيقتان معروقتان غطاهما الشعر والطين. تعلوهما ركبتان حادتان مدببتان تحملان فخذين مقوّسين قليلا إلى الخارج محدثين فتحة يتدلى في وسطها طرف القندورة. ذراعاه طويلتان مشعرتان وساعداه مفتولان من عرْك الطين وعجنه. أعلى وجهه الذي يميل إلى طول غير معيب ينبت شعر مجعد وَخَطَه الشيب وتناثر على ما بقي من خصلاته الطين.
يحدق دائما إلى الأمام، كأنما يرسم لنفسه دروبا لا يخط حدودها أحد سواه، ترحل به مرة إلى تخوم ملغومة، وتطوِّح به أخرى في فيافي كثبانها عالية ومسالكها متشعبة لا يتقن السير فيها إلا خرِّيت متمرِّس. وقد تقوده أحايين أخرى إلى حافات مهاوٍ سحيقة لا قرار لها. يخيل لمن يراه أول مرة أنه يراقب الطريق منتظرا قادما لا يأتي.
لا يريد أن يلتفت خلفه. لا يرغب في رؤية تلك الكومة من السنوات الجاثمة وراءه، تلك السنوات التي أفناها من عمره متأبطا محفظة جلدية خضراء جلبها له والده إحدى أوباته من ليبيا. هذا البلد الذي كم قد أغدق على والده وأمثاله من أموال وبضائع، يذهبون إليه بجيوب خاوية ويعودون بها ضاجة بالأوراق النقدية ومحملين بشتى أنواع البضائع والأطايب. يذهبون خِماصا ويعودون بطانا. لم تكن محفظة عادية، كانت بطعم جذوة الأمل التي أوقدها والده في قلبه وأوكل إليه أمانة إضرامها ورعايتها. رافقته تلك المحفظة الأثيلة إلى قلبه سنوات ست في مسيرة تعلم شاقة. رُتقت مرات كثيرة حتى استبدل خيطها الأصلي بخيوط أخرى ذات ألوان متداخلة. في عامه الأخير اتسعت ثقوبها وعِوض حملها على ظهره صار يتأبطها خشية أن تتمزق وتتبعثر أحلامه وآماله وأدواته الهندسية وأقلامه وقطع الطبشور.
العشاء الأخير في حضرة دافنشي – قصة: محمد محضار
عندما عَادَ من مِيلانو كانت ذَاكرتُه لا تزال تَختزن تلك المشاهد التي عَبَرتْ إلى وجدانه مباشرة وأرضتْ ذائقته الفَنِّية ونزعتْ بها نحو رِحاب الجمال وسحر الإبداع الانساني في أروع تجلياته، وحَقَّقتْ له درجة قُصوى من الاسْتِمتاع بِجَماليات يَعزُّ وُجُودَ مَثيلٍ لها في هذا الزَّمن الذي تلوّثَ بالغُبار والإسْمنتِ واعْتَرتْه مَثالب القُبح والسوداوية، لقد وقف مُتهيِّبا أمام لوحة العشاء الأخير الجِدَاريّة لليوناردُو دافنشِي بِدِير سانتا مَاريّا، يتأمل تعبيرات وجوه المسيح وحوارييه الاثني عشر، وجوه كان بعضها كان يحمل ملامح بريئة كَوَجْه يُوحنا، ووجوه البعض الأَخر كانت ترتسمُ عليها علامات الغدرِ كَوجه يهوذَا الإسخريوطي خائن يسوع، الذي باعه لبيلاطس البَنطي الحاكم الروماني، وكان سببا في صلبه(أو من يشبهه) بالقدس، وعندما غادر الدير كانت أصداءُ المَاضي تَحُفُّ خُطاه وروحه تحلّق في رحابه متماهية مع عِبقِه الذي كان يتنسَّمه في الهواء، فتسري في جسده رعشة انتشاء وشعور بالسعادة، ظلت ترافقه حتى وَجدَ نفسه أمام تمثال ليوناردو دافينشي الشامخ مُحاطا بتلاميذه الأربعة يتوسّط ساحة ديلا سكالا ، وجموع الزوار الحاضرين مأخوذين مثله بجمالية المنظر الذي يسافر بهم إلى الثُّلث الأخير من القرن التاسع عشر عندما أزاح ملك إيطاليا فِيتُوريو إيمانويل الثاني سِتار تدشين هذه التحفة الفنية، تكريما لدافينشي عبقريِّ عصر النهضة الذي جاء لِيطوي صفحة العصور الوسطى المُظلمة، ويفسح المجال لإحياء الفكر الكلاسيكيِّ للإغريق والرومان، وترسيخ مفاهيم جديدة مثل الانسانية والإصلاح الديني والواقعية في الفن، كل هذا مرّ بخاطره وهو يجلس على واحد من المقاعد الرُّخامية المنتشرة في محيط الصرح السَّامق الذي يَحتضن التمثال، تساءَل :" هل حقا عُمْرُ هذه التُّحفة قرن ونصف، وكيف تَأتَّى لها أنْ تصمد أمام عوادي الزمن وتقلّبات الطبيعة؟ " تَذكَّر فجأة عملية تدمير تماثيل بوذا بوادي باميان بأفغانستان بمعاول ومتفجرات طالبان، ماذا كان يَحُلُّ بتمثال دافينشي لو كان الحل والعقد بيد المُلّا عمر؟ تَجاوز هذه الفكرة ، وقام من مكانه وأجنحة الأفكار المُتهاطلةِ على دماغه تُحلِّق به بين الأَزمنة المُتَواترة ومواطن الخيال الخلّاقِ، قادته قدماه إلى 1824 MARCHESI PASTICCERIA لتناول وجبةِ إفطار بصالون الشاي بالطابق العلوي، مستمتعا بعبق القرن الثامن عشر الميلادي . ومُتِلذّذا بوجبة تقليدية إيطالية أصيلة، بدا له العالم بشكل مختلف وأحس بأنه يتجاوز ثقل السنين واحباطات الأيام الماضية، اتصل بزوجته وأخبرها بأنه قادم في اليوم الموالي ، وأنه كان يتمنى حضورها معه، وردَّت عليه بأنّ ظروف عملها حَرمتْها من مُتْعة الوُجود صُحبته ولقاء ابْنهما المقيم بمدينة "كومو" صُحبة زوجته، أنهى المكالمة ثم غادر المكانَ.
القطيعة الإبستمولوجية – قصة: محمد محضار
تَوَقّع أن تقع أشياء كثيرة خلال الأيام القادمة تُغيّر مسار حياته ومسار محيطه، بل مسار العالم، لكن " الأيام القادمة " جاءت دون أن يقع أيُّ تغيير، بل ظل كل شيء على حاله، وربما زاد سوءً.
لقد ظل حبيس هذا الإحساس منذ أزمنة بعيدة، دون أن ينتبه إلى أنّ التغيير الوحيد الذي يحدث كان يمس مُورفولوجيا جسده فقط، فوزنه يزداد، وشعره يشتعل شيبا، ووجهه تمسه الغضون والتجاعيد، وحركاته تُصبحُ أقل نشاطا.
حتى زوجته التي كان يَجد عندها السُّلْوَة والمودة الزائدة ودفق المشاعر الذي يُسرّي عنه، أصابها برود رهِيب مُذْ داهمها المرض وصار كل هَمّها أن تَسْتفتيه في موضوع العلاج، وطريقة استعمال الدواء، ومواقيت التحاليل والأشّعة، أما زملاؤه في العمل فأحاديثهم كانت مَلاحم شجنٍ، وبكائيات لا تنتهي وسردا بئيسا لأحداث بعضها مَحلّيُّ، وبعضها يهم ربوع الوطن، أو أرض الله الواسعة، كانت هذه الأحداث تبدو له بَالِغة الفَظَاظِة تَبثُّهُ بالطاقة السلبية، وتُلقي به نَحو دَوّامة الهواجسِ وبواعثِ القلق. وَلَعَلّ هذا ما كان يدفعه في كثير من الأحيان إلى تجنّب تجمعاتهم، وإن قُدّر عليه التواجد بَينهم فإنه يلتزم الصّمتَ ويتسلح بالانطواء. مِمّا جعلهم يلقبونه بالغراب "الأعصم"، لِفرادته في السلوك والمعاملة.
سأل زوجته ذات مرة: " ما بك يا امرأة؟ وماذا أصابك حتى صِرت على هذا الحال من البرود وضيق الخاطر؟"
نظرت إليه مستغربة، وقالت :" لستُ مسؤولة عمَّا تراه أنت تَغيُّراً، وأراه أنا تَطوّرا طبيعيّا ، وجزءً من قواعد اللعبة المفروضة علينا قَسراً ودون رضانا، والتي تنتهي بحتمية لا نستطيع الوُقوف في وجهها"
أحلام الشيوخ – قصة: د.محمد روي
ارتسم في كينونته على حين غرة وهو في طريقه الغائم معنى لطالما وفد عليه فجأة دون استعداد وتقدير، والواقع أن هذا المعنى منه يُعرف صاحبه بشكل دقيق، وهو حكم منطقي يجري على ألسن الناس؛ مفاده: "كل شيء يدخل في نطاق الوجود فهو متغير"، "وحال الإنسان داخلٌ في هذا النطاق"؛ "فحال الإنسان في تغير دائم".
لم أجد مثل هذا الوصف والتحديد الذي قاله صديقي "عبد الله" يصدق عن صديقنا "حميد"، الذي أعرفه شخصيا معرفة تحقيق، وقد كان آخر مرة التقيت به الإثنين الماضي، وبدا لي من خلال تبادل أطراف الحديث أن نفسه قد نزعت إلى تغيير موضعه الذي لبث فيه زمنا ليس بالقليل، وطال مكوته فيه، وسعى فيه سعيا، كما كابد من أجله مكابدة، حتى إن من يراه في وضعه ذاك لن يخطر على باله في يوم ما أن يفكر في الانتقال منه، وقد كان قبل ذلك يحمد الله على تلك النعمة، ويجد فيها نفسه، ويرنو البقاء فيه طويلا طويلا. لا أدري ما الذي حدا به إلى الرغبة العارمة في التحرك من مكانه.. لا أدري، لا أدري. غير أن المحقق عندي أن هناك شيئا ما، وليس بالتأكيد شيئا عاديا مما يمكن أن يقبله المرء دون مواربة، فأنا أعرف الرجل، فليس من عادته أن يقع في هذا المأزق الذي يحرضه على الانصراف عن المقام الذي لطالما حدثني بكل فرح بحبه له وأنه لا يجد راحته إلا فيه، ولم يقع على فؤاده في وقت من الأوقات –وأنا أعي ما أقول- أنه سيأتي تاريخ يسمح فيه عن تلك الجلسة الملائكية أمام بستانه العقلي الحالم.
وصحيح أنه لا يكاد يخلو طريق شخص من أمور تظهر أحيانا على شكل أطياف من التيه والضلال، وبمقدورها في زمن غير محدد أن تتحول إلى أزهار تضفي على الأيام رونقا بهيا ينسي المارّ من الحجيم ما قاسى من ألم وما لحقه من تعب، ولكنها تظل بالقياس إلى غيرها من الأيام كاوية للخواطر التي لا يتوقف سيلان حركات الذهن من إنتاجها؛ ذلك أنه عادة ما يبلغ به الأمر أن يستسلم لتلك الأطياف بالنزوع إلى أي رصيف يتمطاه، دون أن يسأل إلى أين سوف يصل به، ومع ذلك ينازعها ويتولى استشفاف كل ما هو جدير باستمداد ما يمكن أن يجعله مفعما بالذوق المحرك للمياه الراكدة في مخيلته.