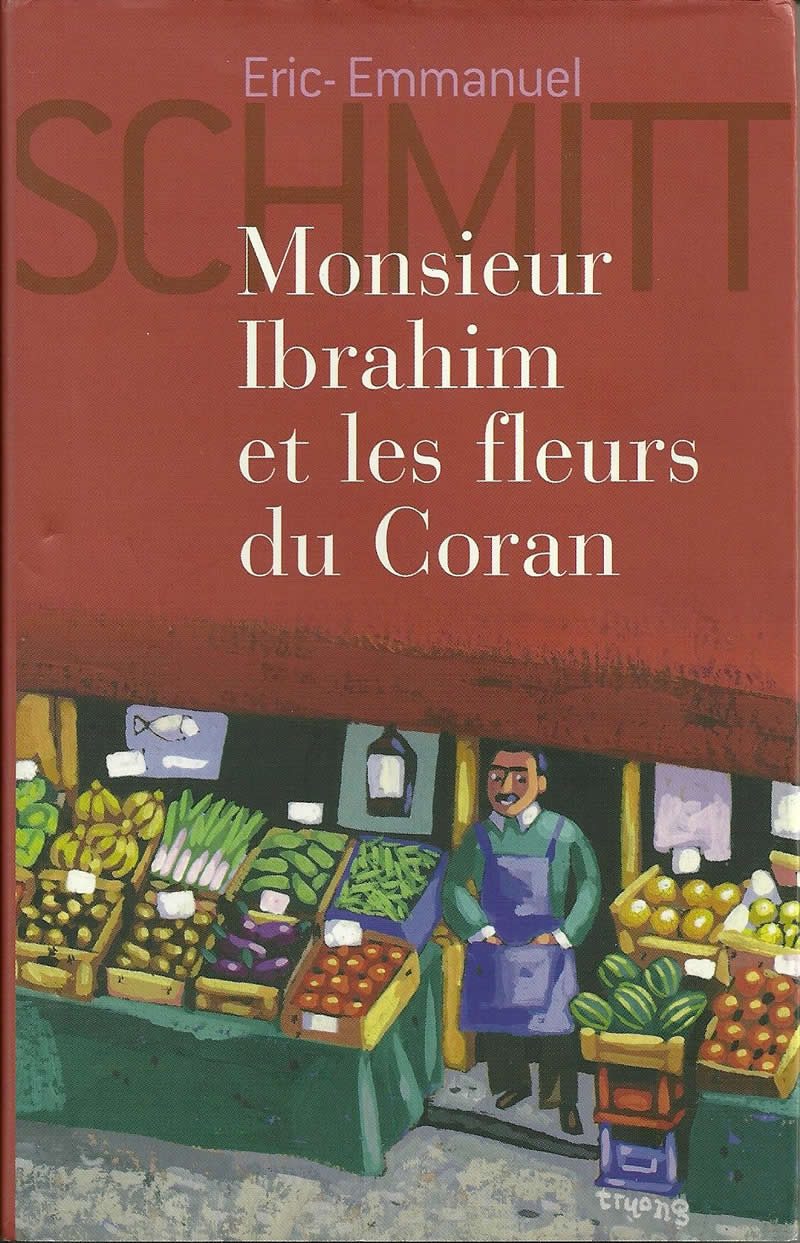قبل الإقدام على تسطير أول كلمة في هذا المقال لا بد من التعريف، ولو بإيجاز، بصاحب الرواية الوارد عنوانها في العنوان أعلاه. باستشارة موسوعة ويكيبيديا نجد أنه ولد في 28 مارس 1960، وأنه روائي، و كاتب مسرحي، و مخرج فرنسي من أصول بلجيكية.. قدمت أعماله في المسارح العالمية، وحاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي بفضل هذه الرواية التي مرجعنا اليها في هذه المحاولة.
لعل ما ضمن للكاتب شهرة في الآفاق العربية هو تناوله، من منظور انساني رحب، لقضية الصراع التاريخي بين اليهود والمسلمين حيث وظف مقدراته الخيالية لنسج علاقة مثالية، متينة بأواصرها الانسانية بين هذين المجتمعين المتحاربين من خلال قصة جرت أطوارها بين فتى يهودي (موسى) وبقال مسلم (ابراهيم). وبما ان الشخصيتين تعيشان في حي باريسي تخيم عليه أجواء سلمية، أمكن للكاتب أن يطور العلاقة بين الفتى اليهودي والبقال المسلم الى أقصى مدى ممكن. اذ نبضت في قلب كل منهما أرقى المشاعر (الأبوة والبنوة).
في ظل جو من الهدوء والهناء، كان الفتى، من حين لآخر، يزور صديقه البقال وهو في حانوته ليتبادل معه أطراف الحديث. هكذا استمر ديدن الفتى الى أن نشأت بينهما علاقة مبنية على تواصل انساني، لا سيما وأن الشاب في أمس الحاجة الى أذن تصغي الى آهاته ومعاناته.
من خلال هذا السياق التنفيسي، يقف القارئ على أن الشاب اليهودي يشكو من الوحدة ومن تحمله لمسؤوليات الكبار قبل الأوان. هجرته أمه وتركته وجها لوجه أمام أب فظ القلب، مارس عليها ساديته مما جعله يشعر بالحرمان والقهر، ويميل الى هامش الانحراف والضياع، لولا أن ابراهيم أحبه وأشفق لحاله، فمد له طوق النجاة، وساعده على فهم الحياة والناس، ووقف الى جانبه في المحن والشدائد، وكأن الاختلاف الديني بينهما لم يخلق العداوة، بل عزز الأحاسيس الانسانية.
بصراحة، تبقى هذه المحاولة ناقصة اذا لم تفرد حيزا، ولو على شكل فقرة أو فقرتين، للوقوف على جمالية عنوان الرواية: "السيد ابراهيم وأزهار القرآن الكريم". هنا، من خلال الدلالة العامة للعنوان، يحق لي اعتبارها أهم سبب على الاطلاق كامن وراء الشهرة النجومية التي اكتسبها الكاتب بين معاشر القراء العرب، خاصة وأنها تمنح لهم مرتبة "الأنا" بينما تجعل اليهود هم "الآخر".
وفي تأويل آخر، فقد أزهر الحب بين الفتى اليهودي والبقال وبات وجها آخر للدين، وبذلك انفتح المسلم المتصوف على اليهودي معتمدا على تعاليم دينه، التي أشار اليها الروائي ب"أزهار القرآن". وبما أن الأخير على علم بتقديس المسلم للنص الديني فقد جعل هذه العلاقة جزءا لا يتجزأ من جماليات العنوان، بحيث شخص لنا ابراهيم كرجل ورع يتخذ من آيات الذكر الحكيم نبراسا هاديا له في حركاته وسكناته، ونورا ينير به علاقاته الانسانية، لهذا بات ضرورة حياتية وجمالية كالأزهار تماما.
ليس غريبا، في كنف هذه العلاقة المنفتحة، أن تثمر لكلا الطرفين، بشكل متبادل، عن تعويض لنقص دفين في الأعماق. بالنسبة لابراهيم، وجد فيها تعويضا نفسيا عن نقص يشعر به جراء عزلته عن الدفء العائلي. أما موسى فكانت غنيمته منها (العلاقة) عبارة عن تعويضه عن الحرمان من حنان الأم والأب كليهما. ويبدو أن اسم ابراهيم قد اختير عن رغبة في تأكيد أن المرجعية الدينية واحدة، لأن النبي ابراهيم (عليه السلام) هو أبو الأنبياء جميعا، يلتقي في ظلاله المسلم واليهودي، لهذا بقي اسمه ثابتا على مر العصور بسبب ثراء دلالته.