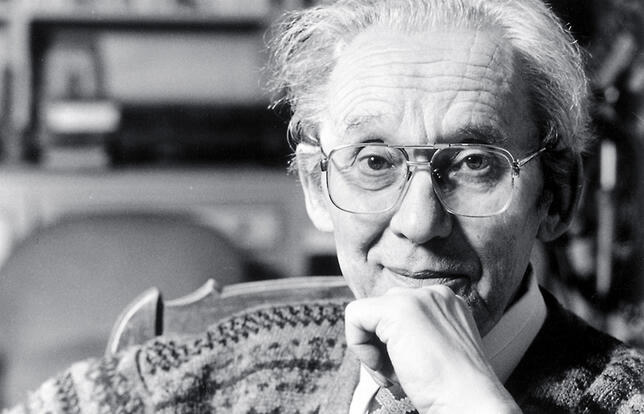(...) نحتفظ بالخصوص من بين هذه السمات العامّة للخطاب، بالعلاقة بين فعل الخطاب ومحتواه، بقدر ما تحتوي هذه العلاقة الجدلية الأكثر بساطة لتخارج و موضعة الخطاب. تَتْبَعُ هذه الجدلية استقلاليةُ مختلف أشكال الخطاب المعروفة تحت مسمّى " الأجناس الأدبية ". وباختصار: مهما قيل، فإنّ ذلك يقف بعدُ في مسافة معينة إزاء فعل الخطاب أو حدث الكلام. تتّسع مسافة مماثلة بين الخطاب والمتحدّث، بين البنية الداخلية والمرجعية الخارج - لسانية، وبين الخطاب ووضعيته الأصلية وفي النهاية بين المتحدّث والإنصات الأوليّ. هنا يبدأ مشكل التأويل. ولا ينحصر هذا المشكل في النصوص المكتوبة، بل يبدأ بالجدلية الدقيقة الحاضرة بعدُ في اللغة الشفهية، والتي بفضلها تتخارج هذه الجدلية، وتتمفصل وتُثُبّتُ في أشكال مختلفة من الخطاب. والأهمّ من هذا الاستنتاج الأول أيضا، هو اعتبار هذه الأشكال ذاتها، أي الأشكال التي، تسمّى في النقد الأدبي" أجناسا". غير أنّني أفضل الحديث عن أشكال من الخطاب للتأكيد على الدور الذي تلعبه هذه الأنماط الألسنية في إنتاج الخطابات. وبالفعل، يتضمن النقد الأدبي تحت عنوان " الأجناس" ، مقولات تساعد النقد على تبيّن السبيل داخل التنوّع اللامحدود للنصوص. بيد أن أشكال الخطاب هي أكثر من أدوات تصنيف؛ هي أدوات إنتاج. من هنا أفهم بأن أشكال الخطاب هي مصفوفات matrices بواسطتها يُنْتَج الخطاب بوصفه عملا. إلاّ أن هذه السمة للخطاب لم يلاحظها الفلاسفة إلاّ قليلا، لأنّها تستخدم مقولات لا تتعلق أوّلا بمجال اللغة، بل بمجال البراكسيس، بمجال الإنتاج والخلق. لكن، هذا هو الحال بالضبط: الخطاب عمل، منظّم وفق وحدات أو كليات totalités من الدرجة الثانية، مقارنة بالجملة بما هي وحدة دنيا للخطاب وبالتالي بما هي وحدة من درجة أولى. يسمّي أرسطو في الخطابة هذه المقولة الأساسية " الوضع"- تاكسيس taxis ؛ ويضعها بين " الاكتشاف" « découverte » ( الحجج) - – heurèsis وبين " الإلقاء" « diction » - lexis. وبفضل هذا " التاكسيس" ( الوضع) ، يوفّر النص المنطوق أو المكتوب نسيجا يجب على بنيته أن تُؤَوّل. إنّ تأويل نصّ يعني دائما أكثر من ضمّ معاني جمل معزولة. يجب أن نمسك بالنص بما هو كليّة من وجهة نظر تراتبيّة "الطوباي" topoï أي الخطابات التي تكوّنه. يجب أن تردّ وظيفة الأجناس الأدبية إلى هذا المفهوم للنص بوصفه كليّة ، وحدة كلية totalité - أو ، مثلما سنقول من هنا فصاعدا، وظيفة مختلف أشكال الخطاب : سرد ومثل سائر أو حكمة ، الخ. ومثلما تمارس القوانين النحوية وظيفة توليديّة وتنتج الخطاب بوصفه جملة، فإنّ للرموز الأدبية codes littéraires أيضا في مستواها، وظيفة توليديّة. فهي تولّد الخطاب بوصفه سردا أو بوصفه هذا الخطاب أو ذلك. وبهذا المعنى فهي في حاجة إلى شعريّة توليديّة ستتوافق، على مستوى "التاكسيس" ("الوضع") الأرسطي ، مع " النحو التوليدي " لتشومسكي .
يجب أن يكون الانشغال الأساسيّ لهذه التأويلية، تحليل الأنماط الجديدة والخاصّة للتماسف الذي يرافق إنتاج الخطاب بوصفه عملا. يمثّل الخطاب بوصفه عملا، وفي ذات الوقت الذي هو فيه عمل فنيّ، موضوعا مستقلاّ يتخذ مسافة من مقصد المبدع، من منزلته في الحياة Sitz im Leben (8)، بالإضافة إلى إنصاته الأوّلي. لأجل هذا تحديدا يكون العمل الفنّي وفعل الخطاب مفتوحين على عدد لا محدود من التأويلات. ويفتح للتأويلات فضاء للحركة، لأنّ استرداد الحدث الأصلي للخطاب يتخذ شكل إعادة بناء ناتجة تحديدا عن بنية داخلية لهذا الشكل من الخطاب الخاص أو ذلك. وبعبارة أخرى، إذا ما ظلت التأويلية محاولة تخطّي المسافة، وجب عليها اعتبار هذه المسافة بوصفها في الآن نفسه موضوع بحث، وبما هي عائقا وبما هي أداة، حتى تعيد تحيين الحدث الأصلي للخطاب في حدث جديد. من هنا، لا يمكن أن يكون الحدث الجديد للخطاب وفيّا إلاّ إذا كان في الآن نفسه مبدعا(....).
إنّ المقولة التي يجب إدماجها هنا هي مقولة " عالم النصّ" . هذا المفهوم يوسّع للأعمال المركّبة للخطاب، ما نسمّيه بعدُ مَرْجَعًاréférence . نحن نعرف الفرق الذي أبانه جوتلوب فراج ، على مستوى الأقوال المعزولة، بين دلالة ومرجع. فدلالة عبارة هو موضوع مثالي مستهدف؛ وهذا المعنى أو الدلالة محايث للخطاب. يحيلنا المرجع إلى الخارج- ألسنيextra-linguistique ويمثّل قيمة الحقيقة بالنسبة إلى القضيّة، أي ادعاءها بلوغ الواقع. تميّز هذه الخاصية خطاب اللغة الذي لا يتضمن أيّ إحالة إلى الواقع: تحيل كلمة في النسق المعجمي، إلى كلمة أخرى فحسب، حسب علاقات تباين وتعارض. والخطاب وحده هو الذي يتعلّق بالأشياء، يتّجه إلى الواقع ويعبّر عن العالم. والسؤال الذي يُطرح هو إذن هذا : ما الذي يحدث للمرجع حينما يصبح الخطاب نصّا؟ أليس المرجع متغيّرا بفعل الكتابة و، قبل كلّ شيء، ببنية الأثر، إلى حدّ يصبح فيه إشكاليّا تماما؟ يجد المشكل حلّه بسهولة، في الخطاب الشفوي العادي، بفضل الوظيفة "البيانية"monstrative » أو « ostensiveأو الإشارية " للغة. وبعبارة أخرى يحلّ مشكل المرجع بواسطة قدرة المتكلّم على إظهار الواقع ( أو الإشارة إليه). وحينما لا يستطيع المتكلّم الإشارة إلى الشيء الذي يتكلّم عنه، يمكنه أيضا، من خلال توصيفات دقيقة، تحديد موضِعِه داخل نسق فريد مكاني- زمانيّ ينتمي إليه المتكلمون. يمثّل هذا النسق على أقصى حدّ فضاءَ مرجعِ لكلّ خطاب ممكن.
تصبح الأشياء أكثر صعوبة مع الكتابة. أولا تفتقر الكتابة إلى وضعية مشتركة بين الكاتب والقارئ. ومن جهة أخرى، لا يمكن استيفاء الشروط العينية للإبانة. لكن الكتابة خاصّة تسمح بتكوّن أشكال أدبية تُستعمل موضوعيا في حذف كل ارتباط بالشبكة المكانية - الزمانية الوحيدة وبالتالي بإلغاء، على الأقلّ في تقريب أوليّ، الإحالة المرجعية إلى واقع معتاد. لقد تمّ دفع هذا التعليق لكلّ إحالة إلى واقع معطى مسبقا، إلى أقصى حدوده في بعض الأشكال الأدبية المعاصرة. ويبدو أنّ دور هذه الأخيرة إذن هو تدمير العالم. ويبدو أن اللسان لا يحتفي إلاّ بذاته، بتحرّره من الوظيفة المرجعية للغة العادية . بيد أنّه، إذا لم يتعلّق مثل هذا الخطاب المحكوم عليه بالتخيّل ، بالواقع اليومي، فليس هو مع ذلك خال من كلّ قوّة مرجعيةّ. إنّه يتّجه إلى طبقة أكثر أساسية للواقع لا تصنعها اللغة المعتادة. إنّ أطروحتي هي أنّ تعليق مرجع من الدرجة الأولى، يشغّله التخيل والشعر، هو شرط تحرّر قوّة مرجعية من درجة ثانية، لا ترتبط بعالم الموضوعات القابلة للتلاعب، بل بما أشار إليه هوسرّل بوصفه " « Lebenswelt » (حياة العالم ) وهيدجر بوصفه "« In-der-Welt-Sein ». ( كَوْنُه في العالم).
إنّ هذه الوظيفة المرجعية المعاصرة للتخيّل والشعر تحكم، في نظري، المشكل الأكثر جوهرية للهرمونيطيقا. وإذا صحّ أنّه لا يمكننا تعيين الهرمونيطيقا بجَهْدِ ( quête) ذات متخفيّة وراء النص وبالبحث البسيكولوجي عن نواياه، وإذا كنّا من جهة أخرى لا نريد أيضا اختزال التأويل في وصف لبنيات النصّ، فإن السؤال الذي يُطرح هو في معرفة ما يجب تأويله على وجه الخصوص. إنّ جوابي هو أن التأويل هو الاعتراف بنمط الوجود - في- العالم الذي يسقطه النصّ. وليُسْمح لي هنا بالتذكير بالمفهوم الهيدجري لـ Verstehen ( حياة العالم). من اللافت للنظر أنه في " الكينونة والزمن" Sein und Zeit ، ليست نظرية " الفهم " comprendre" متصّلة بمبحث البينذاتية - فهم آخر- ، بل بالأحرى ببنية الكائن - في - العالم. وبالتحديد، فإنّ الفهم هو بنية فحصها يتبع بنية la Befindlichkeit- " الوجود في وضعيّة". إنّ لحظة " الفهم" تستجيب جدليا للحظة التي " أجد فيها نفسي" se trouver"، من حيث أنّي مشروع إمكانياتي الأكثر خصوصية في الوضعيات التي قُذفنا فيها. أودّ استعادة مقولة " المشروع"، المنزوعة لدى هيدجر من كلّ دلالة إرادوية، وتطبيقها على نظرية النصّ. إنّ ما يسمح بالخصوص بتأويله في نصّ، هو مشروع عالم، عالم يمكنني الإقامة فيه، و يمكنني فيه أن أضطلع بإمكاناتي الأكثر خصوصية. هاهنا ما أسمّيه عالم النصّ - العالم الذي يملكه هذا النص الفريد. ليس عالم النصّ موضوع السؤال هنا هو عالم الخطاب المعتاد. في هذا المعنى، يوجد على مسافة من الواقع اليومي. يشتغل التخيّل على هذه المسافة في فهمنا للعالم. وتنفتح، بواسطة التخيّل وبالشعر إمكانيات جديدة للوجود في العالم ، في صلب الواقع اليومي. هذه الإمكانيات هي فعلا إمكانيات موجود، لكن ّ هذا الموجود لا يمسك بوجوده الخاص إلاّ في نمط الممكن تحديدا لا في نمط المعطى. هكذا يقع تحوّل الواقع المعتاد، وذلك بواسطة تغيّرات تخيّلية تطبّقها الأعمال الشعريّة على الواقع. ومن بين كلّ أنماط التعبير ذات الطابع الشعريّ، فإنّ التخيّل هو الأداة المميّزة لإعادة وصف الواقع. إنّ اللغة الشعريّة هي اللغة التي، أكثر من أيّ شيء آخر، تساهم فيما يسمّيه أرسطو، في اعتباراته للتراجيديا، محاكاة la mimèsis الواقع. ذلك أن التراجيديا تحدّ الواقع من حيث أنّها ، تعيد فحسب خلقه في ميثوس muthos ( الأسطوري)."
بول ريكور " الدين من أجل التفكير" ، كتابات ومقالات ، فصل 6 " الفلسفة وخصوصية اللغة الدينيّة" ص 199. نشر سوي، باريس 1975.