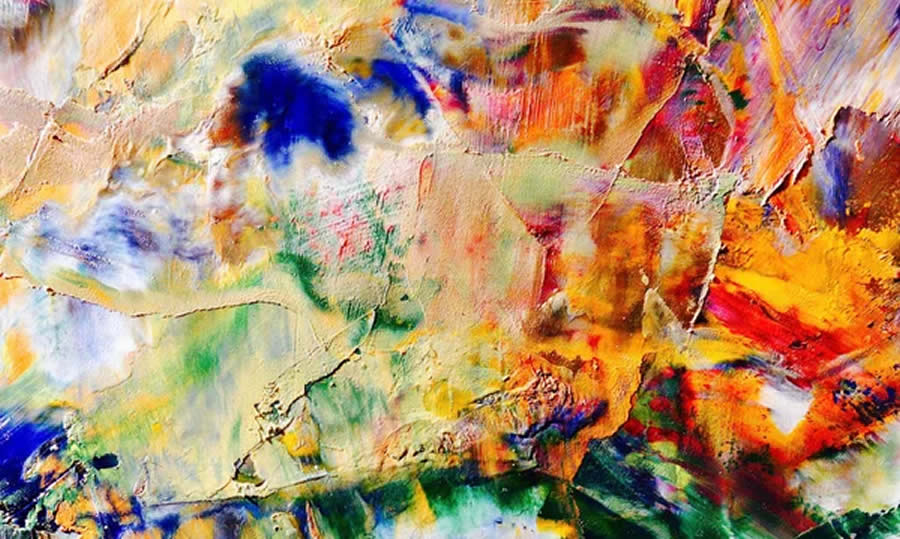يحمل الصمود أو ما يمكن ترجمته حرفياً بـ "الثبات" ـ بصفته مفهوماً وطنياً فلسطينياً ـ معنى العزيمة القوية، والإصرار على البقاء في الوطن والتمسك بالأرض. ويُرجّح أن الصمود كان جزءًا من الوعي الفلسطيني الجماعي بالنضال من أجل الأرض والتشبث بها، يعود تاريخه على الأقل إلى عهد الانتداب البريطاني. إلا أن الصمود، كرمز وطني استخدم في ستينيات القرن الماضي. وأصبح جزءًا من إحياء الوعي الوطني الفلسطيني بعد نشوء حركات المقاومة الفلسطينية كمنظمات رائدة في مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان. حيث كان اللاجئون المقيمون في المخيمات يُعرفون بالصامدين، إذ كان النضال من أجل الحياة اليومية والحقوق الوطنية في تلك المجتمعات يتطلب مستوى عالياً من الصمود. لقد عزز الصمود رسالة الكفاح المسلح التي سيطرت على خطاب الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك. وكان الحاضر الأكبر حين تغيرت الأدوات من النضال المسلح إلى المقاومة اللاعنفية
الصمود هو أكثر من مجرد سمة شخصية، فهو أداة ثقافية ونفسية تربوية فعّالة، وقد أصبح سمة مميزة للمقاومة اللاعنفية في فلسطين. يأتي صمود النساء الفلسطينيات خاصة كنموذج حيّ وعالمي للصمود في ظلّ ظروف بالغة الصعوبة. لهذا النموذج إمكانات تعلّمية هائلة، لا سيما في فلسطين، كما يُجسّد الصمود سرديةً فلسطينيةً راسخةً تتحدى المحاولات العديدة لقمعها أو تشويهها، كما هو الحال في كثيرٍ من الخطاب الغربيّ الشعبيّ حول فلسطين. الصمود إذن فعلٌ من أفعال الوجود والتأكيد على الحق في الحياة على أرض الأجداد.
لقد شهدت المئة عام الأخيرة من التاريخ الفلسطيني ندوباً من النزوح، والتشريد، والنفي، والفقدان. فبالإضافة إلى التطهير العرقي ومصادرة أراضيهم، واجه الفلسطينيون أيضاً تشويهاً متعمداً لتاريخهم وإنسانيتهم. يشعر السكان المدنيون الفلسطينيون يوماً بعد يوم بآثار احتلال عسكري يُعدّ الآن من أطول الاحتلالات في التاريخ المُدوّن، إذ تمتد جذور هذا الظلم إلى عام 1948 حين طردت إسرائيل وهجرت بقوة السلاح حوالي مليون فلسطيني مما أصبح فيما بعد يُعرف بدولة إسرائيل. يتعرض الفلسطينيون الباقون لتمييز ترعاه الدولة، يؤثر على كل جانب من جوانب حياتهم. ومما زاد الطين بلة، أن الواقع الكئيب للمحنة الفلسطينية قد خيم عليه خطاب "سلام" هش وغير فعال خلال العقود القليلة الماضية، لم يترك مجالاً للقصص اليومية عن معاناة الفلسطينيين.
ونظراً لطول المدة التي تحملوا فيها هذا القمع والظلم الصهيوني، فإن هناك عقلية معينة تربط الفلسطينيين ببعضهم البعض. غالباً ما تُغفل، وبالتأكيد لا يتشاركها الجميع، ولكن لا يزال يُنظر إليها على أنها سمة فلسطينية أصيلة. إنها تتعلق بشعور مشترك بالهوية، والحفاظ على القوة الداخلية في مواجهة كل الصعاب - التكامل في مواجهة التشرذم، والحياة في مواجهة الموت. هذا ما يعنيه الفلسطينيون عندما يتحدثون عن الصمود والثبات.