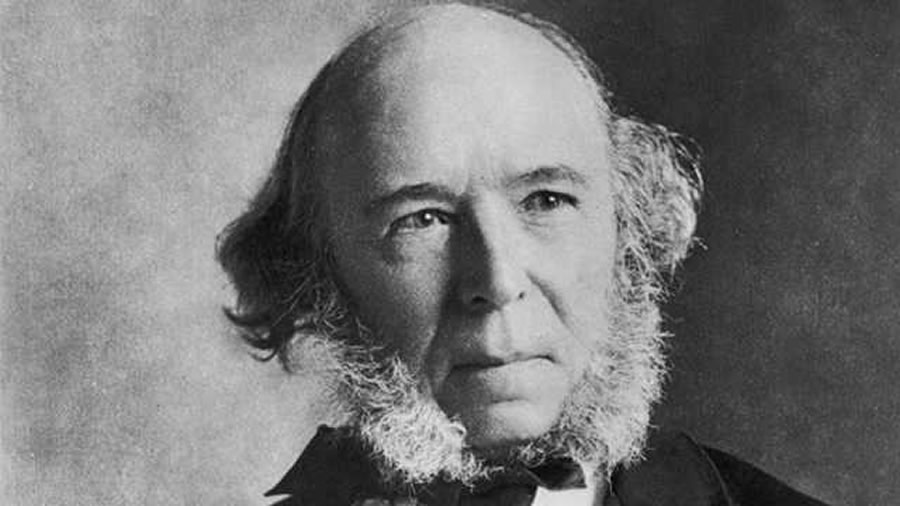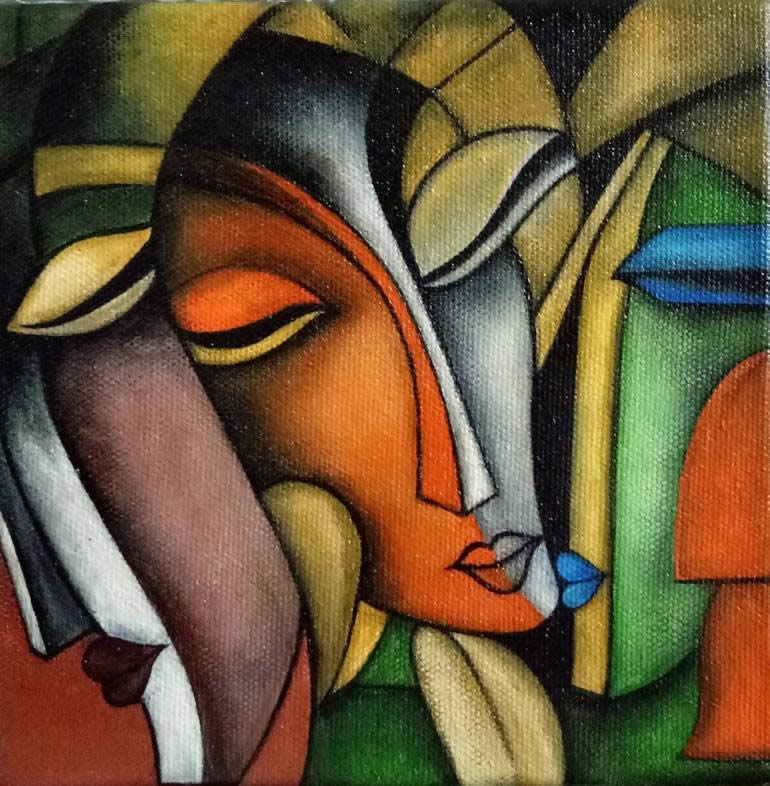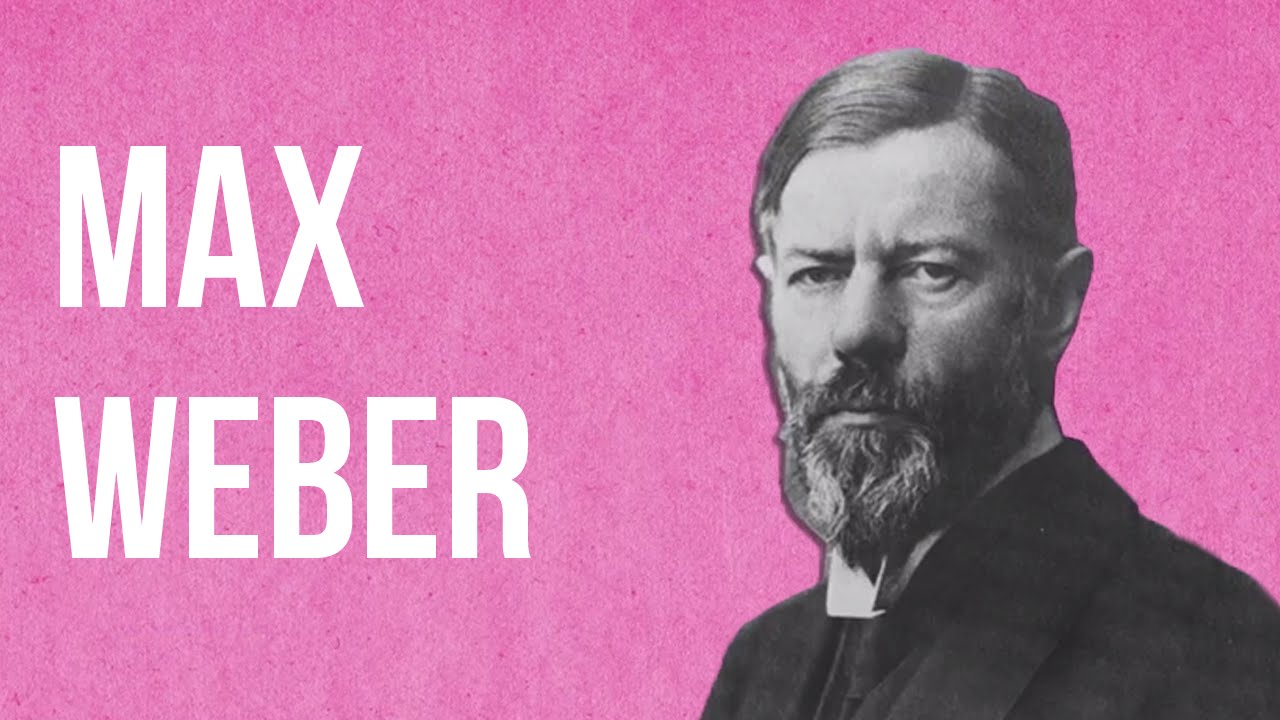يهدف هذا المقال إلى توضيح العلاقة الجدلية بين الهوية واللغة وكيف تساهم اللغة في إيجاد تلك العلاقة بينهما على اعتبار أنه لا هوية بدون لغة وإنتاج فكري ولا ثقافة بدون هوية، ولا حضارة بدون هوية ثقافية كونها ينبوع الحضارات (إن جاز لنا التعبير). بذلك ستنحصر مناقشتنا للأفكار المطروحة أعلاه من خلال تناول المفاهيم التالية والعلاقة القائمة بينها بالدراسة والتحليل، وهي كالآتي:
عرف مفهوم الهوية انتشاراً واسعاً، حيث اكتسح في وقت قصير العلوم الإنسانية وخاصةً الاجتماعية، وفرض نفسه في تحليل حقائق متنوعة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الصعب أن تجد تعريفاً متوافقاً عليه لمفهوم الهوية. وقد أثبتت الدراسات السوسيولوجية من أن لكل جماعة أو أمة ما مجموعة من الخصائص والمميزات الاجتماعية، والنفسية، والمعيشية، والتاريخية المتماثلة، التي تعبّر عن كيان ينصهر فيه قوم منسجمون ومتشابهون بتأثير هذه الخصائص والميزات التي تجمعهم.
وفي حقيقة الأمر يعاني مفهوم الهوية من مشاكل عديدة، فمن صعوبة الحديث عن الهوية مثلاً، أنه حديث الذات عن نفسها. لذا فإن مشاعر الهوية مشاعر دفاعية ضد إرادة السحق التي يبديها الآخر، كذلك لا يمكن فصل الهوية عن الحركية الاجتماعية، وما يجري فيها من تدافع وصراع. وهنا تتداخل حدود الهوية والسلطة والإيديولوجيا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الهوية ؟
في البداية يجب أن نشير أن المقصود في هذا العنصر هو الهوية الثقافية لجماعة بشرية معينة، ذلك أن جوهر الهوية الجماعية هو الثقافة بذلك فإن الهوية الجماعية تستمد ملامح مقوماتها من ثقافة المجتمع على اعتبار أن الثقافة تشكل المجموع المنسجم والمستمر للمعاني والرموز المكتسبة المشتركة التي تعمل الجماعة على توصيلها وإعادة إنتاجها من خلال مختلف القنوات التي تنسجها من أجل هذه الغاية. أما عن مفهوم الهوية فهو لفظ تراثي قديم، معناه أن يكون الشيء هو هو وليس غيره، أي ليس له مقابل مما يدل على ثبات الهوية. وهو قائم على التطابق أو الاتساق في المنطق. وهو نقيض الغيرية وقد تكون الغيرية نسبية وليست كلية لتحدد انحراف الهوية. فإن هوية الشيء هي ثوابته، التي تتجدد لا تتغير، تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون أن تخلي مكانها لنقيضها، طالما بقيت الذات على قيد الحياة.