 ما التراث ؟ :
ما التراث ؟ :
حينما نتحدث عن التراث فإننا نتحدث عن أفكار ومناهج ، ومذاهب وتيارات ، وإشكالات وحلول ، وثوابت ومتغيرات ، نتحدث عن نجاحات وإخفاقات حدثت في الماضي القريب والبعيد .... من التراث ما يمتد تأثيره إلى اليوم وما بعد اليوم ، ومنه ما قد نسي فلم يبق لذكره أثر ، منه ما كان سببا في وجودنا وإمدادنا بعناصر القوة والاستمرارية ، ومنه ما كان سببا في تفشي مظاهر الضعف فينا والوهن.
وإذا كانت بدايات مسار التراث غائرة في الماضي ، متشعبة المصادر والروافد ، فإن نهاياته الحالية هو ما كتبناه وأنجزناه بالأمس القريب في سنتنا هذه وفي شهرنا هذا ، وما ننتجه اليوم هو تراث الغد ، ونحن وإن كنا خلف من قبلنا ، فنحن أيضا سلف من سيأتي بعدنا ، ما نحن في الأخير - شئنا أم أبينا - إلا حلقة من حلقات التراث .
التراث مستمر بنا وفينا وعن طريقنا ، وينبغي أن نقر بأنه يضم تجارب وخبرات إنسانية تشمل الحق والباطل ، والصواب والخطأ ، وهو وعاء ضخم لا يكف عن التمدد والاتساع ، يتضمن خبرات اللغة والأدب ، والاجتماع والسياسة ، والفقه والفلسفة ، والعلم والنظر .... ويشمل أيضا – عند الكثير من الباحثين – الوحي ومعارفه ، ولا مشاحة في الأسماء إذا ضبطت المعاني .
بين دعوات القطيعة ونزعات التصنيم :
السوي في وقفة النفري ـ خالد بلقاسم
 1- إشارة
1- إشارة
اقترنت التجربة الروحية والكتابية عند النفري بالوقفة التي تقوم لديه على حمولة دلالية باذخة. الاقتراب من هذا البذخ واستنبات أسئلة تضيئه يتطلبان العثور على المسالك القرائية المسعفة. وهو ما يسمح به مفهوم السوي في هذه التجربة. يعد مفهوم السوي من المداخل القرائية التي تتيح الاقتراب من تجربة الوقفة كما يقدمها كتاب المواقف والمخاطبات للنفري. فالعبور إلى الوقفة لا يستقيم إلا بالانفصال عن السوي, الذي يا خد,في خطاب النفري,دلالة متشعبة تتحكم فيها محدوديته من جهة, وتعدد وجوهه من جهة أخرى. تتطلب الوقفة بوصفها لقاء مع الله, أو محاورة بين الواقف والمطلق, خروجا من السوي وحكمه, ثم إلغاء له فيما بعد. فلا وقفة ما بقي للسوي أو الغير اثر,على نحو ما يتبدى مما سمعه النفري في إحدى مناجياته مع ربه,إذ قيل له " أنت عبد السوي ما رأيت له أثرا[1]". ولكن المفارقة هي أن السوي لا حدود له. ذلك ما أخبر به النفري لما قيل له " إذا عرفتك سواي فأنت اجهل الجاهلين,والكون كله سواي[2] ". وهذا ما جعل الانفصال عن حكم السوي انفصالا عن الكون كله. وبهذا يصبح الانفصال تجربة على حافة المستحيل. للسوى امتداد وتعدد لا حد لهما. وهما يؤكدان أن الانفصال عن السوي لا ينحصر في زمن دون غيره, بل يشمل التجربة من خارج مقاييس البداية والنهاية, لأن هذا الانفصال محدد لها. الانفصال تجربة مصيرية في العبور إلى الوقفة. وتحقق العبور لا يعني نهاية الانفصال, بل انه يظل مستمرا في مراقبة لا تقبل بالسهو.
انتقادات ابن رشد على جالنيوس من خلال مؤلفه الكليات في الطب ـ د. حسن كامل إبراهيم
 مما لا شك فيه أن العرب استفادوا من التراث الدخيل الذي يضم بين طياتة تراث الفرس، والهند، واليونان، إلخ. ولم يقلد العرب هذا التراث وبخاصة اليوناني منة تقليداً أعمى بل إنهم تلقوه بعين المتفحص المدقق، لذلك استخرجوا ما فيه من أخطاء ومفاسد لا تتفق مع عقيدتهم ولا مع المشاهدة والتجربة والعقل السليم، ولأجل ذلك كانت انتقاداتهم واعتراضاتهم وشكوكهم على هذا التراث. وهذا ما حدث لما ورثة العرب من تراث طبي عن اليونان، فقد خطأ غير واحد من العرب أساطين الطب اليوناني أمثال أبقراط Hippocrates (460 ؟ ـ 377 ؟ ق. م)، وجالينوس Galen (129 ـ 199؟ م)، ويبدو ذلك بوضوح في مؤلفـات كثير مـن العرب أمثـال: أبو بكـر محمد بن زكريا الرازى
مما لا شك فيه أن العرب استفادوا من التراث الدخيل الذي يضم بين طياتة تراث الفرس، والهند، واليونان، إلخ. ولم يقلد العرب هذا التراث وبخاصة اليوناني منة تقليداً أعمى بل إنهم تلقوه بعين المتفحص المدقق، لذلك استخرجوا ما فيه من أخطاء ومفاسد لا تتفق مع عقيدتهم ولا مع المشاهدة والتجربة والعقل السليم، ولأجل ذلك كانت انتقاداتهم واعتراضاتهم وشكوكهم على هذا التراث. وهذا ما حدث لما ورثة العرب من تراث طبي عن اليونان، فقد خطأ غير واحد من العرب أساطين الطب اليوناني أمثال أبقراط Hippocrates (460 ؟ ـ 377 ؟ ق. م)، وجالينوس Galen (129 ـ 199؟ م)، ويبدو ذلك بوضوح في مؤلفـات كثير مـن العرب أمثـال: أبو بكـر محمد بن زكريا الرازى
( تـ 313هـ /925م)،وعلى بن العباس المجوسى ( تـ 994 م )، وأبو على محمد بن الحسن بن الهيثم (تـ432 هـ / 1047 م)،والمختار بن الحسين بن عبدون البغدادي المعرف بابن بطلان (ت 458 هـ / 1066م )، وعلى بن رضوان بن على بن جعفر المصري المعروف بابن رضوان (تـ 460 هـ)، وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس المعروف بالشريف الإدريسي (تـ 560 هـ / 1165 م)، وموفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على بن أبى سعد البغدادي المعروف بعبد اللطيف البغدادي ( تـ 629 هـ / 1231 م) وعلاء الدين على بن أبى الحزم القرشي المعروف بابن النفيس (تـ 687 هـ / 1288م)، وداود بن عمر الأنطاكى (تـ 1008 هـ/1600 م)، إلخ. وفيما يلي سنذكر أمثلة على انتقادات العرب واعتراضاتهم وشكوكهم على اليونان وعلى بعضهم بعضا
الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر : نظرة نقدية – كرستيان ترول ـ ت : د. حامد فضل الله
 . خلفية تمهيدية: التجديد الإسلامي
. خلفية تمهيدية: التجديد الإسلامي
في البداية من المفيد أن نتبين الخلفية ونحدد الإطار الذي نريد من خلاله تقديم الفكر التقدمي في الإسلام المعاصر. إن الحركات والاتجاهات التي تشغل العالم الإسلامي المعاصر يمكن تحليلها في المساحة المتوترة بين مفهومي الأصالة والحداثة. إن مثل هذا المدخل يضع في اعتباره الإسلام المعاصر في المساحة المتوترة بين الأصالة فيما يتعلق بأمور الحياة والفقه الديني النابعة من الماضي، والحداثة التي تحيل إلى الحاضر و "المستقبل" الذي لم يعد يجد المسلمون أنفسهم فيه كمحرك قوة ولذلك ليس بمقدورهم التحكم في تطور الفكر.
القرآن – أزلي وغير قابل للتغيير
القرآن الكتاب المنزل من عند الله يعتبر جوهر العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب يعتبر كتاباً أزلياً وغير قابل للتغيير من حيث الشكل و المضمون. ويعتقد المؤمنون به أنه يصلح لكل مكان وزمان وأنه يحوي بين دفتيه الحقيقة الأزلية. وفي المقابل تتسم فكرة الحداثة بالنسبية فيما يتعلق بالحقيقة وبعامل تطورها المستمر. فبالنسبة للحداثة لا يوجد أي شيء سواء كان مكتوباً أو منطوقاً لا يحق ولا يمكن للإنسان إعادة صياغته وتطويره أو التشكيك في صحته. وهكذا يجد الإسلام نفسه بين طرفي الرحى: رحى الحقيقة الأزلية الثابتة الموجودة بين دفة القرآن من ناحية، ومن ناحية أخرى رحى الحداثة التي ترى أن جميع الأمور قابلة لإعادة الصياغة والتطور الدائم. وهنا يطرح السؤال التالي نفسه: هل يوجد الحل في تحديث الإسلام أم في أسلمة الحداثة؟ ومن واجب المسلمين تقديم الإجابة عليه.
ابن رشد في فكر رواد الإصلاح في النهضة العربية الحديثة ـ مولاي رشيد غلابي
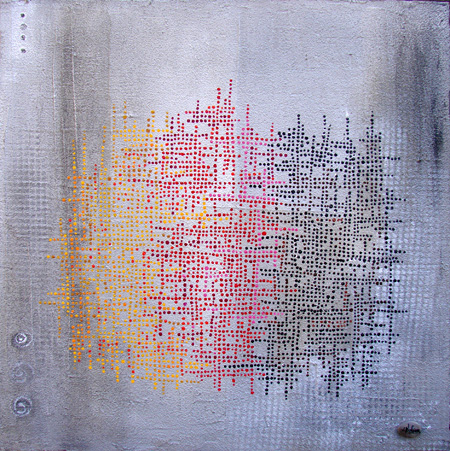 يختلف الباحثون في تحديد اللحظة التاريخية التي يمكن أن يطلق عليها بداية النهضة العربية، لكنها على العموم لحظات متقاربة تتراوح بين الحملة الفرنسية، بقيادة نابليون، على فلسطين ومصر (1798-1801) و ولاية محمد علي على مصر (1805) وإطلاقه مشروعه الإصلاحي الذي عم نظام الحكم، والجيش، والإدارة، والتعليم، والصناعة، والزراعة وغيرها.
يختلف الباحثون في تحديد اللحظة التاريخية التي يمكن أن يطلق عليها بداية النهضة العربية، لكنها على العموم لحظات متقاربة تتراوح بين الحملة الفرنسية، بقيادة نابليون، على فلسطين ومصر (1798-1801) و ولاية محمد علي على مصر (1805) وإطلاقه مشروعه الإصلاحي الذي عم نظام الحكم، والجيش، والإدارة، والتعليم، والصناعة، والزراعة وغيرها.
وإذا كان من الصعب تحديد تاريخ معين للانتقالات التاريخية الكبرى، كونها لا تقع في لحظة زمانية واحدة، كما أن حركية التاريخ لا تسير في خط مستقيم متصل بنفس الوتيرة في الزمان والمكان بل يكتنفها كثير من التداخل بين المراحل والتمفصلات التي يحددها المؤرخون والتي لا تعدو في النهاية أن تكون تقسيمات منهجية تتوخى الاقتراب من الواقع لا كونها تقسيمات موضوعية عامة وشاملة، فإن لحظة الالتقاء بين الحضارة العربية الإسلامية التي كانت في طور متقدم من أطوار الانحدار والحضارة الغربية الحديثة التي كانت في طور الصعود قد شكل لحظة فارقة في حياة الأمة وفي وعي النخبة.
لقد بدأ منذ هذه اللحظة الوعي بالتقابل بين القديم الموروث والجديد الوافد، وعي تزامن وترابط مع الوعي بضرورة الإصلاح والتماس أسباب النهوض للخروج من طور الانحطاط، فانقسم دعاة الإصلاح في الوطن العربي إلى فرقتين: أنصار القديم وأنصار الجديد، وفرقة ثالثة من دعاة التوفيق بين القديم والجديد.
هل تعرف صورتك الباطنة ؟ ـ د.أحمد غاني
 من السهل رصد ملامح الصورة الظاهرة للإنسان ،بل من الممكن اعتمادا على ماأنتجه الإنسان من تقنيات تتبع هذه الصورة في جزئياتها واختزانها ولو في مختلف تلوناتها الزمانية،ولكن من الصعب إن لم نقل من المستحيل رصد صورة هذا الإنسان الباطنة ، أي رصد وجدانه ،وإدراك حقيقة هذا الوجدان في كافة تضاريسه.أجل قد نتمكن من تتبع بعض المؤشرات والقرائن التي نتخيل من خلالها هذه الصورة المختفية وراءالصورة الظاهرة، ولكن هذا الخيال يبقى هلاميا يتلون بألوان المواقف التي تصدر من الذات التي نسعى لتخيل وجدانها واستكشافه ، وتبقى هاته الصورة قابلة للتلون بمختلف الألوان ، مستعدة لأن تفاجأنا بما لم يكن في الحسبان ، فهذا الوجدان قابل لأن ينتقل من القسوة إلى الرقة ، من الضعف إلى القوة ، من الفرح إلى الحزن ، من القبض إلى البسط ، فنجد أنفسنا أمام تقلبات لايفسرها إلا ماورد في الحديث الشريف :" إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء "[1] .
من السهل رصد ملامح الصورة الظاهرة للإنسان ،بل من الممكن اعتمادا على ماأنتجه الإنسان من تقنيات تتبع هذه الصورة في جزئياتها واختزانها ولو في مختلف تلوناتها الزمانية،ولكن من الصعب إن لم نقل من المستحيل رصد صورة هذا الإنسان الباطنة ، أي رصد وجدانه ،وإدراك حقيقة هذا الوجدان في كافة تضاريسه.أجل قد نتمكن من تتبع بعض المؤشرات والقرائن التي نتخيل من خلالها هذه الصورة المختفية وراءالصورة الظاهرة، ولكن هذا الخيال يبقى هلاميا يتلون بألوان المواقف التي تصدر من الذات التي نسعى لتخيل وجدانها واستكشافه ، وتبقى هاته الصورة قابلة للتلون بمختلف الألوان ، مستعدة لأن تفاجأنا بما لم يكن في الحسبان ، فهذا الوجدان قابل لأن ينتقل من القسوة إلى الرقة ، من الضعف إلى القوة ، من الفرح إلى الحزن ، من القبض إلى البسط ، فنجد أنفسنا أمام تقلبات لايفسرها إلا ماورد في الحديث الشريف :" إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء "[1] .
تباين مفهوم الشخصية عند علماء المسلمين ـ إيناس بن سليم
 يجدُ الباحث في مفهوم الشخصية من المنظور الإسلامي تباينا في وجهات نظر الدّارسين والمهتمين بهذا الشأن،حيث إن هناك من يعترض أساساً على استخدام تسمية (الشخّصية)، ويرى أن الأنسب من وجهة النظر الإسلامية استخدام تسمية (الذات الإنسانية) لأنها أدق في التعبير عن طبيعة الإنسان.
يجدُ الباحث في مفهوم الشخصية من المنظور الإسلامي تباينا في وجهات نظر الدّارسين والمهتمين بهذا الشأن،حيث إن هناك من يعترض أساساً على استخدام تسمية (الشخّصية)، ويرى أن الأنسب من وجهة النظر الإسلامية استخدام تسمية (الذات الإنسانية) لأنها أدق في التعبير عن طبيعة الإنسان.
وهناك باحث يُشير – على استحياء- إلى أن علماء المسلمين الأوائل ابتعدوا عن الخوض في دراسة الشخصية لغلبة ظنهم بأن الروح والنفس من الأمور الإلهية ومن ثم أمسكوا عن اقتحام مجهولها امتثالا للآية الكريمة " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " الإسراء -85.
ومن الباحثين من يرى " أن استخدام كلمة النفس في القرآن الكريم لا تعني الروح بل تعني الشخصية الإنسانية ".
إلى آخر يعلل عدم وجود تعريف واضح للشخصية كما نجده عند علماء الغرب بقوله:" لم يكتب لعلم النفّس أن يأخذ حظّه وينمو ويترعرع أو ينصهر في بوتقة العلوم الإسلامية لزمن طويل.. وقرون عديدة، كما أخذت بعض العلوم كالفلسفة والفقه والرّياضيات وعلم الفلك " ولعلّه من الأنسب قبل الخوض في تعريف الشخصية ومفهومها في المنظور الإسلامي أن نتوقف قليلاً عند العقلية العربية منذ عصر الجاهليّة لنسّلط الضوء على تصور الإنسان في تلك البيئة التي بزغ فيها نور الإسلام ليبدّل ما فيها من تصوّرات لاشك أن الإنسان أهم عنصر من عناصرها.
الجامعة الزيتونية.. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ـ عزالدّين عناية
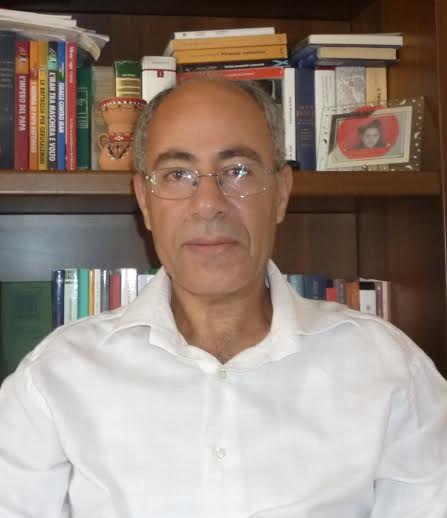 المقال مهدى إلى محسن العوني
المقال مهدى إلى محسن العوني
بموجب الفترة المطوَّلة التي قضّيتها في جامعة الزيتونة في تونس طالبا وباحثا، على مدى السنوات المتراوحة بين منتصف الثمانينيات ومنتصف التسعينيات من القرن الماضي، سيكون جلّ اهتمامي في هذه المقالة منصبّا على التعرّض إلى تجربة التحصيل العلمي، إضافة إلى استحضار واقع الصراع على الزيتونة، بقصد التأمل في مسارات ومآلات مؤسسة دينية، لا تزال مثار جدل، لا سيما في ظل التحولات العميقة التي يشهدها مجتمعنا.
من الزيتونة إلى الغريغورية
غدا بمثابة اليقين لديّ، أن الإشكال الرئيس الذي يعاني منه الدرس الديني في مؤسساتنا التعليمية في تونس متلخص أساسا في أمرين: خضوع المقرّر التعليمي إلى وصاية سياسية توجه مساراته، ما انعكس على مضامينه وتطلعاته وآفاقه؛ ومن جانب آخر مجافاة منهج التعليم الديني للراهنية الحضارية، وهو ما يتجلى في غياب عناصر الواقعية، والعلمية، والمعقولية.











