 تبدو الكنيسة في تونس، التي ينطبق عليها بحق نعت الكنيسة العابرة جراء التبدّل الدائم لرأسها ولقاعدتها، قد تخطّت مرحلة التوجّس، بعد أن مرّ زهاء العام على تسنّم "حركة النهضة" ظهر السلطة في تونس. فبعد أن أدمنت الكنيسة ريبة من بلوغ حزب إسلامي مقاليد الحكم، وعملت على إشاعة تلك الريبة في الغرب، ها هي تتخلّص من مخاوفها، وتشهد تغيرا في الخطاب يتجه نحو الرصانة، بعد تبنّيها طويلا رؤية التقت فيها مع مقول نظام بن علي. مع أن الكنيسة في تونس لم تشهد أي مظهر من مظاهر التلاسن أو التصادم، مع الحركة الإسلامية في تونس، أو مع رموزها، بشأن قضية مّا، منذ مطلع السبعينيات، تاريخ طفو تلك الحركة على الساحة.
تبدو الكنيسة في تونس، التي ينطبق عليها بحق نعت الكنيسة العابرة جراء التبدّل الدائم لرأسها ولقاعدتها، قد تخطّت مرحلة التوجّس، بعد أن مرّ زهاء العام على تسنّم "حركة النهضة" ظهر السلطة في تونس. فبعد أن أدمنت الكنيسة ريبة من بلوغ حزب إسلامي مقاليد الحكم، وعملت على إشاعة تلك الريبة في الغرب، ها هي تتخلّص من مخاوفها، وتشهد تغيرا في الخطاب يتجه نحو الرصانة، بعد تبنّيها طويلا رؤية التقت فيها مع مقول نظام بن علي. مع أن الكنيسة في تونس لم تشهد أي مظهر من مظاهر التلاسن أو التصادم، مع الحركة الإسلامية في تونس، أو مع رموزها، بشأن قضية مّا، منذ مطلع السبعينيات، تاريخ طفو تلك الحركة على الساحة.
الواقع الديني الجديد في تونس ـ د. عزالدين عناية
 ما فتئ النظر في الواقع الديني في تونس موسوما بطابع دعائي إيديولوجي، وهو عائد بالأساس إلى تردّي الثقافة العلمية بشقّيها السوسيولوجي والأنثروبولوجي، الغائبة عن رصد الحقل الاجتماعي وما يمور به من تحولات مستجدة. ليحضر بدل ذلك حكمٌ أكاديمي جاهز تعجز أدواته البالية عن كنه التحولات الاجتماعية، إلى جانب موقف فقهي تقليدي ومحافظ يرى المشروعية في ما وجدنا عليه آباءنا، دون إعارة اهتمام لقاعدة تبدّل الأحكام بتحول الأزمان. والحال أن هناك تعبيرات دينية قديمة ومستجدّة في الواقع التونسي ترفض الوصاية المذهبية المالكية، ما انفكت تعاني الطمس والقمع وتبحث بجهد جهيد عن الحضور، مثل الأحناف، و"الإباضيين" (المسمّون تحقيرا بالخوارج)، والمتشيّعين، والمتنصّرين، (أعلن مارون لحام أسقف تونس أن معدّل المعمَّدين وفق الطقس الكاثوليكي بين ثلاثة وأربعة أنفار سنويا وذلك في محاضرة ألقاها في خورنية في مدينة بريتشا الإيطالية).
ما فتئ النظر في الواقع الديني في تونس موسوما بطابع دعائي إيديولوجي، وهو عائد بالأساس إلى تردّي الثقافة العلمية بشقّيها السوسيولوجي والأنثروبولوجي، الغائبة عن رصد الحقل الاجتماعي وما يمور به من تحولات مستجدة. ليحضر بدل ذلك حكمٌ أكاديمي جاهز تعجز أدواته البالية عن كنه التحولات الاجتماعية، إلى جانب موقف فقهي تقليدي ومحافظ يرى المشروعية في ما وجدنا عليه آباءنا، دون إعارة اهتمام لقاعدة تبدّل الأحكام بتحول الأزمان. والحال أن هناك تعبيرات دينية قديمة ومستجدّة في الواقع التونسي ترفض الوصاية المذهبية المالكية، ما انفكت تعاني الطمس والقمع وتبحث بجهد جهيد عن الحضور، مثل الأحناف، و"الإباضيين" (المسمّون تحقيرا بالخوارج)، والمتشيّعين، والمتنصّرين، (أعلن مارون لحام أسقف تونس أن معدّل المعمَّدين وفق الطقس الكاثوليكي بين ثلاثة وأربعة أنفار سنويا وذلك في محاضرة ألقاها في خورنية في مدينة بريتشا الإيطالية).
تــاريـــخ الــــزمـــن الـــراهــــن بالمغرب :الــمفهـــوم و الإشــكالــيات ـ حسام هاب
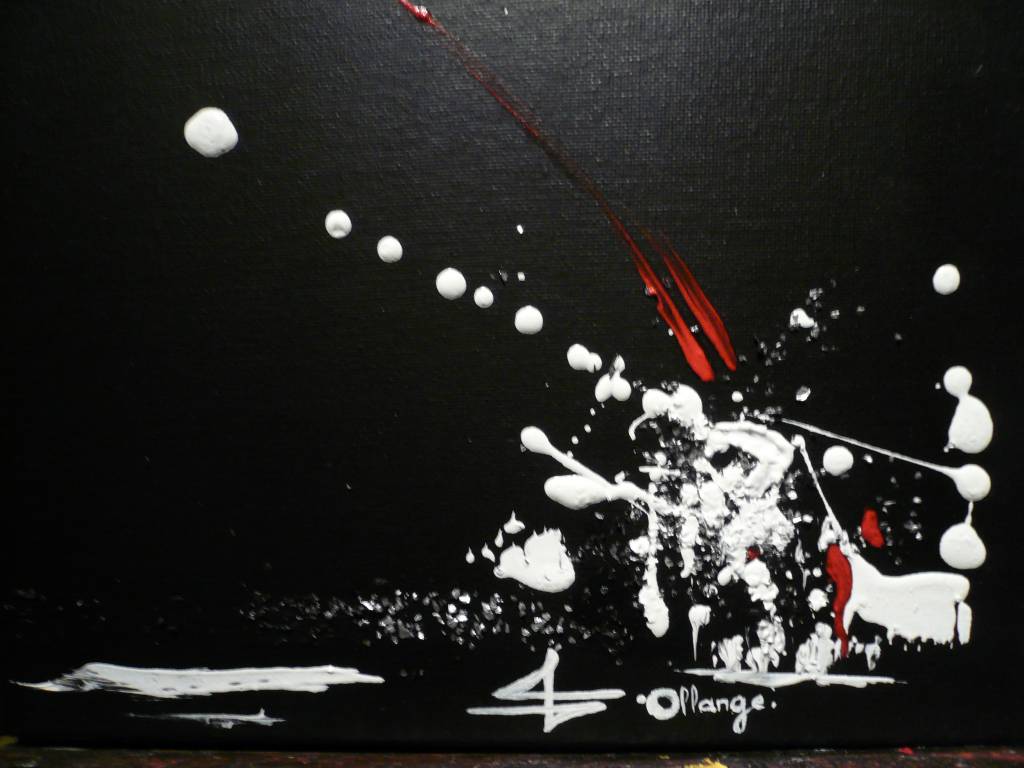 عرفت "المدرسة التاريخية المغربية" تحولا مهما من خلال مواضيعها و مقارباتها و إشكالياتها، حيث برزت في فضاء المعرفة التاريخية المغربية محاولات هامة و جادة لطرق مجالات جديدة في البحث التاريخي: كالتاريخ الاجتماعي، و التاريخ الاقتصادي، و الأنثروبولوجيا التاريخية، و تاريخ العقليات، و تاريخ الزمن الراهن؛ الذي يعتبر أحد حقول البحث التاريخي التي بدأ الاهتمام بها من طرف الباحثين المغاربة.
عرفت "المدرسة التاريخية المغربية" تحولا مهما من خلال مواضيعها و مقارباتها و إشكالياتها، حيث برزت في فضاء المعرفة التاريخية المغربية محاولات هامة و جادة لطرق مجالات جديدة في البحث التاريخي: كالتاريخ الاجتماعي، و التاريخ الاقتصادي، و الأنثروبولوجيا التاريخية، و تاريخ العقليات، و تاريخ الزمن الراهن؛ الذي يعتبر أحد حقول البحث التاريخي التي بدأ الاهتمام بها من طرف الباحثين المغاربة.
لقد ظل تاريخ الزمن الراهن مجالا ترتاده بالأساس دراسات العلوم السياسية، و علم الاجتماع، و الأنثروبولوجيا، و المذكرات، و أقلام صحفية تتفاوت في المهارة و النفس التوثيقي، مما جعل هذه التخصصات هي الأكثر رصدا للتحولات السياسية، و الاجتماعية، و الاقتصادية، و الثقافية، و الذهنية، التي عرفها مجتمع ما خلال تاريخه الراهن. أما المؤرخ فقد بقي اقتحامه لهذه المرحلة محدودا للغاية، خاصة أن تاريخ الزمن الراهن يطرح لحقل البحث التاريخي إشكاليات على مستوى المفهوم، و التحقيب، و المصادر، و البيبليوغرافيا، و المناهج، مع وجود عوائق ذاتية و موضوعية أعاقت اهتمام المؤرخين بدراسة و تحليل تاريخ الزمن الراهن.
تغييب الخطاب الديني التنويري في تونس ـ د. عزالدين عناية
 تعرف تونس في الراهن الحالي تشظيا للمرجعية الدينية، بما جعل فئات واسعة من الناس عرضة للتجييش والتوظيف المخل بالنظام العام وبما ينافي الصالح العام. وهو ما تطفو مؤشراته في الساحة التونسية من خلال تدافع مقيت يزحف فيه خطاب عنيف ويتقلّص منه القول الرشيد، غالبا ما اختزله الإعلام في توصيف هلامي مبهم نعته بـ"الجماعات السلفية". وما يزيد الأمر سوءا غياب تكتل ديني رسمي أو غير رسمي قمين بكسب ثقة التونسيين والتعويل عليه.
تعرف تونس في الراهن الحالي تشظيا للمرجعية الدينية، بما جعل فئات واسعة من الناس عرضة للتجييش والتوظيف المخل بالنظام العام وبما ينافي الصالح العام. وهو ما تطفو مؤشراته في الساحة التونسية من خلال تدافع مقيت يزحف فيه خطاب عنيف ويتقلّص منه القول الرشيد، غالبا ما اختزله الإعلام في توصيف هلامي مبهم نعته بـ"الجماعات السلفية". وما يزيد الأمر سوءا غياب تكتل ديني رسمي أو غير رسمي قمين بكسب ثقة التونسيين والتعويل عليه.
بما يشي أن البلاد ليست مقبلة في الأفق القريب على الخروج من نفق التجاذبات الدينية، التي تخيم بظلالها على القطاعات الثقافية والاجتماعية بشكل عام، وذلك جراء أن تونس في حالة تحول عميقة. لكن رغم تلك الحقيقة فإن سبل الخروج من ذلك الواقع المرتبك تبدأ من التشخيص الموضوعي للحالة بتجرد، بعيدا عن الاتهامات المتسرعة التي تُرمى هنا وهناك والتي تؤجج الاحتقان ولا تفيد شيئا في بناء الوئام الاجتماعي المنشود. إذ أقدر أن الواقع المستنفر عائد بالأساس إلى عامل محوري يتمثل في أن المشترك الإدراكي للدين، أي الوعي الديني الشائع بين الناس، غدا مسكونا بالتسييس المفرط، النابع من قلة التروي وضيق الرؤى وغربة الخطاب، بما خلف ضبابية بين عامة الناس.
الرماية جزء من التراث الشعبي المغربي ـ حـــســام هـاب و سعيد إدبراهيم
 يعتبر التراث الشعبي أحد الركائز الأساسية المشكلة للهوية الحضارية ، و الثقافية لأية جماعة بشرية أو مجتمع ما ؛ نظرا لأنه تجسيد لأفكار هذا المجتمع و وجدانه و تصوراته . و تبرز من خلال هذا التراث هوية أي مجتمع باعتباره يشكل عنوانا لشخصيته التاريخية و الثقافية ، و يوضح معالم كيانه و ملامح وحدته الاجتماعية و الاثنوغرافية ، و يعكس بنيته الثقافية و الفكرية و الذهنية ، و يندرج في اللحظة التاريخية المكونة لنسيج العلائق الاجتماعية ، و أنماط الوعي الاجتماعي . فهو معلم مشع في هذه اللحظة التاريخية لأنه ينطوي على إمكانات هائلة في الابداع و الممارسة الثقافية الشعبية . و من ثم فإنه نافذة مشرعة تطل منها الثقافة و الأدب في أي مجتمع على أفق مغاير نحو الارتباط بالانسان وواقعه الاجتماعي و الثقافي .
يعتبر التراث الشعبي أحد الركائز الأساسية المشكلة للهوية الحضارية ، و الثقافية لأية جماعة بشرية أو مجتمع ما ؛ نظرا لأنه تجسيد لأفكار هذا المجتمع و وجدانه و تصوراته . و تبرز من خلال هذا التراث هوية أي مجتمع باعتباره يشكل عنوانا لشخصيته التاريخية و الثقافية ، و يوضح معالم كيانه و ملامح وحدته الاجتماعية و الاثنوغرافية ، و يعكس بنيته الثقافية و الفكرية و الذهنية ، و يندرج في اللحظة التاريخية المكونة لنسيج العلائق الاجتماعية ، و أنماط الوعي الاجتماعي . فهو معلم مشع في هذه اللحظة التاريخية لأنه ينطوي على إمكانات هائلة في الابداع و الممارسة الثقافية الشعبية . و من ثم فإنه نافذة مشرعة تطل منها الثقافة و الأدب في أي مجتمع على أفق مغاير نحو الارتباط بالانسان وواقعه الاجتماعي و الثقافي .
جامعة الزّيتونة.. العقل الديني التونسي المستقيل ـ د. عزالدّين عناية
 في خضمّ بحث العقل في الفضاء الإسلامي عن اكتشاف سبل الانبعاث الحضاري، يجدر الالتفات للمؤسّسات العلمية، الدّينيّة منها بالأساس، في ما أنتجته وما تنتجه من وعي ورؤى ومفاهيم، وتمعّن مثلّث: المحتوى المعرفي والمنتِج المعرفي والخرّيج العلمي. ومن ثمّة تبيّن الدور الحضاري-المعرفي للمؤسّسة، في فضائها العائدة إليه بالنظر والمرتبطة به. سيكون اهتمامي بالجامعة الزيتونية في هذه الدّراسة لاعتبارين أساسيين: لما ربطتني من وشائج قربى واقتراب بالمؤسّسة، حيث لازمتها طيلة مراحل التكوين الجامعي بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؛ ولانشغالي بالظاهرة الدّينية في حقلها الإسلامي وفي مجالها العالمي الموسّع في علم الأديان. ولم يقتصر بحثي على تناول الزّيتونة في حدّ ذاتها بل تطلّع إلى ربط المؤسّسة بالصيرورة التاريخية التطوّرية العامة، لما شكّلته من آلة يُقاس عليها واقع حال عقل كتل بشرية بمجملها.
في خضمّ بحث العقل في الفضاء الإسلامي عن اكتشاف سبل الانبعاث الحضاري، يجدر الالتفات للمؤسّسات العلمية، الدّينيّة منها بالأساس، في ما أنتجته وما تنتجه من وعي ورؤى ومفاهيم، وتمعّن مثلّث: المحتوى المعرفي والمنتِج المعرفي والخرّيج العلمي. ومن ثمّة تبيّن الدور الحضاري-المعرفي للمؤسّسة، في فضائها العائدة إليه بالنظر والمرتبطة به. سيكون اهتمامي بالجامعة الزيتونية في هذه الدّراسة لاعتبارين أساسيين: لما ربطتني من وشائج قربى واقتراب بالمؤسّسة، حيث لازمتها طيلة مراحل التكوين الجامعي بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؛ ولانشغالي بالظاهرة الدّينية في حقلها الإسلامي وفي مجالها العالمي الموسّع في علم الأديان. ولم يقتصر بحثي على تناول الزّيتونة في حدّ ذاتها بل تطلّع إلى ربط المؤسّسة بالصيرورة التاريخية التطوّرية العامة، لما شكّلته من آلة يُقاس عليها واقع حال عقل كتل بشرية بمجملها.
علم الاجتماع الديني ووقائع الإسلام المعاصر ـ عزالدين عناية
 خلال العشريتين الأخيرتين شكّلت مواضيع الدين والتديّن ومؤسّسة الكنيسة، أبرز العناوين في جدول اهتمامات الباحثين الاجتماعيين في إيطاليا. وقد حاز الإسلام نصيباً معتبراً من تأمّلات العاملين في ذلك المجال. كان موسم "ما بعد العلمنة"، كما سماه جوزي كازانوفا، حافلا بالاهتمام بالدين. برزت أثناءه طائفة من علماء الاجتماع الديني في إيطاليا، مثل: غوستافو غويزاردي، وماسيمو إنتروفينيي، وإنزو باتشي، وسابينو أكوافيفا، وفرانكو غاريلّي، وستيفانو ألِيافي، ورنزو غولو، وجيوفاني فيلورامو وآخرين. ثلّة من هؤلاء أوْلت الإسلام اهتماما خاصا، من بينهم ستيفانو أليافي، ورنزو غولو، وإنزو باتشي، وباولو برانكا. توزعت الأدوار وتكاملت، متمحورة حول ثلاثة مشاغل:
خلال العشريتين الأخيرتين شكّلت مواضيع الدين والتديّن ومؤسّسة الكنيسة، أبرز العناوين في جدول اهتمامات الباحثين الاجتماعيين في إيطاليا. وقد حاز الإسلام نصيباً معتبراً من تأمّلات العاملين في ذلك المجال. كان موسم "ما بعد العلمنة"، كما سماه جوزي كازانوفا، حافلا بالاهتمام بالدين. برزت أثناءه طائفة من علماء الاجتماع الديني في إيطاليا، مثل: غوستافو غويزاردي، وماسيمو إنتروفينيي، وإنزو باتشي، وسابينو أكوافيفا، وفرانكو غاريلّي، وستيفانو ألِيافي، ورنزو غولو، وجيوفاني فيلورامو وآخرين. ثلّة من هؤلاء أوْلت الإسلام اهتماما خاصا، من بينهم ستيفانو أليافي، ورنزو غولو، وإنزو باتشي، وباولو برانكا. توزعت الأدوار وتكاملت، متمحورة حول ثلاثة مشاغل:
المسيحيّة العربية تتطهّر من أدران التاريخ ـ د. عزالدين عناية
 حين اختلّ نظام التوازن الاجتماعي بين أطراف الدولة العثمانية، وجد استجداء أتباع المسيحية العربية النصرة والمعونة من إخوة الإيمان في الخارج مبرّرا. في زمن كانت فيه تلك الديانة منهَكَة على جميع الأصعدة. ولكن أن يستمرّ ذلك المسلك حتى عصرنا الراهن، فهو مما ينذر بوجود خلل عميق في البناء الاجتماعي يستدعي المراجعة والتصحيح. لأنه مما ينافي الصواب أن نزعم أن أتباع تلك الديانة ركن من أركان البيت، في وقت يلاقون فيه رهقا في دينهم ودنياهم في أحضان أوطانهم.
حين اختلّ نظام التوازن الاجتماعي بين أطراف الدولة العثمانية، وجد استجداء أتباع المسيحية العربية النصرة والمعونة من إخوة الإيمان في الخارج مبرّرا. في زمن كانت فيه تلك الديانة منهَكَة على جميع الأصعدة. ولكن أن يستمرّ ذلك المسلك حتى عصرنا الراهن، فهو مما ينذر بوجود خلل عميق في البناء الاجتماعي يستدعي المراجعة والتصحيح. لأنه مما ينافي الصواب أن نزعم أن أتباع تلك الديانة ركن من أركان البيت، في وقت يلاقون فيه رهقا في دينهم ودنياهم في أحضان أوطانهم.
فالناظر في انعكاسات الثورات المجتاحة للبلاد العربية يلحظ العديد من المحاسن التي طالت المسيحية، بما ألحقته من مراجعة لطبقات غائرة في الوعي، جراء ما أُدمن من رؤى وسلوكيات وعوائد، بتنا نراها بمثابة الأمر الواقع، سأولي تلك الآثار بعض الاهتمام.
طيلة العهود السابقة ساد خطاب غير علمي، في تناول واقع المسيحية في البلاد العربية، كان أقرب إلى التخمين الباطني منه إلى الرصد الموضوعي. وهو ما يتنافى مع أغراض التفهم الرصين والتقدير الصائب، فضلا عن مستوجبات التعاطي السياسي والتشريعي والحقوقي المتزن، ما يشي بوهن قدرات العقل في الثقافة العربية. فالقول بأن المسيحية العربية مكوّن أصيل في الثقافة العربية، وأن المسيحي شريك في الحضارة العربية الإسلامية، وَرد في مجمله ضمن أغراض الاستهلاك السياسي، بما افتقر إليه من مصداقية سوسيولوجية، وبما عازه من طرح جاد لمعنى ذلك المكوّن الأصيل ومدلولات تلك الشراكة الحضارية.










