 "إننا نعيش في مجتمع يسير بمعظمه نحو الحقيقة، أعني في مجتمع ينتج وينشر خطابا همه هو الحقيقة، أو يعتبره الناس كذلك، وله من جراء ذلك سلطة خاصة... "ميشيل فوكو
"إننا نعيش في مجتمع يسير بمعظمه نحو الحقيقة، أعني في مجتمع ينتج وينشر خطابا همه هو الحقيقة، أو يعتبره الناس كذلك، وله من جراء ذلك سلطة خاصة... "ميشيل فوكولعل السؤال الذي يظل أكثر إحراجا بل ربما الأكثر إزعاجا بالنسبة إلى العقول اليوم، فلاسفة كانوا أو علماء أو نقادا هو سؤال:" ما الحقيقة؟" ، ذلك أن هذه الكلمة مشبعة بالالتباس والغموض وتختلط بكلمات أخرى تتداخل معها في المعنى وتتشاكل في الدلالة مثل البداهة ، اليقين، الصلاحية، الصواب أو تتناقض معها وتفترق مثل الخطأ، الوهم، الكذب والظن والرأي، وهكذا لم يتولد عن هذه الكلمة سوى تماثلات لأفكار فضفاضة وما نسميه حقائق لا يعدو أن يكون سوى تماثلات لأفكار لا وجود لها في الواقع.
زد على ذلك أننا لا نكاد نظفر برؤية متماسكة تفضي إلى وضع حد جامع مانع لمفهوم الحقيقة تنقضي بمقتضاه فوضى الآراء حول قضية منزلتها الإبستيمولوجية في العلوم تصورات وانجازات بشكل يجعل النقد الابستيمولوجي يتحول إلى تفلسف موضوعي أو على الأقل يقترب من موضوعية العلوم الإنسانية.
ولعله لا يمكن أن نفهم هذه الفوضى إلا بالعودة إلى أزمنة البدء أيام كان العالم لم يزل بعد محاطا بالأسرار وأيام كانت المفاهيم تلمع في لحظة تشكلها الأولى وأيام كانت الكلمات لم تزل تمتلك سرية الإيماءة وسلطان الإشارة لنساءل النظريات والتجارب والنصوص في طزاجتها الأولى ونرتحل بين ثناياها وتفاصيلها إقبالا وإدبارا. طالما كانت الرحلة تعبيرا عن إصغاء الكائن لنداء الأقاصي تترجم رغبته في العبور من المجهول إلى المعلوم ومن المحدود المختزل إلى المطلق الخصب وذلك بتحطيم الأطر الضيقة والمقاربات المسقطة والمناهج الصارمة والتخلص من شروط الزمان والمكان.
نحن لا نزعم هنا تقديم القول الفصل في مسألة "مكانة الحقيقة في العلوم" وحسم الأمر بتقديم نظرة نهائية بل سنكتفي بتدقيق النظر في مواطن الشبهة والخلاف والبحث عن معنى الحقيقة بتوسيع دائرة التشخيص والمقارنة وبتكثيف الأسئلة حول هذه القضية. وأول ما يتبادر إلى الأذهان هو وجود جملة من الصعوبات تمنع الإحاطة بالموضوع وتوقع الفكر في نوع من الكبر والغرور.



 فلسفة هيجل: مضمونها، أنواعها:
فلسفة هيجل: مضمونها، أنواعها: مدخل :
مدخل : "فما زال التأويل هو أصعب جوانب فني بكل تأكيد. وإنني لأرى في نفسي القدرة على أن أتحدث عن هوميروس أفضل من أي شخص آخر."[1]
"فما زال التأويل هو أصعب جوانب فني بكل تأكيد. وإنني لأرى في نفسي القدرة على أن أتحدث عن هوميروس أفضل من أي شخص آخر."[1] "لا تقل علاقة الرسالة النصية بالقارئ عن علاقتها بالمؤلف. فحيث يتوجه الخطاب المنطوق إلى شخص يحدده الموقف الحواري سلفا...يتجه النص إلى قارئ مجهول وضمنا إلى كل من يعرف كيف يقرأ"[1]
"لا تقل علاقة الرسالة النصية بالقارئ عن علاقتها بالمؤلف. فحيث يتوجه الخطاب المنطوق إلى شخص يحدده الموقف الحواري سلفا...يتجه النص إلى قارئ مجهول وضمنا إلى كل من يعرف كيف يقرأ"[1] "كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء"
"كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء"  يعتبر مفهوم "الحرية" من بين أبرز مفاهيم الحداثة في فكر عبد الله العروي، حتى أنه أفرد له كتابا باسمه [1] ، بل إنه أول مفهوم يستهل به سلسلة المفاهيم ليختمها بمفهوم العقل، إلا أن لمفهوم الحرية مكانة بارزة في سلسلة المفاهيم، بحيث أنه لا دولة إلا دولة الحرية ولا عقل إلا العقل الحر غير المقيد أو الخاضع للرقابة الذاتية ولا يتجلى المفهوم فقط في الدولة وفي العقل بل قد تتجلى حتى في الاقتصاد فنقول الاقتصاد الحر وفي الدين فنتحدث عن حرية الاعتقاد قبل الاعتقاد… هذا بالإضافة إلى الحريات السياسية والمدنية… إلا أن كل هذه التجليات ترجع إلى الحرية من حيث هي مبدأ. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: لماذا يخط العروي كتابا عن الحرية؟ ألا يوجد هذا المفهوم في الثقافة العربية الكلاسيكية؟ ألم يعش المجتمع العربي الإسلامي التقليدي تجربة للحرية؟ وإذا كان قد عرفها، فما هو نوعها؟ وهل تطابق المفهوم الغربي للحرية أم أنها تختلف عنه ؟
يعتبر مفهوم "الحرية" من بين أبرز مفاهيم الحداثة في فكر عبد الله العروي، حتى أنه أفرد له كتابا باسمه [1] ، بل إنه أول مفهوم يستهل به سلسلة المفاهيم ليختمها بمفهوم العقل، إلا أن لمفهوم الحرية مكانة بارزة في سلسلة المفاهيم، بحيث أنه لا دولة إلا دولة الحرية ولا عقل إلا العقل الحر غير المقيد أو الخاضع للرقابة الذاتية ولا يتجلى المفهوم فقط في الدولة وفي العقل بل قد تتجلى حتى في الاقتصاد فنقول الاقتصاد الحر وفي الدين فنتحدث عن حرية الاعتقاد قبل الاعتقاد… هذا بالإضافة إلى الحريات السياسية والمدنية… إلا أن كل هذه التجليات ترجع إلى الحرية من حيث هي مبدأ. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: لماذا يخط العروي كتابا عن الحرية؟ ألا يوجد هذا المفهوم في الثقافة العربية الكلاسيكية؟ ألم يعش المجتمع العربي الإسلامي التقليدي تجربة للحرية؟ وإذا كان قد عرفها، فما هو نوعها؟ وهل تطابق المفهوم الغربي للحرية أم أنها تختلف عنه ؟
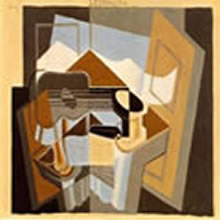 يسود الرأي لدى مؤرّخي الفلسفة أنّ التفكير الفلسفي و الكلامي لدى الفرق و المدارس اليهودية في السياق العربي الإسلامي في العصور الوسطى منطبع و متأثّر بالفلسفة العربية الإسلامية شديد التأثر، بل و يعدّ جزءا منها و أحد تمظهراتها منذ أواسط القرن الثامن الميلادي \ القرن الثالث هجري وخاصة في
القرون التالية مع ازدهار و انتشار حركة الترجمة و التأليف ، فقد كانت اللغة العربية في مجالات الإلاهيات و الفقه و علم الكلام و الفلسفة و الطب و الفلك و غيرها من العلوم و الفنون ، اللغة المعتمدة في التأليف و الكتابة لدى معظم العلماء و المؤلفين من مختلف الفرق و الديانات من مسلمين و مسيحيين و يهود. أتاح الإسلام هنا، كفضاء حضاري ذو أفق معرفي منفتح، انتشار و سيادة بنية إثنية و ثقافية تعددية متنوعة أفرزت بدورها
نموذج تعايش ثقافي اجتماعي تعدّدي متميز بالثراء و الحيوية، و لعلّ النموذج الأندلسي في العصور الوسيطة يعتبر أحد أهم تجليات هذا التعايش.
يسود الرأي لدى مؤرّخي الفلسفة أنّ التفكير الفلسفي و الكلامي لدى الفرق و المدارس اليهودية في السياق العربي الإسلامي في العصور الوسطى منطبع و متأثّر بالفلسفة العربية الإسلامية شديد التأثر، بل و يعدّ جزءا منها و أحد تمظهراتها منذ أواسط القرن الثامن الميلادي \ القرن الثالث هجري وخاصة في
القرون التالية مع ازدهار و انتشار حركة الترجمة و التأليف ، فقد كانت اللغة العربية في مجالات الإلاهيات و الفقه و علم الكلام و الفلسفة و الطب و الفلك و غيرها من العلوم و الفنون ، اللغة المعتمدة في التأليف و الكتابة لدى معظم العلماء و المؤلفين من مختلف الفرق و الديانات من مسلمين و مسيحيين و يهود. أتاح الإسلام هنا، كفضاء حضاري ذو أفق معرفي منفتح، انتشار و سيادة بنية إثنية و ثقافية تعددية متنوعة أفرزت بدورها
نموذج تعايش ثقافي اجتماعي تعدّدي متميز بالثراء و الحيوية، و لعلّ النموذج الأندلسي في العصور الوسيطة يعتبر أحد أهم تجليات هذا التعايش. إننا، في كثير من الأحيان، نحاكم الانتاجات الفكرية الماضية، انطلاقا من سياقنا التاريخي والفكري الراهن، وكأن المفاهيم التي عبرها يتم التفكير، كيانات ميتافيزيقية ثابتة ومتعالية على الصيرورة التاريخية. وبذلك نجحف في حق التراث الفكري، عندما لا نقرؤه في ضوء سياقه
التاريخي. وإن مفهوم"حالة الطبيعة" أو "الطور الطبيعي" في الفلسفة السياسية لفلاسفة العقد الاجتماعي خير مثال على هكذا سوء فهم، إذ يعتبره الكثير شطحا من الخيال، أو تحريفا للتاريخ البشري، أو فرضية لا تستند إلى أي أساس. فما هي دلالة مفهوم "الطور الطبيعي" في نظرية التعاقد الاجتماعي، في ضوء السياق التاريخي للقرنين السابع عشر والثامن عشر؟
إننا، في كثير من الأحيان، نحاكم الانتاجات الفكرية الماضية، انطلاقا من سياقنا التاريخي والفكري الراهن، وكأن المفاهيم التي عبرها يتم التفكير، كيانات ميتافيزيقية ثابتة ومتعالية على الصيرورة التاريخية. وبذلك نجحف في حق التراث الفكري، عندما لا نقرؤه في ضوء سياقه
التاريخي. وإن مفهوم"حالة الطبيعة" أو "الطور الطبيعي" في الفلسفة السياسية لفلاسفة العقد الاجتماعي خير مثال على هكذا سوء فهم، إذ يعتبره الكثير شطحا من الخيال، أو تحريفا للتاريخ البشري، أو فرضية لا تستند إلى أي أساس. فما هي دلالة مفهوم "الطور الطبيعي" في نظرية التعاقد الاجتماعي، في ضوء السياق التاريخي للقرنين السابع عشر والثامن عشر؟ نظرية العدالة عند جون راولز
نظرية العدالة عند جون راولز






