 ...دخلت "زهرة"مرحة كعادتها لإعداديتها الصغيرة المتواجدة في أطراف القرية.تجر لعب الطفولة و حب الحياة وراءها . تكسو جسدها الصغير بأجمل الثياب (فهي آخر العنقود في البيت و الكل يحبها و يدللها) . تلفت أنظار أهالي القرية النائمين وسط كوم من التقاليد و الممنوعات . قالوا عنها يوما : "اتركوها حتى تكبر,إنها ما تزال طفلة" .
...دخلت "زهرة"مرحة كعادتها لإعداديتها الصغيرة المتواجدة في أطراف القرية.تجر لعب الطفولة و حب الحياة وراءها . تكسو جسدها الصغير بأجمل الثياب (فهي آخر العنقود في البيت و الكل يحبها و يدللها) . تلفت أنظار أهالي القرية النائمين وسط كوم من التقاليد و الممنوعات . قالوا عنها يوما : "اتركوها حتى تكبر,إنها ما تزال طفلة" .عاشت "زهرة" تلك الأيام المشبعة بالطفولة، تتنقل في كل اتجاه كفراشة تزهو بألوانها المختلفة أيام فصل الربيع . و تعلن عن تحدي خفي يهدد أركان مؤسسة الشيخ. لا تراها إلا باسمة أو ساخرة من بعض الأقوال المترامية في القدم ."لماذا لا أمارس الرياضة؟"سؤال وجهته بعنف لإحدى صديقاتها الصامتات . و هكذا عرفت "زهرة" بأفكارها الثورية الهاربة من قلعة الشيخ .
جاءها في يوم من الأيام,في غفلة عنها,إنذار رسمي يقول:"زهرة.. احتشمي .لقد صرت امرأة.تصرفاتك كلها عيب." يومها رقصت "زهرة" و رقصت معها كل الأزهار المفقودة بالقرية . و أعلنت عن نجاحها الدراسي مرة أخرى بتفوق . و مزقت بذلك كل الحناجر التي نادت بعجزها عن الدراسة : العنوا هذه الفتاة إنها شيطان صغير..و لن تفلح في الدراسة.



 أبحث عن ذئب
أبحث عن ذئب
 "ولما صعّرتُ لها خدي وطاءً على الثرى
"ولما صعّرتُ لها خدي وطاءً على الثرى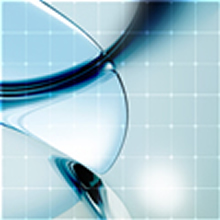 في يوم بعيد و شديد البرودة من أيام كانون قبل ثلاثين عاما وقف الأستاذ عبد الجليل نائب مدير المدرسة كعادته بوجهه الأحمر الملسوع من البرد قرب بوابتها الكبيرة المشرعة لابتلاع التلاميذ جماعات وفرادى ، ليس قربها بالضبط ، إنما بعيد بعض الشيء ، يذرع الأرض ذهابا وإيابا مطأطأ الرأس وقد لف ذراعيه خلف ظهره ، وأخذ باطن كفه الأيسر يحتضن قفا كفه الأيمن وتركهما يستريحا على العصعص . أحيانا يتوقف للحظات بين الفينة والأخرى ليطيل النظر إلى الأرض حوله كمن يبحث عن قطعة نقود ضائعة ، ثم يعود للمشي البطيء كالسلحفاة من جديد . وقد يضع كفه في جيب بنطاله ليدفئه ، فيخرج الكف وقد اصطاد حبة فول كان قد نسيها من زمن ، فيلقي بها في فمه كمن يلقي حجرا في حفرة عميقة ، وقد يقتنص الكف فتافيت ورق عتيق فيرمي بعضها ويحتفظ بالبعض الآخر.
في يوم بعيد و شديد البرودة من أيام كانون قبل ثلاثين عاما وقف الأستاذ عبد الجليل نائب مدير المدرسة كعادته بوجهه الأحمر الملسوع من البرد قرب بوابتها الكبيرة المشرعة لابتلاع التلاميذ جماعات وفرادى ، ليس قربها بالضبط ، إنما بعيد بعض الشيء ، يذرع الأرض ذهابا وإيابا مطأطأ الرأس وقد لف ذراعيه خلف ظهره ، وأخذ باطن كفه الأيسر يحتضن قفا كفه الأيمن وتركهما يستريحا على العصعص . أحيانا يتوقف للحظات بين الفينة والأخرى ليطيل النظر إلى الأرض حوله كمن يبحث عن قطعة نقود ضائعة ، ثم يعود للمشي البطيء كالسلحفاة من جديد . وقد يضع كفه في جيب بنطاله ليدفئه ، فيخرج الكف وقد اصطاد حبة فول كان قد نسيها من زمن ، فيلقي بها في فمه كمن يلقي حجرا في حفرة عميقة ، وقد يقتنص الكف فتافيت ورق عتيق فيرمي بعضها ويحتفظ بالبعض الآخر. استيقظت على صوت أرعن..
استيقظت على صوت أرعن.. 
 بـعـد أن ضاقـت الـسـبـل بـعـلـي واشـتـدت أزمـتـه الـمـالـية جـراء زيـادة نـفـقـاتـه بـدأ يـحـس بـثـقـل الـمـسـؤولـيـة الـمـلـقـاة عـلـى عـاتـقـه .قـد كـبـرت الـبـنـات ولـم يـعـد مـا يـحـصـل عـلـيـه مـن أجـرة هـزيـلـة كـافـيـا لإعـالـة أسـرتـه الـتـي بـدأت تـنـمـو بـشـكـل مـسـتـمـر فـي الـوقـت الـذي ظـل فـيـه راتـبـه كـمـا هـو ولـمـدة تـزيـد عـن عـشـر سـنـوات .لـقـد انـتـظـر تـرقـيـتـه كـمـوظـف بـسـيـط بـالـبـريـد ، لـكـن دون جـدوى فـي حـيـن حـصـل عـلـى الـتـرقـيـة شـبـان لـحـقـوا بـالـوظـيـفـة بـعـده بـسـنـوات عـدة ودون أن يـعـلـم لـذلك سـبـبـا . ومـع تـوالـي الـضـغـوط الـمـاديـة عـلـى كـاهـلـه بـدأت زيـاراتـه لـمـكـتـب رئـيـسـه تـتـوالـى مـتـسـائـلا مـسـتـفـسـرا عـن مـصـيـر وضـعـيـتـه ، كـيـف يـتـسـلـق مـوظـفـون أصـغـر مـنـه سـنـا وأقـل خـبـرة وتـجـربـة بـل وكـفـاءة ، الـسـلالـم والـدرجـات ويـبـقـى هـو قـابـعـا فـي نـفـس الـمـكـان كـأنـمـا كـتـب عـلـيـه أن يـبـقـى بـلا حـراك عـلـى خـلاف نـظـام الـكـون والـحـيـاة . كـانـت وسـيـلـتـه الـوحـيـدة هـي الـشـكـوى وكـتـابـة رسـائـل الاسـتـفـسـار دون أن يـمـلك أن يـتـخـلـى عـن مـبـادئـه كـمـا فـعـل ويـفـعـل الـكـثـيـرون مـمـن يـعـرفـون الـمـسـالك والـطـرق والـمـمـرات الـجـانـبـيـة لـتـحـقـيـق مـا يـريـدون دون أن يـكـلـفـهـم ذلك جـهـدا ولا مـشـقـة . كل مـا فـي الأمـر أن يـرسـلـوا عـلـبـا أو أكـيـاسـا إلـى رؤسـائــهـم لـيـحـظـوا بـعـدهـا بـالـتـرقـيـات والـرخـص وشـتـى الامـتـيـازات ، بـيـنـمـا ظـل صـاحـبـنـا لـسـنـوات طـويـلـة يـعـمـل بـجـد واجـتـهـاد ، وبـكـل مـا أوتـي مـن قـوة وصـبـر لـدرجـة أنـه كـان يـعـلـم كـل صـغـيـرة وكـبـيـرة فـي الـمـكـتـب الـبـريـدي ، إلا أنـه لـم يـكـن يـعـلـم تـحـديـدا أيـن يـسـكـن رئـيـسـه ولا مـا يـفـضـلـه هـذا الـرئـيـس بـل ولا حـتـى تـاريـخ مـولـده .
بـعـد أن ضاقـت الـسـبـل بـعـلـي واشـتـدت أزمـتـه الـمـالـية جـراء زيـادة نـفـقـاتـه بـدأ يـحـس بـثـقـل الـمـسـؤولـيـة الـمـلـقـاة عـلـى عـاتـقـه .قـد كـبـرت الـبـنـات ولـم يـعـد مـا يـحـصـل عـلـيـه مـن أجـرة هـزيـلـة كـافـيـا لإعـالـة أسـرتـه الـتـي بـدأت تـنـمـو بـشـكـل مـسـتـمـر فـي الـوقـت الـذي ظـل فـيـه راتـبـه كـمـا هـو ولـمـدة تـزيـد عـن عـشـر سـنـوات .لـقـد انـتـظـر تـرقـيـتـه كـمـوظـف بـسـيـط بـالـبـريـد ، لـكـن دون جـدوى فـي حـيـن حـصـل عـلـى الـتـرقـيـة شـبـان لـحـقـوا بـالـوظـيـفـة بـعـده بـسـنـوات عـدة ودون أن يـعـلـم لـذلك سـبـبـا . ومـع تـوالـي الـضـغـوط الـمـاديـة عـلـى كـاهـلـه بـدأت زيـاراتـه لـمـكـتـب رئـيـسـه تـتـوالـى مـتـسـائـلا مـسـتـفـسـرا عـن مـصـيـر وضـعـيـتـه ، كـيـف يـتـسـلـق مـوظـفـون أصـغـر مـنـه سـنـا وأقـل خـبـرة وتـجـربـة بـل وكـفـاءة ، الـسـلالـم والـدرجـات ويـبـقـى هـو قـابـعـا فـي نـفـس الـمـكـان كـأنـمـا كـتـب عـلـيـه أن يـبـقـى بـلا حـراك عـلـى خـلاف نـظـام الـكـون والـحـيـاة . كـانـت وسـيـلـتـه الـوحـيـدة هـي الـشـكـوى وكـتـابـة رسـائـل الاسـتـفـسـار دون أن يـمـلك أن يـتـخـلـى عـن مـبـادئـه كـمـا فـعـل ويـفـعـل الـكـثـيـرون مـمـن يـعـرفـون الـمـسـالك والـطـرق والـمـمـرات الـجـانـبـيـة لـتـحـقـيـق مـا يـريـدون دون أن يـكـلـفـهـم ذلك جـهـدا ولا مـشـقـة . كل مـا فـي الأمـر أن يـرسـلـوا عـلـبـا أو أكـيـاسـا إلـى رؤسـائــهـم لـيـحـظـوا بـعـدهـا بـالـتـرقـيـات والـرخـص وشـتـى الامـتـيـازات ، بـيـنـمـا ظـل صـاحـبـنـا لـسـنـوات طـويـلـة يـعـمـل بـجـد واجـتـهـاد ، وبـكـل مـا أوتـي مـن قـوة وصـبـر لـدرجـة أنـه كـان يـعـلـم كـل صـغـيـرة وكـبـيـرة فـي الـمـكـتـب الـبـريـدي ، إلا أنـه لـم يـكـن يـعـلـم تـحـديـدا أيـن يـسـكـن رئـيـسـه ولا مـا يـفـضـلـه هـذا الـرئـيـس بـل ولا حـتـى تـاريـخ مـولـده .








