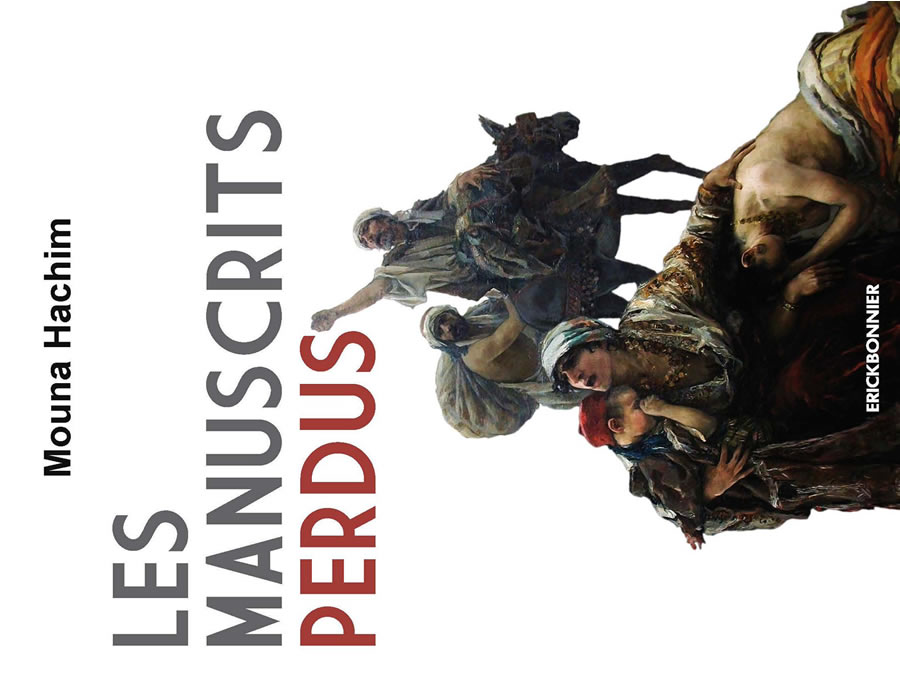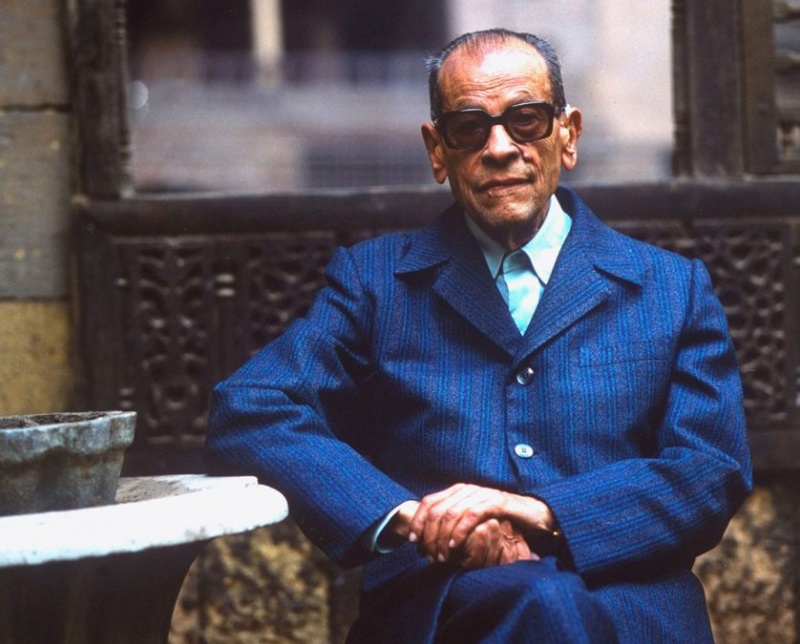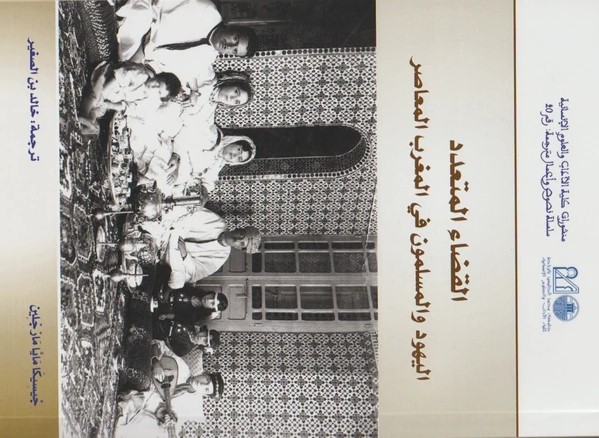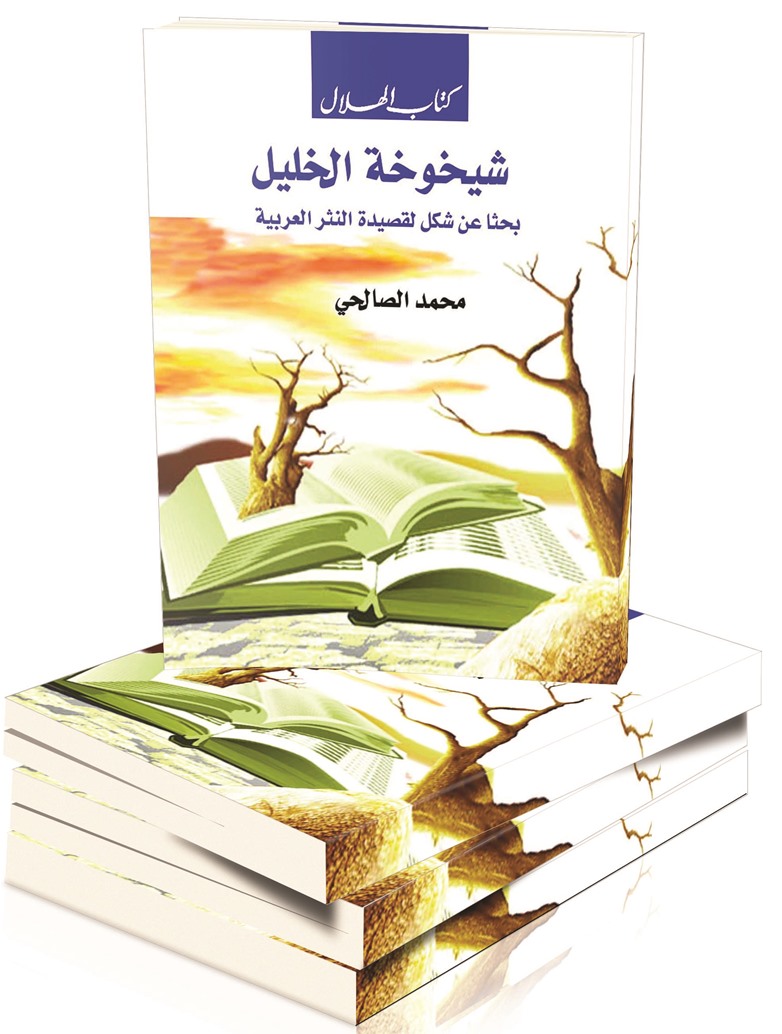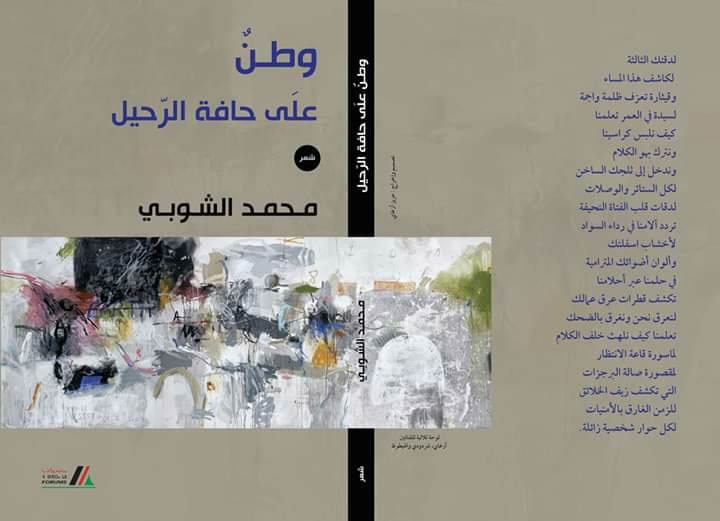نحاول في هذه المقالة القصيرة النبش في الرواية العربية النسائية، ونتساءل عن أقدم نص روائي نسائي؟ ونسعى إلى ترتيب الدول العربية بحسب ظهور أول نص بكل قطر عربي نسأل الله التوفيق:
- في المرتبة الأولى: لبنان وكانت أول رواية هي نص (حسن العواقب (لزينب فواز) صدرت سنة 1899، وقبل دول عربية أصدر للبيبة هاشم أيضا رواية (قلب الرجل) سنة 1904. وهما روائيتان اشتهرتا قبل رواية ظهور رواية (زينب) لأحمد حسنين هيكل التي يحلو للبعض اعتبارها أول رواية عربية...
- المرتبة الثانية كانت ثلاثية بين كل من سوريا ومصر والعراق : إذ صدر في سوريا سنة 1950 نص (يوميات هالة) للروائية سلمى الحفار الكزبري ، وصدر في نفس السنة نص (أروى بنت الخطوب) لوداد سكاكسيني وهي فلسطينية الأصل، عاشت بين سوريا ومصر ) وبالعراق صدرت رواية (ليلة الحياة) لحورية هاشم، ولم تنته الخمسينيات حتى كانت الرواية قد استقطبت ما زيد على خمس روئيات بسوريا. وبالعراق صدرت روايات نسائية منها (بريد القدر) 1951 ورواية (من الجاني) لحربية محمد سنة 1954، ورواية ن(ادية) لليلى عبد القدر سنة 1957.