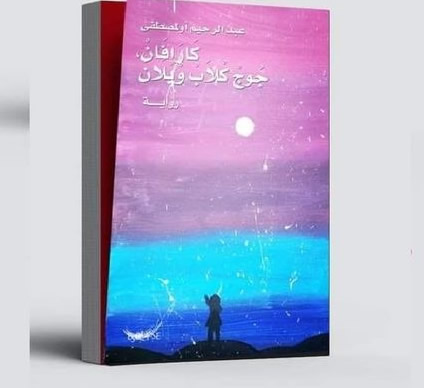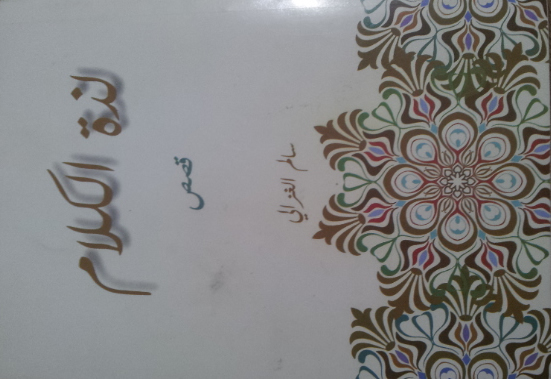كقبضة يد، يشتغل العداد وفق رنات ثمانية، يعد الشذرات الواحدة تلو الأخرى، وأنا أجهد رئة الشوق كمن يطارد قطعان حملان وديعة، أنتشي بقفزاتها باحثا عني بين ثنايا السطور:
كمن يتأمل خطوط يده- الغياب وكف الزمن- يد على خد- قبضة من حديد- اليد القصيرة- يد النجدة- كلمات وكتب- الحب يد تربت على قلب- حفنة فرح.
وإذ تطالعك أولى العتبات، تتساءل عما يمكن أن تقبض عليه، وأنت تمسك الديوان، فتحتار بين العنوان، كقبضة يد، وبين لوحة الغلاف التي تقول: هذي يدي ممدودة، للفنانة خديجة الفحلي... وبين القبض والسدل، سرعان ما تتبخر حيرتك وأنت تقرأ صفحة الغلاف الخلفية، وتعي أن البداية من حيث انتهى الديوان بشذرة تلخص كل شيء، تعبر عن حياة لا تستقيم إلا بصراع الأضداد:
عن رواية "كارافان، جوج كلاب، وبلان" للروائي المغربي عبد الرحيم أولمصطفى - المصطفى السهلي
صدرت للمسرحي والروائي المغربي المقيم في ألمانيا الأستاذ عبد الرحيم أولمصطفى رواية باللغة الدارجة المغربية، عنوانها: "كارافان، جوج كلاب، وبلان"، في أكتوبر 2020، عن منشورات إيسكيس ( ESQUISSE ) من القطع الصغير. وصمّمت لوحة الغلاف سلمى أولمصطفى. وهي رواية في مائة وتسعين صفحة.
أصل الحكاية:
حين تولَد الحكاية من رَحِم الصورة، ويَشتغل المِخيالُ على ملامحها وتفاصيلها، تَنبَثِقُ منها الحركة، وتتناسلُ في رحابها الأحداث، وتتزاحمُ في حضرتها الشخوص، فتتقمّصُ الشخصيةُ الرئيسةُ تلك الملامحَ، وتتسلّلُ إليها الحياة، عبر شرايين الحكي، وأوردة السرد، وأوعِيَة الحروف والكلمات المنتقاة بدقة وعناية... هكذا خرجَتْ إلينا شخصيةُ "فاتي" ( أو فتيحة ) من إحدى الصور، عبر تقنيةٍ تُسمّى "حكاية لوجه واحد" ( Story for one face )، فتَمثلتْ لنا بَشرًا سَوِِيّا، يُواجِه ظروفَ الحياة القاسية، بإرادةِ المتحدي، وعَزم القوي، والتزام المناضل، وصبر المُجابِه العَنيد، وصمود المتشبث بالحياة...
معرفة النص الأدبي - ذ. رشيد سكري
كثيرة هي الكتب ، في الساحة الثقافية ، التي تهتم بالنقد العربي ، وقليل منها ما يبقى راسخا في الأذهان . فعندما تبحث عن الأسباب ، التي تبوئ هذه المراجع المكانة المتميزة والراقية في خريطة النقد العربي ، تجد السدى المتين الذي يشد بناءها المعرفي المتماسك ؛ مقاوما بذلك عوادي الزمن ، وتقلباته المعرفية والثقافية . فعلى المستوى المنهجي ، إنصات كلي إلى المناهج الحديثة ، وما جادت به من نظريات تخدم تلقي النص الأدبي ، منفتحة تارة على ثقافة الآخر ، وعلى ما يدور في فلكه من نصوص نقدية تارة أخرى . أما على مستوى الفكري ، فانتظام الأفكار فيها وتسلسلها يخلق عالما من التأمل و التحليل ، ويكبد القارئ مشقة إعمال العقل بقوة ؛ لاستبانة إشكالاتها المعرفية والثقافية والتاريخية ، وتدفعه ـ أي القارئ ـ نحو أخذ مسافة الأمان بينه وبين النص الأدبي ، مبرزا موقفه تجاه ما يعج بها من نظريات وأفكار ومعارفَ . أما على المستوى اللغوي ، فتصيد المعجم المناسب ميسم دأبت عليه هذا النوع من النصوص المتميزة ؛ بهدف تفكيك واستجلاء الغامض والمبهم من المفاهيم والقوانين الثاوية فيها . تلكم أهم توصيفات كتب الكاتبة اللبنانية حكمت صباغ الخطيب المعروفة ب : يمنى العيد .
بين التجريب وتبئير المشروع في روايات شعيب حليفي من "زمن الشاوية" حتى "لا تنس ما تقول" - الكبير الداديسي
بقدر سعادتنا بمثل هذه الملتقيات التي نجدد فيها الوصل بأصدقاء نعزهم ونحمل لهم في قلوبنا من الود ما لا تتسع له الصدور... نشعر ببعض الغبن عندما يطب منا الإيجاز في ما يستوجب الإطناب، ويفرض علينا تقديم أكلة سريعة خفيفة لضيوف استأنسوا المأدبات الثقافية الدسمة، لذلك نعتذر منذ البداية عن أي تقصير في تقديم قراءة سريعة حول مشروع ثقافي متكامل لمفكر مثقف نقابي كاتب يجمع بين الإبداع والنقد... ولج شعيب حليفي عالم الكتابة الروائية مطلع تسعينيات القرن الماضي بمساء الشوق 1992 لتتوالى تدفقه السردي عبر: زمن الشاوية 1994، وروايات أنا أيضا: تخمينات مهملة"، و"رائحة الجنة"، و"لا أحد يستطيع القفز فوق ظله" "مجازفات البزنطي" "أسفار لا تخشى الخيال" "تراب الوتد" "سطات" و "لا تنس ما تقول" ليكون من القلة القليلة في الرواية المغربية الذين استطاعوا خلق تراكم روائي يستحق أن يكون موضوع دراسة ، ويفرض أسئلة عن الثوابت والمتغيرات في مشروع شعيب حليفي؟ الموضوع الروائي؟ اللغة الروائية عند حليفي؟ الوعي والشخصيات؟ البناء الزمني؟ البناء الروائي؟ أساليب الحكي؟ الغاية من تورط حليفي في الكتابة الروائية؟ وخصوصيات الكتابة الروائية عند حليفي؟
ستيفن ديرالوس بصيغة مغربية - ذ.رشيد سكري
يعد محمد زفزاف واحدا من أساطين الأدب المغربي ، وأنا في ميـْعة الصبا ، قرأت مجموعته القصصية " العربة " ، التي كانت أيقونة ، بكل المقاييس ، تصور تصويرا فوتوغرافيا الواقع المغربي . في الحقيقة ، كان اندهاشي كبيرا عندما أحسست أن للأدب طاقة خلاقة يكتشف بها هذا العالم هذه الحياة ، بل إن الانبهار كان على أشده و سيد الموقف ، عندما أصبح الأدب قادرا على أن يفعل الكثير ، كما قال الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا .
صهيل محمد زفزاف جاء من أدغال نهر سبو، حيث عانق الفقر ، واحتضنه كما يحتضن جائع رغيف خبز حاف . انتظم إبداع زفزاف في السرد والشعر . في المرحلة الثانوية كانت أولى قصائده تتفتح على رحيق الصبا ، حيث تنبأ له أستاذه الدكتور ابراهيم السولامي بفجر واعد في الأدب . كانت الانطلاقة الحقيقية من وراء المجاميع القصصية ، التي أصبحت سراج هذا الثعلب الذي يظهر ويختفي . فضلا عن ذلك ، فانطلاقا من مجموعته القصصية " حوار في ليل متأخر " إلى الأعمال الكاملة القصصية والروائية ،التي تحسب لوزارة الثقافة المغربية ، جاءت الشهرة إلى محمد زفزاف تغني ليل الصابرين . فبقدر ما تزداد أسهمه في بورصة قيم ورواسخ الإبداع ، بقدر ما يزداد ترسخا وتعلقا بأصلاب مهمشين ومنبوذين وتعساء في المجتمع . لم يكتف ، محمد زفزاف ، بإخراج أصواتهم المبحوحة إلى العلن ، وإنما صورهم كما فعل ، بأبطالهم ، الكتاب العالميين من أمثال إرنست إمنغواي و أنطوان تشيخوف وغي موبسان .
نعي إبراهيم الحجري وقراءة في إحدى رواياته - ذ.الكبير الدايسي
كالصاعقة نزل على المثقفين خبر رحيل الروائي والناقد إبراهيم الحجري في عز عطائه بعد غيبوبة مفاجئة لم يفك الطب شفرتها، وكالزلزال أصاب عائلته الصغيرة زوجته وابناؤه، وصبرا جميلا لوالدته التي فقدت قبل فترة قصيرة من أخاه، وعزاؤنا أن الكاتب لا يموت، فقد خلف إبراهيم خلفه ثراثا أدبيا هاما منه :
1- "أبواب موصدة" مجموعة سردية، دار القرويين، البيضاء 2000.
2- "أسارير الوجع العشيق"، منشورات وزارة الثقافة، الكتاب الأول، 2006م.
3- آفاق التجريب في القصيدة المغربية الجديدة، منشورات وزارة الثقافة، سسلسلة أبحاث، 2006م.
4- "استثناء" قصص، منشورات مقاربات، 2009م.
5- النص السردي الأندلسي: نقد، منشورات المجلة العربية، المملكة العربية السعودية، 2010م.
6- رواية صابون تازة، دار رواية، القاهرة، مصر العربية، الطبعة الأولى 2011م
7- المفهومية في التشكيل العربي: نماذج ورؤى، منشورات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 2012م.
مظاهر المفارقة وتجلياتها في مجموعة " ميكايلا" - عبد النبي بزاز
" ميكايلا " هي المجموعة القصصية السابعة للقاص المغربي لحسن حمامة وهي قصص تغني (ريبرطاوره) السردي بما تتضمنه من تيمات تمتح من مصادر متعددة ، ومرجعيات متنوعة مما يضفي عليها طابع عمق إبداعي يزخر بزخم جمالي ودلالي تغدو معه النصوص أكثر انفتاحا ورحابة وإيحاء.
فقد عمد الكاتب للكشف عن ( طابوهات) ظلت حبيسة الحجز والكتمان في نص " ميكايلا " بالخصوص وهي الطالبة الكندية التي دشنت فصول علاقة مع الطالب المغربي عبد السلام انطلقت من إعجاب داخل عربة المترو : " فقد بدأت في الحقيقة علاقتي بك في عربة المترو ... منذ ذلك الوقت وأنا أشعر نحوك بميل خاص وبعلاقة عاطفية تنسج معك " ص 86 لتتطور عبر مكاشفة نتأت أولى خيوطها لنسج شبكة تباين اجتماعي تجسد في وضعية أسرة ميكايلا : " أبي رجل أعمال كبير بكندا " ص 84 ، ووضعية أسرة عبد السلام : " أما عن وضعية أسرتي فهي أسرة متواضعة . صراع أبي الحقيقي مع لقمة الخبز . أمي تعمل في البيت " ص 86، تتشكل معه معالم مفارقة تتعدد تجلياتها ، وتتحدد تمظهراتها ليطال بنية المجتمع الاقتصادية : " هذا الميناء يعتبر من أهم الموانئ الكبرى في العالم يوفر لاقتصاد البلاد المال وفرص العمل" ص 92 على مستوى تنمية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، عكس بلده الذي تخترمه نواقص واختلالات : " مشكلتنا الرئيسية هي في كيفية تكوين وتأهيل الإنسان.
لذة القراءة في "لذة الكلام" - المصطفى السهلي
1 - في البدء كان العنوان:
حين شبّه جاك دريدا العنوان بالثريا(2) اختصر كل الإضاءات التي يمنحها للنص. إنها تتدلّى فوقه، فتضيء عتماته، وتكشف أسراره الخفية، وتنير زواياه القاتمة. وبما أن العنوان أول تواصل بين الكاتب والمتلقي، فإنه يأتي في شكلِ أكبر تكثيف ممكن لمعاني النص، وأعلى اقتصاد لغوي يمكن أن يُختزَل إليه المتن الذي تحته. إنه كالمنارة التي تَهدي القارئ، حين يَلفت نظره، ويسترعي انتباهه، قبل اسم الكاتب نفسه، في كثير من الأحيان. وهو بذلك يشكل مكونا رئيسا من مكونات "النص الموازي"(3) كما سماه جيرار جينيت. ولا شك أن الكاتب يحمِّل العنوان من الدلالات، ما قد يَفيض عن النص، ويجعله حمّال أوجه في القراءة والتأويل، سيما حين يضع مسافة بين المتن وعنوانه، تستلزم من القارئ عُدّة من آليات التحليل، وأدوات التفسير والتأويل.