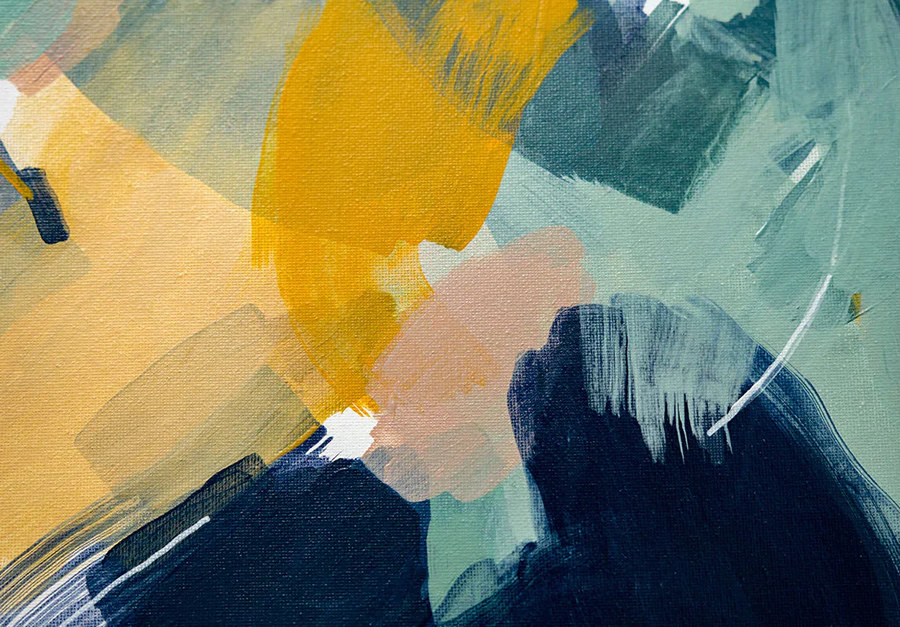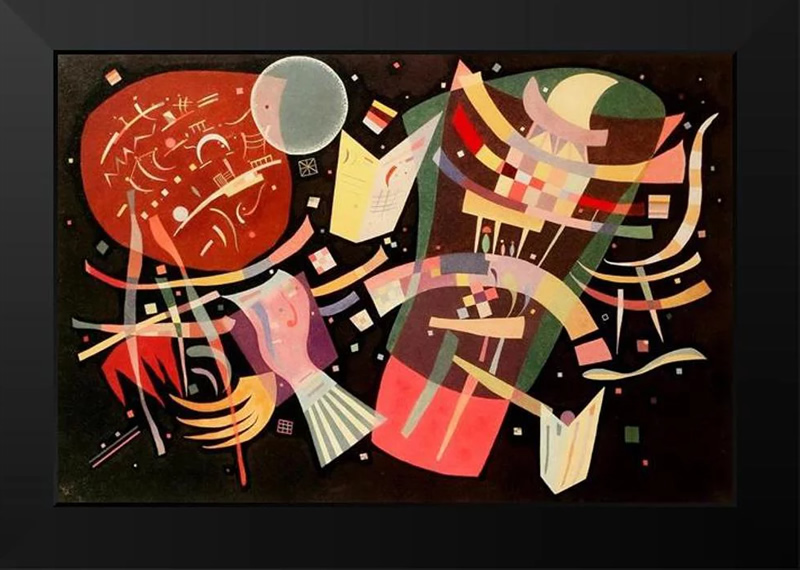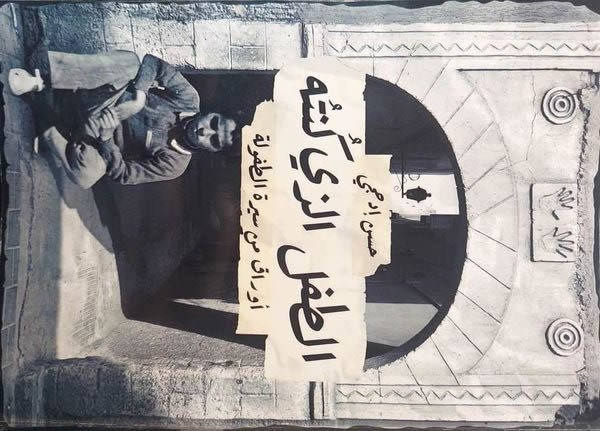يبدو أن التفكير في الأدب لا ينفصل عن الممارسة الأدبية نفسها، على الأقل حين تمر هذه الممارسة عبر الكتابة: إضافة إلى الثقافة الغربية، فإن كل الحضارات التي عرفت الكتابة، سواء أتعلق الأمر بالهند، أم الصين، أم اليابان، أم بالفضاء الثقافي الشاسع للأمة الإسلامية، قد أنتجت ثقافة محلية حول الإنتاجات الأدبية. صحيح أن طريقة التفكير التي طورها الغرب قد بدأت نتزع إلى استئصال أنماط التفكير المحلية، منذ القرن التاسع عشر، بموازاة مع التوسع السياسي والاقتصادي للحضارة الغربية: ولكن من المهم أيضا أن نؤكد على أن الحضارة الغربية لا تنفرد بالتفكير في اللغة، كما أن المفاهيم الوصفية والمنهجية المؤسسة لتقاليدها النقدية لا تشكل النمط الوحيد الوجيه للتفكير في الأدب.
ليس مجالنا هنا أن نقدم عرضا لتاريخ التفكير في الأدب عند الغربيين، والذي لم يتوقف عن مواكبة التطور الأدبي بأشكاله المختلفة ، منذ أرسطو وحتى خلال العصر الوسيط (خلافا للرأي الشائع)، (انظر كلوبش، 1980، هوغ ، 1985). سنقتصر هنا على التذكير ببعض الوقائع العامة التي يمكن أن تساعد على فهم أحسن للوضع الراهن.
النموذج الكلاسيكي
منذ العصور القديمة حتى نهاية القرن الثامن عشر عموما، مورس التفكير في الأدب أساسا وفق ثلاثة محاور، مع اختلاف في التأكيد على هذا العنصر أو ذاك باختلاف العصور:
1) الشعرية: والمقصود بذلك دراسة الوقائع الأدبية من زاوية الفن اللفظي. إن التفكير في فن الشعر الذي أسسه أرسطو كشكل خاص للدراسة، قد ظل حاضرا عبر العصور، رغم أنه سيفقد بسرعة استقلاليته التي منحها له صاحب كتاب فن الشعر، وسوف يتم احتواؤه من طرف البلاغة. واقتضى الحال أن ننتظر عصر النهضة، وإعادة اكتشاف نص أرسطو لكي تستعيد الشعرية استقلاليتها.
2) البلاغة: وتعني تحليل الخطابات ، وخاصة مجموع الوسائل المستخدمة لضمان التواصل الجيد. إنها مهارة تقنية مرتبطة بالحياة العمومية أولا ( يجب أن يتعلم المرء الوسائل اللسانية المناسبة للاستخدام من أجل تحقيق الهدف المقصود)، ومع ذلك فإنها تحمل في طياتها منذ البداية مكونا تحليليا ما دام اكتساب فن الخطابة يمر عبر دراسة النماذج الخطابية الجيدة. ولأسباب تاريخية ( ومنها على الخصوص تراجع الديمقراطية في العصور القديمة)، فإن النصوص الأدبية بحصر المعنى ( الأعمال التخييلية والشعر) ستحظى بمكانة متزايدة الأهمية على مستوى النماذج الخطابية التي تشكل موضوعا للنقاش. وفي نفس الوقت، فإن الخطاب الأدبي سيحتل مكانة مركزية بين الأجناس الخطابية المدروسة. وسوف يستمر هذا التطور خلال العصر المسيحي ليؤدي إلى إفقار حثيت وعنيف للبلاغة التي سيتم اختزالها تدريجيا لتقتصر على مشاكل البيان.
3) الهرمنوطيقا: والمقصود بها نظرية التأويل. ورغم اقتصارها في الأصل على النصوص المقدسة، فإنها تناولت أيضا منذ العصر الإسكندري المشكل الفقهي اللغوي المتعلق بتأسيس النصوص الآدبية الدنيوية. أضف إلى ذلك أن النصوص المقدسة في التقليد اليهودي والمسيحي تحمل مجموعة من القواسم البنيوية مع النصوص الدنيوية الترفيهية (نصوص سردية وشعرية): فبعض المشاكل الخاصة التي تتناولها هرمنوطيقا النصوص المقدسة تتدخل أيضا في فهم النصوص الأدبية بحصر المعنى، خاصة قضية الرمز والحكاية المجازية. وفي النهاية عوض النقد الفيلولوجي ابتداء من عصر النهضة بشكل متزايد هرمينوطيقا النصوص المقدسة، رغم اقتصارها في البداية على الأعمال المنتمية للعصور القديمة.
في دراسة كلاسيكية حول تقاليد النقد الغربي، ميز أبرامس ( 1953) بين أربعة ، وليس ثلاثة ، توجهات نقدية. حسب ما إذا كان الناقد يركز على الفنان المبدع، على العمل الإبداعي، على الواقع كما يعبر عنه هذا العمل أو كما يفهمه الجمهور المقصود بهذا العمل. لقد ميز أبرامس بين : النظريات التعبيرية، التي تحدد العمل الأدبي كتعبير عن ذاتية فنية؛ النظريات الموضوعية التي تحصر العمل الأدبي في بنيته النصية المحايثة؛ النظريات المحاكاتية التي تحدد هذا العمل في علاقته بالواقع الذي يمثله؛ وأخيرا النظريات التداولية التي تحلل العمل الأدبي من زاوية آثاره على المتلقي. تنتمي الشعرية طبعا للنظريات الموضوعية، وتنتمي البلاغة للنظريات التداولية. هذا صحيح على الأقل إذا التزمنا بالحدود الكلاسيكية لهذين المجالين المعرفيين، رغم أن هذه التحديدات قد تبدو إشكالية نظرا لصعوبة الفصل بين العوامل التركيبية والتداولية ضمن تحليل الخطاب. أما النظريات المحاكاتية فإنها تنتسب للقطب الهرمينوطيقي، إذا نظرنا إليها كنموذج مميز للتحليل الدلالي ( وهو عمليا تحليل من زاوية العناصر المرجعية). أما النظريات التعبيرية فلم تتطور بشكل فعال إلا مع العصر الرومانسي.