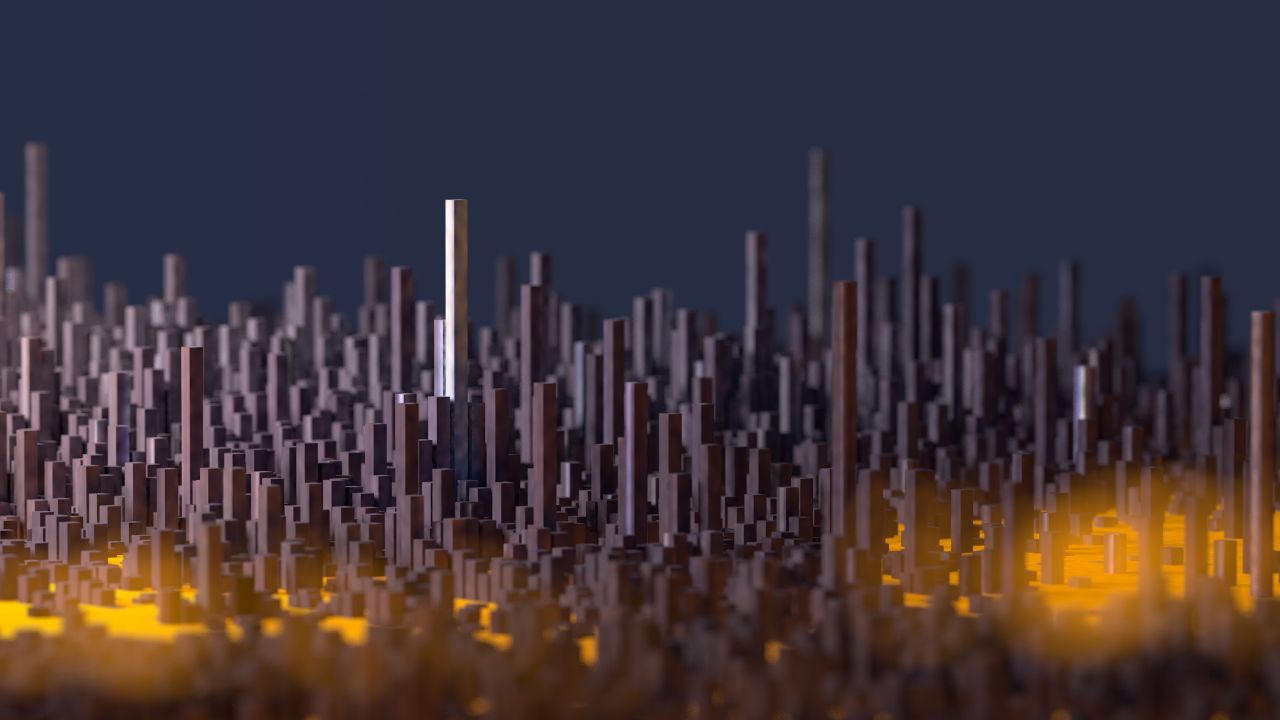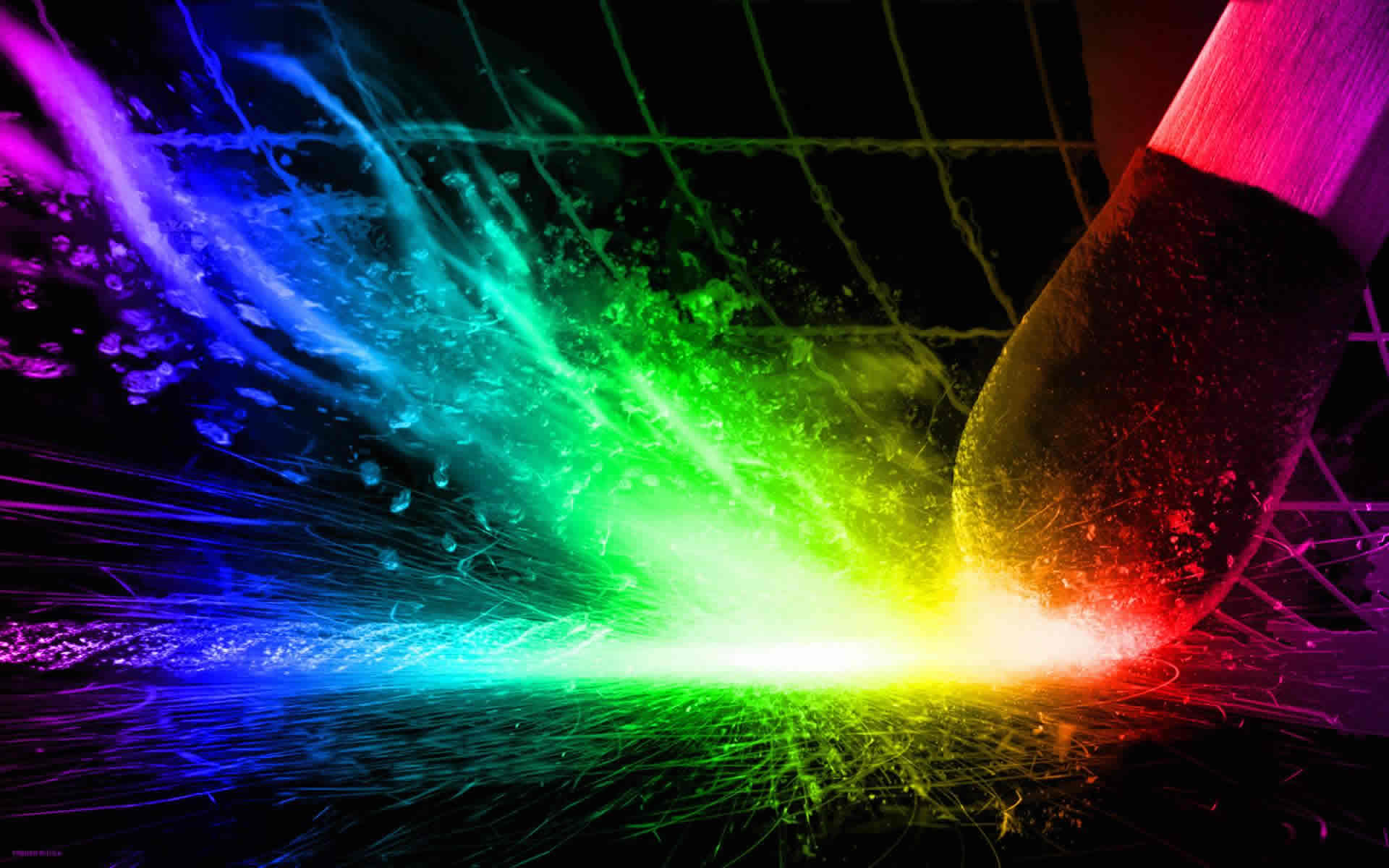تشهد بلادنا منذ سنوات حركات احتجاجية تناولتها السوسيولوجيا المغربية كظاهرة اجتماعية من خلال مجموعة من الأسئلة مثل: كيف تعبر الحركات الاحتجاجية عن ذاتها في المجتمع المغربي؟ وكيف تشتغل في ظل نسق مفتوح على الأزمة والاختلال؟ وكيف تتعامل مع معطيات النسق وردود مالكي الإنتاج والإكراه فيه؟ وكيف تدبر خطاب وممارسة الانتقال من الاحتجاج العرضي إلى الحركة الاجتماعية القوية والفاعلة في مسارات صناعة التغيير؟ وما الثابت والمتحول في صلب هذه الدينامية؟ غير أن هذا التناول يبقى ناقصا من الناحية النظرية على الأقل بحكم تغييبه للأسئلة المنصبة على علاقة هذه الحركات الاجتماعية بالأحزاب السياسية. من أجل المساهمة في ملء هذه الثغرة، أقترح هذه الترجمة العربية للمقدمة التي أفردها فردريك ساويكي لكتاب جماعي حول نفس الموضوع تم تأليفه تحت اشرافه .
الطريقة التي تم بها عموما التفكير في الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية داخل مجال العلوم الاجتماعية وعلاقاتها مؤشر ممتاز على آثار الجهل الناجم عن تجاوزات تقسيم العمل العلمي.وقد كتب ستيفاني ديشيزيلس وسيمون لوك في تقديمهما لهذا البحث؛ أن "المتخصصين" في الحركات الاجتماعية وأولئك المهتمين بالأحزاب، ولكن أيضا المهتمين بنقابات العمال والمجال الجمعوي، طوروا مع مرور الوقت اشكالياتهم وأدوات التحليل الخاصة بهم عن طريق التقليل شيئا فشيئا من مواجهتهم جميعا، لمغبة الافراط في استقلالية مواضيعهم البحثية.
جيزيل سابيرو ترصد العلاقة بين الأدب والايديولوجيا من منظور سوسيولوجي ـ أحمد رباص
من أجل ربح الرهان الذي يقتضيه عنوان هذه القراءة،أقترح عرض ما جاء في مقالة جيزيل سابيرو التي عنوانها الأصلي :"من أجل مقاربة العلاقات بين الأدب والإديولوجيا"،والتي نشرتها في المجلة الإلكترونية"contextes".لكن، قبل الشروع في عرض مضمون هذه المقالة يجدر بي تقديم نبذة عن كاتبتها. فهي من مواليد 1965 بباريس، مؤرخة فرنسية متخصصة في الأدب الفرنسي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين .
تندرج اهتماماتها بالأدب في إطار مواصلة أبحاث بيير بورديو؛ السوسيولوجي الفرنسي الشهير. بعد إنجازها لعدة أبحاث حول إشكالية الالتزام لدى الكتاب الفرنسيين طيلة سنوات الحرب العالمية الثانية، ثم تحول اهتمامها إلى التداول العالمي للأفكار وما يخضع له من مؤثرات العولمة.أما الآن، فتشغل منصب مديرة أبحاث بالمركز الأوربي للسوسيولوجيا وتحاضر بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية. من كتبها الصادرة عن دار النشر"فايار"،هناك "معركة الكتاب،1940-1953" (1998) و"من أجل تاريخ للعلوم الاجتماعية" (2004) و"دفاعا عن بورديو"، بنفس التاريخ.
وسائل الإعلام: مأسسة وعولمة للتغليط - تفكيك مغالطات الميديا - إدريس هاني
1. في البدء: السياسات الإعلامية ودور المحلل السياسي
هنا بيروت، عاصمة الأنارشيا بنكهة عربية، تلك التي شكّلت فرصة تاريخية للكائن العربي تحديدا، أو لنقل الرئة التي لا يتنفس من خلالها اللبنانيون وحدهم بل هي الرئة التي يتنفس من خلالها الأحرار العرب وحتى غير الأحرار العرب، فهي جغرافيا التعبير عن الإرادات، ولهذا كانت الثقافة والإعلام والنشر لها هاهنا حكاية تفرّد، هنا في عاصمة الصناعة الإعلامية العربية كان اجتماعا حافلا بالأفكار ذلك الذي جمعنا قبل أيّام على مائدة النقاش حول العلاقة بين المحلل السياسي ووسائل الإعلام في إطار اجتماع الهيئة التأسيسية للرابطة الدّولية للخبراء والمحلّلين السياسيين قصد تحيين هذا الإطار ومناقشة القانون التأسيسي وميثاق الشّرف وخطّة عام 2017. النصف الأوّل من اليوم تضمن جلسات تتعلق بدور المحلل السياسي في صناعة الرأي العام وعلاقته أيضا بوسائل الإعلام ساهم فيها أصدقاء وزملاء من داخل مؤسسات الإعلام المتنوّعة ومحللين سياسيين من مشارب وخبرات مختلفة، هذا في حين انحصر اجتماع النصف الثاني من اليوم في مناقشة الوثائق المذكورة في إطار مغلق خاص بالهيئة الإدارية وهو ما كان يعالج تفاصيل البنود ولغة الوثيقة وبعض القضايا التفصيلية حيث انتهى إلى الكثير من التوافقات فضلا عن انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية من بينهم رئيسا للرابطة خلال الفترة القادمة.
سوسيولوجيا المثقّفين العرب في الغرب ـ د. عزالدين عناية
مرّت زهاء خمسة عقود على صدور النسخة الإنجليزية من مؤلف هشام شرابي "المثقفون العرب والغرب"، ولعله بات من المشروع، في الوقت الحالي، الحديث عن المثقفين العرب في الغرب، بعد أن شهدت الساحة تطورات مهمة في هذا السياق. إذ يشغل المنتوج الثقافي العربي القادم من الغرب، إبداعاً وتأليفاً وترجمةً، حيزا معتبرا ضمن خارطة الثقافة العربية الحديثة، عبر ما يسهم به بشكل فعّال في اجتراح مسارات مستجدة. وإن نال هذا المنتوج شيئا من الاهتمام، فإن المنتِج لم يحظ بالقدر الكافي من المتابعة. ومن هذا الباب نقدّر أن النخبة الفكرية العربية في الغرب تحتاج إلى معالجة رصينة ومتأنية، تُتابَع من خلالها أدوارها وتُتفحَّص على ضوئها هويتها، بعيدا عن أية وعود مبالغة أو أحكام مسقَطة. ومع أن الخاصية المشتركة بين عناصر تلك الشريحة الانتماء، في ما مضى، إلى بنية حضارية موحَّدة، فإن مقامها الدائم في مجتمعات غربية، قد عزّزها بعناصر مستجدة طفحت من خلال رؤاها ومواقفها.
قراءة في كتاب "مفهوم الحرية" لعبد الله العروي ـ ياسين عتنا
تمهيد
مما لا يختلف فيه البيان، أن مفهوم الحرية من ابلغ المفاهيم الإنسانية تداولا، سواء تعلق الأمر في اللسان الشعبي اليومي، أو في الحقل الفلسفي و العلمي. وعلى إثر هذه الأهمية البالغة، نخصص مقالنا هذا، لقراءة في فصول كتاب " مفهوم الحرية" للمفكر المغربي عبد الله العروى، الصادر عن دار النشر المركز الثقافي العربي، الطبعة الخامسة، 1993. لما يحوزه هذا الكتاب من أهمية معرفية في الساحة الفكرية المغربية و العربية على حد سواء. الأمر الذي فرض الوقوف عنده، ورصد تحليله للمفهوم السالف. وفق أربعة مستويات معرفية؛ أولها معنون بـ" طوبي الحرية في المجتمع الإسلامي التقليدي" حيث عالج فيه مسألة الحرية استنادا على المنظومة المعجمية العربية، و ركز على أربعة مصطلحات تضمن مفهوم الحرية، وهي كل من : البداوة، التصوف، العشيرة، التقوى. في حين جاء الفصل الثاني، الموسوم بـ " الدعوة إلى الحرية (عهد التنظيمات)" موضحا فية ما يصطلح عليه سياسات الإصلاح كامتداد لتوغل أنظمة الدولة و إقحام الفرد في تجربة السياسة، و ارتباط مفهوم الحرية بالدولة . أما الفصل الثالث : "الحرية اللبرالية "، تضمن تحديد معالم التفكير اللبرالي، و تبيان الأشواط التي خاضها ( أربع مراحل) ليلتقي بها المفكر العربي على شكل منظومة فكرية متناقضة. الفصل الرابع : " نظرية الحرية"، حاول فيه عبد الله العروي أن يجادل في كل من الفكر اللبرالي و الماركسي و الوجودي، و تصورهم الفلسفي لمفهوم الحرية، و علاقتهم بالوضع العربي من خلال تسليط الضوء على بعض المفكرين العرب. أما الفصل الخامس فخصص لـ" اجتماعيات الحرية"، موضحا فيه الإهمال الذي طال جسم العلوم الاجتماعية و بالأخص علم الاقتصاد و علم الاجتماع و علم السياسة، لكونها علوم تعبر عن مؤشرات التحرر.
العولمة : مظاهر الهيمنة والتغير المفاهيمي ـ محمدين جمال
يبدو أن لفظة العولمة تمثل مجالا دلاليا خصبا وغنيا، باعتبارها المحدد الوحيد للتجربة الإنسانية الحديثة، وبوصفها حركة لا تقف عند حد الهيمنة السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، التي فرضها العالم المتقدم على عالم الجنوب وعلى ضعاف العالم، بل تتجاوز ذلك إلى فرض النموذج الثقافي والقيمي الأمريكي في كل شيء. وتسخر لأجل ذلك سلطاتها في مستوي الاقتصاد، والعتاد التكنولوجي، والحضور القوي في الساحة السياسية الدولية.
وهكذا تكون مقاربة هذه الظاهرة من جانب واحد اقتصاديا كان أم سياسيا أم ثقافيا الخ، أمرا غير ممكن. وإن كان هناك من لا يعترف بوجود العولمة إلا في تمظهراتها الاقتصادية بالدرجة الأولى. فنحن في واقع الأمر أمام ما هو أكبر من ذلك، أمام مرحلة تاريخية جديدة، بسمات وملامح جديدة. مرحلة تصوغ واقع حياة الشعوب المستضعفة من جديد، وفق رؤية العالم الغربي المتقدم وأهدافه. مرحلة يمكن اعتبار أن أهم سمة مميزة لها هي التعقد البالغ في العلاقات، وانكماش المسافات بين المجتمعات، انكماشا لم يكن ممكنا في حضور حواجز الهوية والثقافة، كما كانت من ذي قبل. وتسارع في وتيرة السير في طريق الاندماج الكلي، الذي انخرطت فيه جميع الأمم والشعوب منذ ظهور الثورة التكنولوجية الحديثة، في أواخر القرن العشرين. التي أضحت سارية المفعول في خضم حركة العولمة هذه، بسهر وتأطير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كقوة وحيدة على عرش العالم.
السينما في دوامة السلطة ـ بوجمعة أكثيري
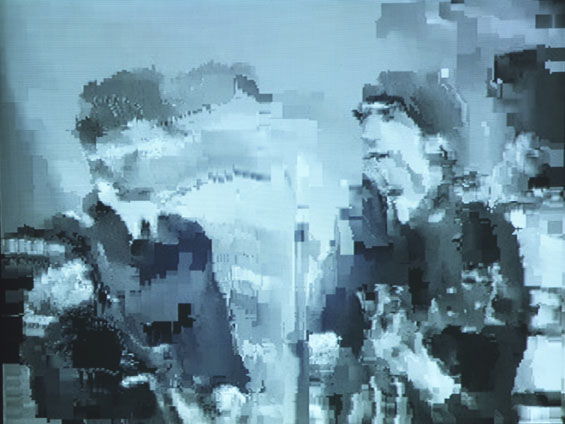 تعد تكنولوجية الصورة والإعلام، إحدى ركائز التفوق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي...في المجتمعات الحديثة، نظرًا لما لها من قدرة جبارة على الإقناع والتأثير والتوجيه، بل والتحكم في القيم وتغيير الأذواق والتمثلات والنظرة للأمور وللعالم؛ ما يفسر أن تكنولوجيا الصورة الحديثة بشتى تلاوينها السينما، التلفزة، الإنترنيت...إلخ، غدت سلطة فعالة في أيدي الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر على الصناعة الإعلامية. فما هي يا ترى تجليات هذه السلطة؟
تعد تكنولوجية الصورة والإعلام، إحدى ركائز التفوق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي...في المجتمعات الحديثة، نظرًا لما لها من قدرة جبارة على الإقناع والتأثير والتوجيه، بل والتحكم في القيم وتغيير الأذواق والتمثلات والنظرة للأمور وللعالم؛ ما يفسر أن تكنولوجيا الصورة الحديثة بشتى تلاوينها السينما، التلفزة، الإنترنيت...إلخ، غدت سلطة فعالة في أيدي الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر على الصناعة الإعلامية. فما هي يا ترى تجليات هذه السلطة؟
تستمد الصورة سلطانها مما نستثمره فيها من رغبات، وتقوم مقام رغباتنا في تحويل العالم، إن للصورة قوة تأثيرية تفوق كل التوقعات، سيما وأنها توظف مجموعة من التقنيات: السيناريو، الحوار، الإخراج، المونتاج، الإنارة، والماكياج، الإكسسوارات، المؤثرات الصوتية...إلخ، بغية بسط سلطانها على المشاهد؛ فرهان هذا الاختراع البصري هو التحكم في زمام الأمور، وتكريس سلطته على الفضاء العام والخاص، من خلال:
قراءة في كتاب الفلاح المغربي المدافع عن العرش لصاحبه ريمي لوفو ـ عبدالرزاق القرقوري و المصطفى ابو العلا و صلاح الدين ليياتي
 مقدمة:
مقدمة:
إذا كانت الدرسات الكولونيالية والفرنسية بالخصوص قد ركزت بشكل كبير على دراسة مختلف الأوضاع الطبيعية والاجتماعية والإقتصادية للمغاربة قبل الإستقلال، تمهيدا لفرض السيطرة الإمبريالية عليه، فإن مضمون اهتمام الدراسات قد تغير بعد الإستقلال.
لقد أولت اهتماما متزايدا لتشخيص الأوضاع السياسية، والوقوف على التوجهات الجديدة التي يسير فيها المغرب وخاصة مغرب الحسن الثاني، وبذلك أطلت علينا مجموعة من الأطاريح السياسية والإجتماعية التي قدمت قراءات مختلفة للوضع المغربي.
من أهم هذه الدراسات، والتي لاقت انتشارا واسعا، نجد دراسة الباحث الفرنسي ريمي لوفو Rémy leveau تحت عنوان: " الفلاح المغربي المدافع عن العرش"، وهي دراسة فريدة إبان الفترة التي أصدرت فيها، وذلك من خلال توجهها الجديد والذي يمكن أن ندخله في سيسيولوجيا الانتخابات.
لقد قدم الباحث تشخيصا عميقا ودقيقا للوضع السياسي المغربي، من خلال تشخيص القوى السياسية الفاعلة في البلاد، وهي مؤسسة الملك والنخب السياسية، سواء منها القديمة التي ظهرت في فترات الإستعمار أو الجديدة والتي ساهمت مجموعة من الظروف في بروزها.
فما المقصور بالفلاح المدافع عن العرش؟ وما هي أبرز المضامين التي حملتها أطروحة الفلاح المغربي في ثناياها؟ وما هي أهم القضايا التي عبرت عنها؟
ما هي أهمية الدراسة المقدمة، باعتبارها توجه جديد في عالم الدراسات التي جعلت من المغرب حقلا معرفيا لها؟
كيف قدم الباحث تصوره عن الأوضاع السياسية المغربية والنخب المشاركة فيها ونوعية العلاقات التي تربط بينها؟