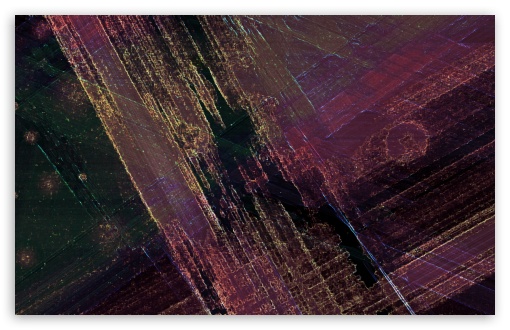 1-س- كيف كان مساركم،قبل مشاركتكم في تأسيس تنظيم ''إلى الأمام" ؟
1-س- كيف كان مساركم،قبل مشاركتكم في تأسيس تنظيم ''إلى الأمام" ؟
ج-وأنا في سن الخامسة عشر ،كنت عضوا في صفوف الحزب الشيوعي حقبة السرية.في مدينة مكناس، وبالضبط الثانوية المسماة اليوم مولاي إسماعيل،بادرت مع بعض تلاميذ الثانوية إلى إنشاء خلية للحزب.دأبت على العمل السري،حتى سن الثامنة عشر.سنة1960،في مدينة الدارالبيضاء بثانوية ليوطي المتواجدة وقتها بشارع 2مارس،أسسنا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية،وخلال السنة الموالية أي 1961،عشنا حدثا بارزا مميزا تمثل في تنظيم تظاهرة كبرى للاحتجاج على اغتيال باتريس لومومبا.خلال تلك الفترة،وقبل العولمة كثيرا،كان قويا الشعور، بالانتماء إلى حركة تحريرية عالمية كبرى،عند المناضلين والمواطنين من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ.سنة 1962،قصدت فرنسا من أجل الدراسة،بحيث اكتشفت هناك ممارسة نضالية أخرى، أكثر اتساعا وانفتاحا، فيما يتعلق بأسئلة المجتمع والحريات الفردية، ارتباطا بزخم النقاشات ضمن صفوف القوى التقدمية الفرنسية، حول الفرد والمجتمع والفضاءات الجمعية والديمقراطية.
الترجمة: الأدب والأدبية ـ أوكتابيو باث ـ ترجمة: إدريس المصمودي ومحمد القاضي
 فكل قراءة هي ترجمة وكل نقد هو بداية للترجمة، ولكن القراءة هي ترجمة داخل نفس اللغة، والنقد هو ترجمة حرة للقصيدة أو أكثر تدقيقا هو (عملية النقل) للناقد، فالقصيدة هي نقطة الانطلاق نحو نص آخر، نصه هو، بينما المترجم في لغة أخرى وبعلامات مخالفة، عليه أن ينظم قصيدة مشابهة للأصل.
فكل قراءة هي ترجمة وكل نقد هو بداية للترجمة، ولكن القراءة هي ترجمة داخل نفس اللغة، والنقد هو ترجمة حرة للقصيدة أو أكثر تدقيقا هو (عملية النقل) للناقد، فالقصيدة هي نقطة الانطلاق نحو نص آخر، نصه هو، بينما المترجم في لغة أخرى وبعلامات مخالفة، عليه أن ينظم قصيدة مشابهة للأصل.
إن تعلم الكلام يشبه الترجمة، فعندما يسأل الطفل أمه عن مدلول هذه الكلمة أو تلك، فهو في الحقيقة يطلب من أمه أن تترجم إلى لغته تلك الكلمة التي يجهلها، إن الترجمة ضمن لغة واحدة ليست ترجمة جوهرية، وعلى هذا الأساس فهي لا تختلف في هذا المعنى عن الترجمة بين لغتين، وتاريخ كل الشعوب يكرر التجربة الصبيانية، بل وحتى القبائل المعزولة عليها أن تواجه في وقت من الأوقات لغة شعب غريب عنها. إن الدهشة والغضب والرعب أو الحيرة المسلية التي نشعر بها أمام أصوات اللغة التي نجهلها، لا تلبث أن تتحول إلى شك حول اللغة التي نتحدثها، وعندئذ تفقد اللغة عالميتها وتنكشف لنا في تعددية اللغات، كلها غريبة وغامضة يصعب التعرف عليها كلها. في القديم كانت الترجمة تبدد هذا الارتياب ما دامت اللغة العالمية منعدمة، فاللغات جميعها تكون مجتمعا عالميا يصبح فيه الجميع بعد التغلب على بعض الصعوبات يتفاهمون ويستوعبون، ويدركون أن الناس يقولون دائما نفس الأشياء رغم تعدد اللغات. إن الجواب عن هذا الغموض والبلبلة هو عالمية المضمون.
ذاكرة أنفاس : حوار مع طوني ماريني ـ حاورتها:زكية الصفريوي ـ ترجمة : سعيد بوخليط
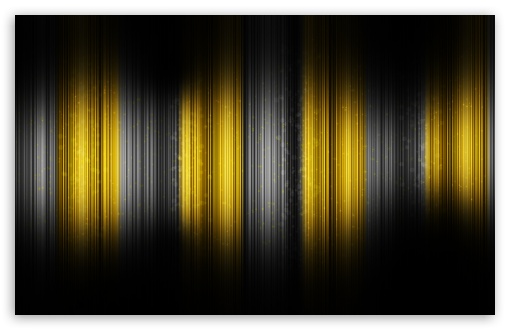 1-س- ماهي حيثيات نسجكم،لعلاقات مع مجموعة أنفاس ؟
1-س- ماهي حيثيات نسجكم،لعلاقات مع مجموعة أنفاس ؟
ج-بين سنتي 1964و1965،حينما قدمت من أجل تدريس تاريخ الفن بمدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء،في نفس لحظة الفنان التشكيلي محمد المليحي(الذي سيدرس التشكيل) ،بدعوة من الفنان فريد بلكاهية (الذي كان مديرا جديدا) ،ثم ارتبطنا بعلاقات مع الشاعر مصطفى النيسابوري.هكذا،شكّلنا ''فريقا صغيرا" من الأصدقاء،تقاسموا نفس الأفكار والرؤى والمشاريع،ويناضلون ثقافيا من أجل النهوض بالوضعية الفنية بالمغرب،المحكومة بثقل السياسة الثقافية الكولونيالية. على الفور،جذبت مبادرة تشكيليي مدرسة الفنون الجميلة(دروس جديدة،أبحاث ودراسات في المدرسة نفسها،ثم عروض جماعية في الفضاءات العمومية،وبيانات، إلخ)دعم وتعاطف فنانين وشعراء ومثقفين.قدم لنا النيسابوري الشاعر عبد اللطيف اللعبي، فجمعتنا مباشرة صداقة.في غضون ذلك، كان اللعبي،يفكر في إخراج مجلة أدبية بمعية خير الدين والنيسابوري.الأخير،سبق له أن أصدر سنة1963،عمله :مياه حية.ثم مع خير الدين،المجلة الصغيرة : القصيدة كليا.شهر يناير1966،بادر الفنانون التشكيليون بلكاهية وشبعة والمليحي- مع نص كتبته لهم على سبيل التقديم- إلى إقامة معرض بباب الرواح في الرباط.أيضا،خلال الفصل الأول،من سنة1966،شهد ميلاد مجلة أنفاس المدعومة من نفس فريق الفنانين التشكيليين،والذين أثثوا صفحات العدد الأول.الجسر الممتد بين التشكيليين والشعراء،من الدار البيضاء إلى الرباط، أطلق العنان لطاقات ومشاريع.بكلمات أخرى،التقيت النيسابوري واللعبي(صاحبا فكرة المجلة)قبل ظهور أنفاس(وقتئذ غادر خير الدين نحو فرنسا) ،فكرة تبلورت على أرض الواقع بفضل دعم تشكيليي الدار البيضاء.
ذاكرة أنفاس : حوار مع محمد المليحي(1) ـ حاورته:زكية الصفريوي ـ ترجمة : سعيد بوخليط
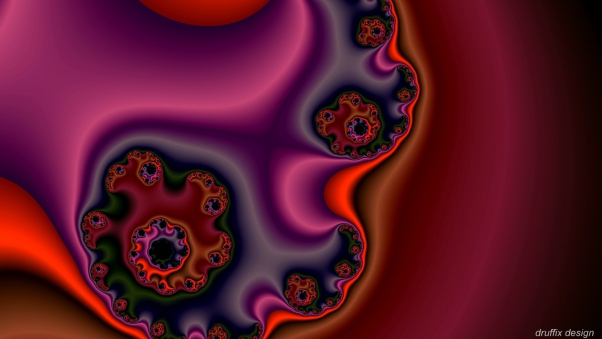 1-س- لقد تلقيتم تكوينا في المغرب وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.بماذا تحتفظون، من هذا الأمر؟
1-س- لقد تلقيتم تكوينا في المغرب وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.بماذا تحتفظون، من هذا الأمر؟
ج-هو مسار أكثر من كونه،تكوينا أكاديميا.حينما ذهبت إلى الأكاديمية،فقد كان ذلك بالنسبة إلي ربما، مجرد ذريعة :لم أكن أبحث حقا عن تكوين علمي.لكن، وأنا أتابع الدروس، أدركت سريعا أن هذا التكوين الفني، مصدره ثقافة وإيديولوجية محددة جدا :الثقافة الإغريقية- الرومانية.بينما، نحن ننتمي إلى ثقافة تتعارض معها بشكل ما.فوضعي،لا يسمح لي بقبول نظرية التمثيل هذه.ولكي أواصل انضوائي،ضمن التقليد الإسلامي،أبقيت على شكل للتعبير،يمكننا تسميته فيما بعد بالاختزالي : السطح،غياب الرؤية،وكذا تصور فضاء أو شكل فني يخلق نوعا من الوهم البصري.عنصران كانا،أيضا حاسمين بخصوص إشكاليتي المتعلقة بالرسم التصويري:الفن المعاصر،كما تمثله في أبّهة كبيرة المدرسة الأمريكية،أو مدرسة مابعد- باوهاوسBauhaus،ثم التقليد الإسلامي.مذهبان، يتلاقى فكرهما،دون أن يمثل أحدهما،شيئا آخر من الثاني.تحققات فنية،تقدم نفسها.هناك،أيضا عنصر نجده ثانية في الإسلام. لقد، ربط الفن المعاصر مع ثورة مدرسة باوهاوس(معهد فني تأسس في فيمارWeimar سنة 1919،حيث تبلورت حركة طليعية،تهم الهندسة والديزاين والصورة والرقص،ثم توقفت سنة 1933،تحث الضغط النازي،بدعوى شيوعية عناصر المجموعة) الفن بالمسكن،أي الهندسة بالإنسان،أكثر من أسطورة متخيلة.
مقابلة مع إدغار موران ـ : آنا سانشيز ـ ترجمة:د.ضياء الدين عثمان حاج أحمد
 " أجدني مندفعا و أنا أكتب كتابي الذي يشبه مخلصا جديدا، و الذي أسميته: (الطريق). فهو رسالة لإنقاذ البشرية من كارثة. "
" أجدني مندفعا و أنا أكتب كتابي الذي يشبه مخلصا جديدا، و الذي أسميته: (الطريق). فهو رسالة لإنقاذ البشرية من كارثة. "
توطئة:
لقد عجزت تماما عن مفارقة فكر إدغار موران.
التقيت به عام 1980 عندما بدأت ترجمة كتابه: (النهج) أثناء دراستي لإكمال أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة ( و التي تتعلق بالارتباط بين فكر موران المراكباتي و النظرية النسوية).
دعاني السيد موران إلى منزله، حيث تحدثنا عن أعماله، ثم على الفور دعاني لتناول العشاء في الليلة نفسها.
أذكر أن مكان العشاء كان هو نفس المكان الذي التقيت فيه بالراحل خوسيه فيدال بينيتو، و الذي كان صديقا مقربا من إدغار.
بعد ذلك التقينا في مناسبات عديدة، و كثيرا ما جمعتنا ظروف العمل و الحياة الشخصية معا.
جدير بالذكر أن موران في مقترحاته الفلسفة-علمية يطرح جانبا أي فصل بين الذات و الموضوع، و في حياته الخاصة تتحد تنظيراته مع مقارباته الشخصية.
مدفوعاً باهتماماته النظرية الشخصية، فقد صار إدغار موران - و لا زال: صحفيا، و عالم اجتماع، و متخصصا في العلوم السياسية و عالم فلسفة علوم.
و قد ترجمت عدة من أعماله إلى لغات متعددة؛ ابتدءا باللغات اليابانية و الصينية و الكورية وصولا إلى لغات أكثر قربا لنا هنا مثل الإسبانية أو الكاتالونية أو البرتغالية.
الأنا / الآخر: بعض مظاهر القصور في ميدان الترجمة ـ عبد السلام الطويل
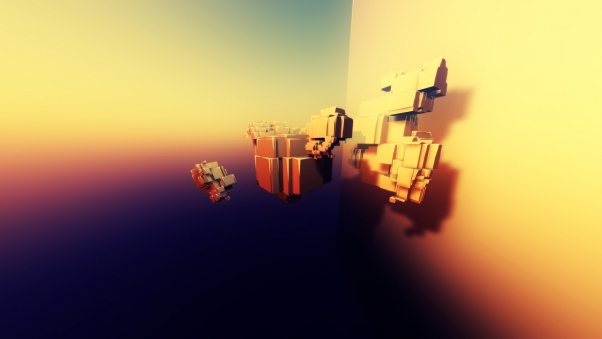 يقال عادة إن لحظة الترجمة(1) غالبا ما تأتي سابقة على لحظة التأليف، ويبقى هذا القول صحيحا إذا ما احتكمنا إلى عصر النهضة العربية. فإذا كانت حركة الترجمة في العصور الإسلامية الأولى، تلك التي بدأت(*) مع عبد الملك بن مروان، وبلغت أوجها مع المأمون في القرن الثالث الهجري (217هـ/832م)، بتأسيس "بيت الحكمة"، قد واكبتها عملية تأليف، إذ ظهر أول الفلاسفة العرب بمجرد ما ظهرت الترجمات الأولى للفلسفة اليونانية، بل كان التأليف أحيانا هو الذي يخلق الحاجة إلى الترجمة، كما حصل مع علم الكلام الذي نشأ "قبل ترجمة اللاهوت المسيحي عن السريانية"(2)، فإن لحظة التأليف في عصر النهضة جاءت متأخرة جدا عن لحظة الترجمة. إلا أن الثابت تاريخيا هو ضرورتها(**) في اللحظتين معا، ففي الحقبة الإسلامية الأولى، استدعتها ضرورة الانفتاح على العالم، وتحديدا، ضرورة سد بعض الثغرات في مجال تنظيم الدولة ووضع قوانين الجباية والقيام بشؤون الإدارة والمال، وكان من بعض نتائج ذلك، توسيع أفق الثقافة العربية الإسلامية لكي تشمل علوما وفنونا وفلسفات لم يكن لها بها علم من قبل، وإغناء اللغة بالمصطلحات والتعبيرات الجديدة في مختلف العلوم والفنون، الخ… أما ضرورتها بالنسبة للحظة الثانية، المتمثلة في عصر النهضة، فتتجلى في اعتبارها محفزا للفعل ودعوة للإبداع وتطويرا للمعرفة ومراكمة الخبرة، الخ.. مع فارق أساسي يتمثل في أن عصر الترجمة الأول جاء تعبيرا عن واقع متقدم ينقل تراث حضارات في طور السكون، بينما جاء عصر النهضة تعبيرا عن واقع متخلف يسعى إلى "اللحاق" بحضارة في طور التقدم.
يقال عادة إن لحظة الترجمة(1) غالبا ما تأتي سابقة على لحظة التأليف، ويبقى هذا القول صحيحا إذا ما احتكمنا إلى عصر النهضة العربية. فإذا كانت حركة الترجمة في العصور الإسلامية الأولى، تلك التي بدأت(*) مع عبد الملك بن مروان، وبلغت أوجها مع المأمون في القرن الثالث الهجري (217هـ/832م)، بتأسيس "بيت الحكمة"، قد واكبتها عملية تأليف، إذ ظهر أول الفلاسفة العرب بمجرد ما ظهرت الترجمات الأولى للفلسفة اليونانية، بل كان التأليف أحيانا هو الذي يخلق الحاجة إلى الترجمة، كما حصل مع علم الكلام الذي نشأ "قبل ترجمة اللاهوت المسيحي عن السريانية"(2)، فإن لحظة التأليف في عصر النهضة جاءت متأخرة جدا عن لحظة الترجمة. إلا أن الثابت تاريخيا هو ضرورتها(**) في اللحظتين معا، ففي الحقبة الإسلامية الأولى، استدعتها ضرورة الانفتاح على العالم، وتحديدا، ضرورة سد بعض الثغرات في مجال تنظيم الدولة ووضع قوانين الجباية والقيام بشؤون الإدارة والمال، وكان من بعض نتائج ذلك، توسيع أفق الثقافة العربية الإسلامية لكي تشمل علوما وفنونا وفلسفات لم يكن لها بها علم من قبل، وإغناء اللغة بالمصطلحات والتعبيرات الجديدة في مختلف العلوم والفنون، الخ… أما ضرورتها بالنسبة للحظة الثانية، المتمثلة في عصر النهضة، فتتجلى في اعتبارها محفزا للفعل ودعوة للإبداع وتطويرا للمعرفة ومراكمة الخبرة، الخ.. مع فارق أساسي يتمثل في أن عصر الترجمة الأول جاء تعبيرا عن واقع متقدم ينقل تراث حضارات في طور السكون، بينما جاء عصر النهضة تعبيرا عن واقع متخلف يسعى إلى "اللحاق" بحضارة في طور التقدم.
حوار مع رولان بارث ـ حاوره : هنري تيسو ـ ترجمة : هادي معزوز
 على عكس ما يحدث في جل الأنشطة الإنسانية، يبقى من الصعب العثور على تعريف حقيقي، جامع مانع للأدب، بيد أن لانعكاس الأدب على المجتمع والوجود عامة، كبير أثر على الإنسان، الأدب فلسفة عميقة تتغير وتغير سيرورة التاريخ، في هذا الحوار يؤكد المفكر العالمي رولان بارث أن للأدب قوة كبيرة جدا، وأنه ليس من الترف بمكان بقدر ما يحمل بين تضاعيفه عوالم تلخص وجود الإنسان سواء في علاقاته المباشرة من الذات، أو في علاقاته غير المباشرة مع المواضيع، في المقابل وإن تم إجراء هذا الحوار بعد عشرات السنين من اليوم وتحديدا سنة 1975 إلا أن راهنيته لازالت تلقي بظلالها لحد الساعة على الفضاء الأدبي...
على عكس ما يحدث في جل الأنشطة الإنسانية، يبقى من الصعب العثور على تعريف حقيقي، جامع مانع للأدب، بيد أن لانعكاس الأدب على المجتمع والوجود عامة، كبير أثر على الإنسان، الأدب فلسفة عميقة تتغير وتغير سيرورة التاريخ، في هذا الحوار يؤكد المفكر العالمي رولان بارث أن للأدب قوة كبيرة جدا، وأنه ليس من الترف بمكان بقدر ما يحمل بين تضاعيفه عوالم تلخص وجود الإنسان سواء في علاقاته المباشرة من الذات، أو في علاقاته غير المباشرة مع المواضيع، في المقابل وإن تم إجراء هذا الحوار بعد عشرات السنين من اليوم وتحديدا سنة 1975 إلا أن راهنيته لازالت تلقي بظلالها لحد الساعة على الفضاء الأدبي...
في ماذا يختلف الأدب عن باقي أجناس التعبير الكتابي؟
بداية توجب اعتبار أن سؤال: "ما الأدب؟" لم تتم صياغته إلا ابتداءً من مرحلة قريبة نسبيا، والحال أنه في ثقافتنا الغربية أنشئ الأدب منذ مدة ليست بالقصيرة دون أن يقدم لنا في الحقيقة نظرية في الأدب، أي نظرية في الأدب ككينونة، وهو ما كان حدوثه بالخصوص في فرنسا، من ثمة فقد كان القرن التاسع عشر قرنا كبيرا بخصوص التقدم العلمي، أي فيما يتعلق بعلوم الإنسان والعلوم الاجتماعية، لكن وللأسف نتباين فيما بيننا إذا أمكنني الحديث عن قصورنا النظري حول مشكلة الأدب، وتأكيدا فقد كانت هناك حركة تحليل الأعمال الأدبية، لكن لا أحد طرح بحق هذا الأمر كمشكلة لفلسفة الأدب، وبشكل أقل وطأة مقارنة بسؤال النقد العلمي، ففي فرنسا لم يكن لدينا ما يعادل التركيب الكبير الذي عرفته الفلسفة والتاريخ، أي ذاك الذي تم تكونه مع هيجل في ألمانيا، بخصوص اختلافات أجناس الفن. والحق أن مثيل هذا السؤال يعتبر قريبا بشكل نسبي، لقد طُرح هذا الأمر اليوم بشكل نظري وبحدة كبيرة، وخصوصا في الأعمال والنصوص الطليعية، إن الأمر يتعلق بوضع الفعل الأدبي في علاقة مع كبريات الأنظمة المعرفية الجديدة للعلوم الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال النقد السياسي أو التحليل النفسي، على العموم ومنذ أن وجدت هاته البيئة العلمية شرعنا في طرح سؤال: "ما الأدب؟"
الحياة العامة والحياة الخاصة ـ ميشال مافيزولي ـ ترجمة: حسن أحجيج
 عرف تاريخ الأمم الغربية مسألة المركزة منذ العصر الوسيط. فتزايد عدد الموظفين الملكيين في الأقاليم وعقلنة الضرائب ومراقبة الحياة المحلية كانت بمثابة أساس لتنظيم هرمي للمجتمع، وهو تنظيم ساهم في ترسيخه تقسيم المجتمع إلى محافظات. يتعين علينا أن نفهم التعارض أو التكامل القائمين بين العام Le public والخاص Le privé انطلاقا من هذا المستوى. إذ توجد بالفعل علاقة سببية متبادلة بين تزايد البنيات الدولتية أو العمومية وتباين الروابط الاجتماعية القاعدية. هذه السيرورة هي التي ولدت الفردانية أو "نزعة التخصيص" Privatisme التي تميز مجتمعاتنا. لقد سلط توكفيل الضوء على العلاقة الموجودة بين ما يطلق عليه هيمنة "الموظفين الإداريين" والإضفاء المتصاعد للاستقلالية على الأفراد. هكذا، ولأن الأفراد "لم يظلوا مرتبطين فيما بينهم بأي رباط طبقي أو عائلي أو رباط البلدة […]، فإنهم أصبحوا يميلون إلى الاهتمام بمصالحهم الخاصة فقط وإلى التفكير في أنفسهم والانغلاق في فردانية ضيقة خنقت فيها كل فضيلة جماعية".
عرف تاريخ الأمم الغربية مسألة المركزة منذ العصر الوسيط. فتزايد عدد الموظفين الملكيين في الأقاليم وعقلنة الضرائب ومراقبة الحياة المحلية كانت بمثابة أساس لتنظيم هرمي للمجتمع، وهو تنظيم ساهم في ترسيخه تقسيم المجتمع إلى محافظات. يتعين علينا أن نفهم التعارض أو التكامل القائمين بين العام Le public والخاص Le privé انطلاقا من هذا المستوى. إذ توجد بالفعل علاقة سببية متبادلة بين تزايد البنيات الدولتية أو العمومية وتباين الروابط الاجتماعية القاعدية. هذه السيرورة هي التي ولدت الفردانية أو "نزعة التخصيص" Privatisme التي تميز مجتمعاتنا. لقد سلط توكفيل الضوء على العلاقة الموجودة بين ما يطلق عليه هيمنة "الموظفين الإداريين" والإضفاء المتصاعد للاستقلالية على الأفراد. هكذا، ولأن الأفراد "لم يظلوا مرتبطين فيما بينهم بأي رباط طبقي أو عائلي أو رباط البلدة […]، فإنهم أصبحوا يميلون إلى الاهتمام بمصالحهم الخاصة فقط وإلى التفكير في أنفسهم والانغلاق في فردانية ضيقة خنقت فيها كل فضيلة جماعية".
يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كان بإمكان سلسلة من المؤشرات أن تفجر اليوم التعارض القائم بين الحياة العامة والحياة الخاصة. وبالفعل، وحسب لغة سوسيولوجية كلاسيكية، يمكن للمجتمعات (Gesellchaft)، من حيث هي جماعات من الأفراد المستقلين وجماعات محددة بمتوسط إحصائي، أن تترك مكانها للتجمعات (Gemeinchaft)، التي يمكن للجمعي أن يتحدد فيها برباط انفعالي.











