 إن ما نسميه بالزمن في مورفولوجيا لغة ما، لا يدخل في علاقة بسيطة ومباشرة مع ما نسميه بالزمن على المستوى الوجودي (حتى دون أن نفكر في المعاني الفلسفية للمصطلح)؛ يوجد دليل من بين أدلة أخرى، في لغات كثيرة، لمصطلحين مختلفين فيما يخص اللسني والمعيش، ففي الإنجليزية نجد: tense وtime، وفي الألمانية هناك: Tempus وZeit. فمن جهة يمكن للاختلافات الزمنية أن تحدد بوسائل أخرى غير زمن الفعل (الظروف، مفاعيل الزمن، التواريخ)؛ وحتى في بعض اللغات كالعبرية القديمة، نجد عنصرا هاما لمفهوم الزمن، حيث الاختلاف الكرونولوجي للماضي، والحاضر، والمستقبل غير محدد بشكل مباشر داخل الفعل. ومن جهة أخرى فزمن الفعل لا يصلح فقط لتعيين الزمنية، ولكن يعني أيضا علاقة خاصة بين الذي يتكلم، والمتكلم عنه. سنهتم، مع ذلك، بظاهرة تتموقع بين هذا وذاك "الزمن": أي تمثيلات الزمن في علاقتها بلحظة التلفظ، وهو ما سنسميه، بالمعنى الواسع، زمن الخطاب.
إن ما نسميه بالزمن في مورفولوجيا لغة ما، لا يدخل في علاقة بسيطة ومباشرة مع ما نسميه بالزمن على المستوى الوجودي (حتى دون أن نفكر في المعاني الفلسفية للمصطلح)؛ يوجد دليل من بين أدلة أخرى، في لغات كثيرة، لمصطلحين مختلفين فيما يخص اللسني والمعيش، ففي الإنجليزية نجد: tense وtime، وفي الألمانية هناك: Tempus وZeit. فمن جهة يمكن للاختلافات الزمنية أن تحدد بوسائل أخرى غير زمن الفعل (الظروف، مفاعيل الزمن، التواريخ)؛ وحتى في بعض اللغات كالعبرية القديمة، نجد عنصرا هاما لمفهوم الزمن، حيث الاختلاف الكرونولوجي للماضي، والحاضر، والمستقبل غير محدد بشكل مباشر داخل الفعل. ومن جهة أخرى فزمن الفعل لا يصلح فقط لتعيين الزمنية، ولكن يعني أيضا علاقة خاصة بين الذي يتكلم، والمتكلم عنه. سنهتم، مع ذلك، بظاهرة تتموقع بين هذا وذاك "الزمن": أي تمثيلات الزمن في علاقتها بلحظة التلفظ، وهو ما سنسميه، بالمعنى الواسع، زمن الخطاب.
ينتظم هذا الزمن حول الحاضر، فهو مفهوم لسني محض، يعين اللحظة التي يتكلم فيها. وتنقسم الأزمنة الأخرى (في اللغات الهند أوروبية، على الأقل) إلى مجموعتين كبيرتين، حسب العلاقة التي تربطها مع الحاضر، وبشكل عام، مع التلفظ. فالأزمنة الفرنسية مثلا، تتوزع ضمن السلسلات التالية:
اَلْأَصْدِقَاءُ ـ قصة : خُولْيُو كُورْطَاثَرْ ـ ترجمة : د. لحسن الكيري
 في تلك اللعبة كان يجب أن يمر كل شيء بسرعة. عندما قرر رقم واحد أنه يجب تنحية روميرو و أن رقم ثلاثة هو من سيتكفل بالمهمة، كان بِلْتْرَانْ قد توصل بالمعلومة دقائق قليلة بعد ذلك. بهدوء و لكن دون تضييع لحظة واحدة، خرج من مقهى كُوريينتس و لِبيرطاد و صعد إلى سيارة أجرة. بينما كان يستحم في شقته، مستمعا إلى الأخبار، تذكر أنه كان قد رأى روميرو آخر مرة في سان إسيدرو. في تلك الأثناء، كان روميرو يُدعى روميرو بينما هو كان يُدعى بلتران؛ صديقان حميمان قبل أن تفرق بينهما الحياة. ابتسم على مضض تقريبا، مفكرا في ردة الفعل التي يمكن أن يقوم بها روميرو عندما سيراه من جديد، لكن وجه روميرو لم يكن ذا أهمية و في المقابل كان يجب التفكير على مهل في قضية المقهى و السيارة. كان مثيرا للفضول أن تخطر ببال رقم واحد فكرة تدبير قتل روميرو في مقهى كُوتشابامبا و بييدراس، بينما في ذلك الحين، ربما كان هذا الرقم واحد قد تقدم في السن إن أمكن أن نصدق بعض المعلومات. في كل الأحوال، كانت حماقة الأمر تمنحه امتيازا: كان بإمكانه أن يخرج السيارة من المرأب و يركنها و المحرك مشتغلا بجانب كوتشابامبا ثم يبقى منتظرا حتى يصل روميرو كما العادة لملاقاة أصدقائه على الساعة السابعة عشية تقريبا.
في تلك اللعبة كان يجب أن يمر كل شيء بسرعة. عندما قرر رقم واحد أنه يجب تنحية روميرو و أن رقم ثلاثة هو من سيتكفل بالمهمة، كان بِلْتْرَانْ قد توصل بالمعلومة دقائق قليلة بعد ذلك. بهدوء و لكن دون تضييع لحظة واحدة، خرج من مقهى كُوريينتس و لِبيرطاد و صعد إلى سيارة أجرة. بينما كان يستحم في شقته، مستمعا إلى الأخبار، تذكر أنه كان قد رأى روميرو آخر مرة في سان إسيدرو. في تلك الأثناء، كان روميرو يُدعى روميرو بينما هو كان يُدعى بلتران؛ صديقان حميمان قبل أن تفرق بينهما الحياة. ابتسم على مضض تقريبا، مفكرا في ردة الفعل التي يمكن أن يقوم بها روميرو عندما سيراه من جديد، لكن وجه روميرو لم يكن ذا أهمية و في المقابل كان يجب التفكير على مهل في قضية المقهى و السيارة. كان مثيرا للفضول أن تخطر ببال رقم واحد فكرة تدبير قتل روميرو في مقهى كُوتشابامبا و بييدراس، بينما في ذلك الحين، ربما كان هذا الرقم واحد قد تقدم في السن إن أمكن أن نصدق بعض المعلومات. في كل الأحوال، كانت حماقة الأمر تمنحه امتيازا: كان بإمكانه أن يخرج السيارة من المرأب و يركنها و المحرك مشتغلا بجانب كوتشابامبا ثم يبقى منتظرا حتى يصل روميرو كما العادة لملاقاة أصدقائه على الساعة السابعة عشية تقريبا.
في ظل الغرب : حوار مع إدوارد سعيد(1)– ترجمة مصطفى ناجي
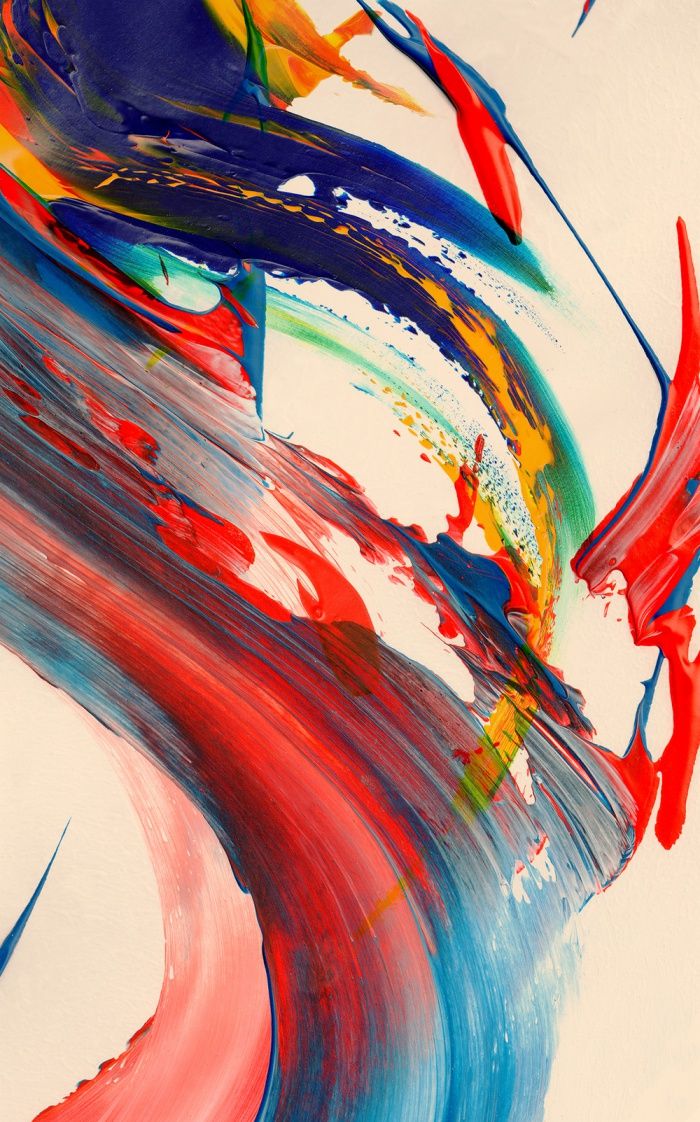 تقديم
تقديم
خلال الخمسينات والستينات ، كتب الجيل الأول من مفكري ما بعد الاستعمار le postcolonialisme ( فرانز فانون، إيمي سيزير ...) أعمالهم في ظل الاستعمار الأوروبي المباشر والحركة الوطنية من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي. لذلك اتسمت العلاقة لديهم بين الستعمر والمستعمر بالصدامية والعنف المتبادل...
وخلال السبعينات والثمانينات ظهر الجيل الثاني (إدوارد سعيد، هومي بابا، أنور عبد المالك...) الذي فتح أفقا جديدا للصراع بين الطرفين ، وبحث عن إمكانيات أخرى لمواجهة الغرب وهيمنته على صعيد التمثلات والأفكار.
ويعد إدوارد سعيد (1935-2003) من أشهر أعلام هذا الجيل من مفكري ما بعد الاستعمار. وهو مثقف فلسطيني حامل للجنسية الأمريكية. اشتغل أستاذا للأدب الإنجليزي والأدب المقارن بجامعة كولومبيا. وله عدة مؤلفات منها : الاستشراق (1978)، القضية الفلسطينية (1979)، تغطية الإسلام (1981)، الثقافة والإمبريالية (1993)...
هذا الحوار الذي نقدم ترجمته للقارئ العربي أجري في الأصل باللغة الأنجليزية سنة 1985. وقد نقلته إلى الفرنسية الفيلسوفة الجزائرية الأصل الحاملة للجنسية الفرنسية، و المهتمة بموضوع الاستشراق وفكر ما بعد الاستعمار سلوى لوست بولبينة Seloua Luste Boulbina . وقد نقلنا هذا الحوار عن هذه الترجمة الفرنسية.
في هذا الحوار، نجد حضورا للقضايا التي شغلت إدوارد سعيد، ابتداء من تأثره بفرانز فانون؛ ثم اهتمامه بالقضية الفسطينية؛ نقده لتمثلات الغرب حول الشرق ؛ سعيه لبناء ثقافة بديلة تصحح هذه التمثلات وتبرز زيفها...
هابرماس: سبل الديمقراطية الراديكالية ـ ستيفان هابر ـ ترجمة: محمد سهمي
 تغيرت دلالة القانون بشكل عميق مع المنعطف الديمقراطي الذي عرفته الفلسفة السياسية بفضل روسو. فمن اعتباره أداة لتنظيم العلاقات بين الأشخاص والسلط، أصبح القانون الوسيلة التي بواسطتها يعبر المجتمع عن إدراكه لذاته، وإرادته المستقلة، ومن هنا، لم يعد المواطن متصورا كمواطن يخضع لسلطة شرعية حيث بإمكانه الإفادة من قوانين بالمعنى الليبرالي للكلمة. ذلك أنه يتحدد، استقبالا كشخص واع يشارك في سيرورة متواصلة بواسطتها يفكر المجتمع في ذاته، ويتخذ قراره، والحال أن الأنظمة الغربية –رغم ادعاءاتها- حققت، وبشكل ناقص جدا، الإمكانيات الديمقراطية الخاصة بالقانون الحديث كما سبق أن اكتشفها روسو. يبدو أن الشكل التمثيلي للسلطة السياسية، المنحدرة من تجارب ثورية، قد اقتصر فقط على عملية ترويض القوى الديمقراطية كما سبق أن أكد على ذلك النقد الاشتراكي لـ"الدولة" البورجوازية في القرن التاسع عشر.
تغيرت دلالة القانون بشكل عميق مع المنعطف الديمقراطي الذي عرفته الفلسفة السياسية بفضل روسو. فمن اعتباره أداة لتنظيم العلاقات بين الأشخاص والسلط، أصبح القانون الوسيلة التي بواسطتها يعبر المجتمع عن إدراكه لذاته، وإرادته المستقلة، ومن هنا، لم يعد المواطن متصورا كمواطن يخضع لسلطة شرعية حيث بإمكانه الإفادة من قوانين بالمعنى الليبرالي للكلمة. ذلك أنه يتحدد، استقبالا كشخص واع يشارك في سيرورة متواصلة بواسطتها يفكر المجتمع في ذاته، ويتخذ قراره، والحال أن الأنظمة الغربية –رغم ادعاءاتها- حققت، وبشكل ناقص جدا، الإمكانيات الديمقراطية الخاصة بالقانون الحديث كما سبق أن اكتشفها روسو. يبدو أن الشكل التمثيلي للسلطة السياسية، المنحدرة من تجارب ثورية، قد اقتصر فقط على عملية ترويض القوى الديمقراطية كما سبق أن أكد على ذلك النقد الاشتراكي لـ"الدولة" البورجوازية في القرن التاسع عشر.
تعزز هذا الاتجاه مع مجيء الدولة الراعية (Etat Providence)، ذلك أن وضع آليات للحماية (= الرعاية) الاجتماعية كان جد مكلف من أجل وصاية متزايدة، وتشجيع لإعادة توجيه الأفراد نحو الحياة الخاصة، والاستهلاك الذي أدى إلى عدم الاهتمام بالدائرة العمومية. لقد أصبحت السياسة منكرة على المجتمع المدني أكثر من أي وقت مضى. ومع ذلك، هناك إشارات إلى أن هذه الوضعية بدأت تتغير. فالعداوة النامية إزاء إغواء السياسي للنخب التقنوقراطية ومحترفي السياسة، وتوسيع الممارسات الديمقراطية لتطال ميادين جديدة، والإحلال الصعب لديمقراطية محلية والدور المتكاثر لـ"حركات اجتماعية"، والتزامات المواطنين –كل هذا يشير إلى إرادة للإفلات من خيار خاطئ بين ديمقراطية "تمثيلية" تكشف –أمام أعيننا- عن حدودها، وبين ديمقراطية مباشرة أمست مستحيلة –كما سبق أن أشار إلى ذلك روسو- من خلال الشروط الاجتماعية للحداثة. هناك طريق ثالث ضمن الممكنات المحركة التي يتضمنها عصرنا، ويتعلق الأمر بـ ديمقراطية راديكالية يسودها مبدأ التنظيم الذاتي للمجتمع ذي الأنماط المتعددة.
بين الفلسفة والشعر ـ عبد الفتاح كيليطو
 هل يستطيع المرء امتلاك لغتين؟ هل بإمكانه أن يبرع فيهما معا؟ ربما لن نهتدي إلى جوانب إلا إذا أفلحنا في الإجابة عن سؤال آخر: هل يمتلك المرء لغة من اللغات؟ أتذكر أنني سمعت كلاما لم أعثر بعد على مرجعه، يصف فيه أحد القدماء علاقته بالعربية، فيقول: "هزمتها فهزمتني، ثم هزمتها فهزمتني"، مشيرا إلى أن علاقته بها متوترة، وأن الحرب سجال بينهما، مرة له ومرة عليه؛ ولكن الكلمة الأخيرة لها، لهذه الكائنة الشرسة التي تأبى الخضوع والانقياد. ينتهي القتال دائما بانتصارها، ولا يجد المرء بدا من مهادنتها ومسالمتها والاستسلام لها، وإن على مضض.
هل يستطيع المرء امتلاك لغتين؟ هل بإمكانه أن يبرع فيهما معا؟ ربما لن نهتدي إلى جوانب إلا إذا أفلحنا في الإجابة عن سؤال آخر: هل يمتلك المرء لغة من اللغات؟ أتذكر أنني سمعت كلاما لم أعثر بعد على مرجعه، يصف فيه أحد القدماء علاقته بالعربية، فيقول: "هزمتها فهزمتني، ثم هزمتها فهزمتني"، مشيرا إلى أن علاقته بها متوترة، وأن الحرب سجال بينهما، مرة له ومرة عليه؛ ولكن الكلمة الأخيرة لها، لهذه الكائنة الشرسة التي تأبى الخضوع والانقياد. ينتهي القتال دائما بانتصارها، ولا يجد المرء بدا من مهادنتها ومسالمتها والاستسلام لها، وإن على مضض.
إذا كان هذا حال المتكلم مع لغة واحدة، مع لغته، فكيف حاله مع لغتين أو أكثر؟ كيف ينتقل من هذه إلى تلك، كيف يتصرف بينهما، وكيف يتدبر أمره مع الترجمة المستمرة التي يمارسها؟ سأحاول الخوض في جانب من هذه الأسئلة استنادا إلى الجاحظ، إلى كاتب لا نعرف بالتأكيد إن كان يتقن لغة غير العربية، مع العلم أن في مصنفاته علامات تشير إلى أنه لم يكن يجهل الفارسية.
ولنبدأ بما قال في البيان والتبيين عن أبي علي الأسواري، الذي قص في أحد المساجد "ستا وثلاثين سنة، فابتدأ لهم في تفسير سورة البقرة، فما ختم القرآن حتى مات، لأنه كان حافظا للسير، ولوجوه التأويلات، فكان ربما فسر آية واحدة في عدة أسابيع". إن تفسير القرآن عملية طويلة لا يحدها إلا عمر المفسر.. بأية لغة كان أبو علي الأسواري ينجز شرحه؟ بالعربية طبعا، والظاهر أن جمهوره يتكون أساسا من العرب، ومن بعض العجم الذين تعلموا العربية. ولكن كيف كان يتم تفسير كتاب الله لأولئك الذين يجهلون اللغة التي أوحي بها؟
اللعب والكلام ـ Francis Wy brands ـ ترجمة : الحسين سحبان
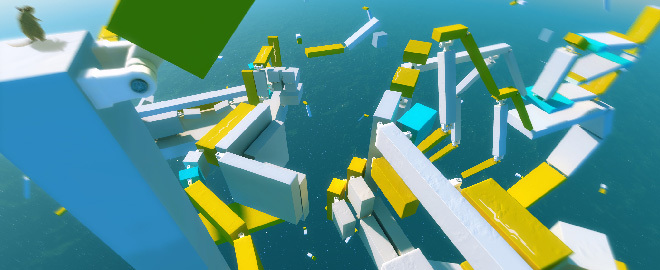 "أما كل شيء إذن إلا لعب ومبادلة أو تحويل لشيء لا يتبدل le même، فلا يلفى في أي جهة اسم، ولا مكان حتى لربح أو مكسب حميم." ريلكه، مرثية (إلى مارينا تسفيتايفا) ترجمة: Ph. Jaccottet
"أما كل شيء إذن إلا لعب ومبادلة أو تحويل لشيء لا يتبدل le même، فلا يلفى في أي جهة اسم، ولا مكان حتى لربح أو مكسب حميم." ريلكه، مرثية (إلى مارينا تسفيتايفا) ترجمة: Ph. Jaccottet
"أدعوكم للعب، للنظر بانتباه… أدعوكم للتفكير"
أ.تابيز، ممارسة الفن ("أفكار"، غاليمار، ص 144).
"ليس في اللعب "لأن"، ولا "لماذا". إن اللعب هو لعب حين يجري. فاللعب هو وحده الذي يبقى: إنه أسمى وأعمق ما يوجد.
غير أن "وحده" [ لا يعني أن اللعب جزء من كل، بل يعني أنه ] هو الكل، وأنه الواحد الأوحد".
م.هيدجر، مبدأ السبب (ترجمة A.Breau، ص 243)
يكشف اللعب عن نفسه في أوجه تتعدد بحيث يبدو من المستحيل بلوغ أي إدراك لمعناه في مستوى المفهوم. إذ ما هو المشترك، بالفعل، بين لعب [حركة ارتفاع وانخفاض] الأمواج le jeu des vagues، ولعب(1) (التلاعب) الكلمات le jeu des mots ، بين اللعب الذي يخص به الأطفال وبين اللعب [مجموع الحركات الآلية] الذي يتيح لقطع آلة أن تشتغل؟ تجاه هذا التبعثر الذي يحول دون التفكير في اللعب، بسبب حصره، في كل مرة، لمعنى اللعب في دائرة منفصلة (جمالية، لسانية، سوسيولوجية، سيكولوجية…)، يمكن، مع ذلك، إبراز تصورين كبيرين للعب:واحد لهوي ludique، وآخر كوسمولوجي Cosmologique. يقول أحد هذين التصورين إن كل شيء لعب: كل شيء يلعب من الإنسان إلى الإله. ويقول التصور الآخر إن الكائن، في مجموعه، هو، في عمقه، لعب. إن كان لا فرق بين هذين التصورين، اللذين يقولان الشيء نفسه le même، سوى في التشديد والتوكيد، فذلك لأنهما قائمان على أساس واحد غير مفكر فيه. [هذا الأساس هو الذي يكشف عنه] هيدجر في اعتراضه على الطابع الأنثروبولوجي لكل تصور لهوي للعب، وعلى الصبغة "الميتافيزيقية" لكل تصور كوسمولوجي للعب.
حوار كليمان روسي : شوبنهاور فيلسوف مثير وجذاب – ترجمة: ادريس بنشريف
 لا تكمن جاذبية شوبنهاور بالنسبة للفيلسوف الفرنسي المعاصر كليمان روسي، في نزعة التشاؤم التي وسمت فلسفته؛ وإنما في الخلاص من تراجيديا الوجود وعبثيته المصاحبة لإرادة الحياة. خلاص يجد في البعد الإستيطيقي علاجا حقيقيا لمأساة الإنسان، إنه ليس علينا أن نجد متعة في آلام الحياة وأوجاعها، وإنما ينبغي علينا أن نتمسك بفرحة الحياة رغم الجوانب المأساوية للواقع والوجود بتعبير نيتشه؛ليس من الصدف السعيدة إذن، أن تشكل العلاقة شوبنهاور نيتشه مركز الثقل في اهتمامات كليمون روسي،إنها ليست بالعلاقة الواضحة كما يدعي البعض؛ بالنسبة لنيتشه يتجه المرح دوما إلى أقصى الحدود مقارنة بالحزن عند شوبنهاور، إذ ظل تحليل الضغينة مغيبا عند هذا الأخير في الوقت الذي أخضعها نيتشه لمطرقة النقد الجينيالوجي.
لا تكمن جاذبية شوبنهاور بالنسبة للفيلسوف الفرنسي المعاصر كليمان روسي، في نزعة التشاؤم التي وسمت فلسفته؛ وإنما في الخلاص من تراجيديا الوجود وعبثيته المصاحبة لإرادة الحياة. خلاص يجد في البعد الإستيطيقي علاجا حقيقيا لمأساة الإنسان، إنه ليس علينا أن نجد متعة في آلام الحياة وأوجاعها، وإنما ينبغي علينا أن نتمسك بفرحة الحياة رغم الجوانب المأساوية للواقع والوجود بتعبير نيتشه؛ليس من الصدف السعيدة إذن، أن تشكل العلاقة شوبنهاور نيتشه مركز الثقل في اهتمامات كليمون روسي،إنها ليست بالعلاقة الواضحة كما يدعي البعض؛ بالنسبة لنيتشه يتجه المرح دوما إلى أقصى الحدود مقارنة بالحزن عند شوبنهاور، إذ ظل تحليل الضغينة مغيبا عند هذا الأخير في الوقت الذي أخضعها نيتشه لمطرقة النقد الجينيالوجي.
ليس الأهم في هذه العلاقة، حسب فيلسوفنا، نقط التقاطع؛ بل هي نقط التمايزات حيث التحرر من سلطة المربي تقتضي الاحتفاء بموته الرمزي. هكذا وتحت تأثير نيتشه سقط شوبنهاور في طي النسيان طيلة عقود فلم يعد أي داع للحديث عن تشاؤميته ،والإحتفاء بها. لكن اللقاء مع فلسفة سيوران شكل منعرجا حاسما أعيد فيه الاعتبار لشوبنهاور من خلال ثلاث مسائل أساس:
أولها غلبة قوى الرغبة والغريزة على قوى اللوغوس ،ثانيها مأساوية الوجود وعبثيته،ثالثها الأفق الذي يفتحه الـتأمل الإستيطيقي لتخليص الإنسان من المعاناة المصاحبة لإرادة الحياة؛ فكل براهيننا وتفسيراتنا العقلية حول العالم وحول أنفسنا ليست سوى نتاج إرادة عمياء تنفلت منا كطاقة عمياء و هوجاء تسري في العالم. لكن كيف يمكن أن تكون الإرادة سبب معاناتنا ، بينما الموسيقى كتعبير عن هذه الإرادة هي مصدر مرحنا ؟مفارقة أرقت كليمون روسي منذ ستينيات القرن المنصرم دون أن يجد لها جوابا شافيا ؛لذا لم يعتبر فلسفة شوبنهاور مجرد مسكن للألم؛بل هي أعمق من ذلك ،إنها فلسفة إستيطيقية تحمل من التميز والأصالة ما يبهر؛فكان لها بحق الأثر البالغ في التيارات الفنية للقرن العشرين.
هُومِيرُوسْ ـ نص : إِدْوَارْدُو غَالْيَانُو ـ ترجمة :د. لحسن الكيري
 لم يكن يوجد شيء و لا أحد. و لا حتى الأشباح كانت توجد. لم يكن هناك أكثر من مجرد صخور صماء، و نعجة أو نعجتين تبحثان عن الكلإ بين الخراب.
لم يكن يوجد شيء و لا أحد. و لا حتى الأشباح كانت توجد. لم يكن هناك أكثر من مجرد صخور صماء، و نعجة أو نعجتين تبحثان عن الكلإ بين الخراب.
لكن هذا الشاعر الأعمى عرف كيف يرى، هنالك، تلك المدينة الكبيرة التي لم تكن توجد. رآها محاطة بالأسوار الضخمة، سامقة فوق التل مشرفة على الخليج؛ و سمع ولولات و زمجرات الحرب التي دمرتها.
و أنشدها. كان ذاك إعادة تأسيس لطروادة. لقد ولدت طروادة من جديد. ولدت من كلمات هوميروس، بعد مرور أربعة قرون و نصف على إبادتها. و هكذا انتقلت حرب طروادة، التي كانت منذورة للنسيان، إلى أشهر حرب بين الحروب.
يقول المؤرخون إنها كانت حربا تجارية. بحيث أغلق الطرواديون ممر العبور نحو البحر الأسود و أنهم كانوا يجنون ربحا كبيرا من ذلك. و أباد الإغريقيون طروادة كي يفتحوا لأنفسهم ممرا نحو الشرق عبر معبر الدردنيل. لكن كانت كل الحروب التي شهدها العالم تجارية أو تقريبا كلها كذلك. لماذا يمكن أن يحق لهذه الحرب التي تكاد تكون غير حقيقية أن تخلد في الذاكرة؟












