 حسبنا من الحقائق الجلية الخفية أو القريبة البعيدة، حقيقتان اثنتان وهما: الأصل في الترجمة هي الحاجة، والغاية منها إدخال الآخر في الذات في سبيل اختصار المسافة بينهما.
حسبنا من الحقائق الجلية الخفية أو القريبة البعيدة، حقيقتان اثنتان وهما: الأصل في الترجمة هي الحاجة، والغاية منها إدخال الآخر في الذات في سبيل اختصار المسافة بينهما.
بات من المؤكد للدارسين أن الفكر المدعي للتمامية والاكتمال يكون منسد الأفق ينذر انسداده بإمكان التحول إلى عنف رهيب ومنقلب كئيب، لذلك استشعرت الحضارة العربية الإسلامية منذ بداياتها الأولى حاجة ماسة إلى ترجمة علوم الأوائل أي إقحام الثقافات الأخرى في جسدها حتى يتحقق الإقلاع الفكري، فثمة تلازم بين الترجمة والتحديث([1]). وهذه مسألة لا ينكرها إلا مكابر ولا تذهب إلا عن غافل.
ثابت لدينا أن الفكر اليوناني انتقل إلى الثقافة العربية الإسلامية عبر مسار جغرافي متنوع وخلال فترة تاريخية طويلة، وقبل أن نذكر أهم هذه المواقع الجغرافية ننبه إلى ملاحظة هامة عرضت لنا أثناء دراسة بعض الأسفار المرتبطة بالموضوع، يتعلق الأمر بتباين مواقف الباحثين بخصوص تحقيب مراحل تطور الترجمة ووظائفها، بين ذاهب إلى تقسيمها إلى مرحلتين بارزتين، الترجمة في العصر الأموي، والترجمة في العصر العباسي، وبين مدع بضرورة ربطها فقط بالزمن العباسي، وبين زاعم بفكرة تقسيمها بحسب أزمنة خلفاء بني العباس(*).
التعرّف على عقل الله : نظرية كل شيء ـ Michael Marshall ـ ترجمة : حمودة إسماعيلي
 تُعتبر "نظرية كل شيء" من أهم الأحلام العزيزة على العلم. فلو تم اكتشافها، ستؤدي حتماً إلى كشف عمل الكون على المستوى الأساسي وذلك يشمل فهمنا العام للطبيعة. وستقدم لنا كذلك إجابات عن الألغاز المستمرة مثل ماهية المادة المظلمة، سبب جريان الزمن باتجاه واحد، وكيفية عمل الجاذبية. شيء مثير، كما قال الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ على أن مثل هذه النظرية ستكون : "الانتصار المطلق للعقل البشري ـ من ثم وجب علينا معرفة عقل الله".
تُعتبر "نظرية كل شيء" من أهم الأحلام العزيزة على العلم. فلو تم اكتشافها، ستؤدي حتماً إلى كشف عمل الكون على المستوى الأساسي وذلك يشمل فهمنا العام للطبيعة. وستقدم لنا كذلك إجابات عن الألغاز المستمرة مثل ماهية المادة المظلمة، سبب جريان الزمن باتجاه واحد، وكيفية عمل الجاذبية. شيء مثير، كما قال الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ على أن مثل هذه النظرية ستكون : "الانتصار المطلق للعقل البشري ـ من ثم وجب علينا معرفة عقل الله".
لكن لا يجب على الثيولوجيين أو علماء اللاهوت (الفقهاء) أن يفقدوا طعم النوم حتى الآن، فبالرغم من عقود من الجهود المبذولة، فإن إحراز التقدم لايزال بطيئا. العديد من الفيزيائين ألزموا أنفسهم بتطوير نظريات "جاذبية الكوانتم" من خلال سعيهم للتوفيق بين ميكانيكا الكوانتم والنسبية العامة ـ كشرط أساسي لنظرية عن كل شيء. لكن بدل الخروج بنظرية أو نظريتين متنافستين تكونان أهلاً للاحتكام ضد الأدلة، هاهنا وفرة من الترشيحات التي تعالج أجزاء مختلفة من المسألة، وبعض القرائن القيمة التي على نحو (أي منها) يمكن أن تكون صحيحة.
هل مات الإنسان ؟ حوار للمفكر الفرنسي ميشيل فوكو ، ترجمة : محمد قرافلي
 - هل مات الإنسان ؟
- هل مات الإنسان ؟
- يسود الاعتقاد بأن النزعة الإنسانية، مفهوم يضرب في القدم ويعود إلى اعمال مونتين وما قبله. إلا اننا لانعثر في قاموس "ليتري" Littré" عن هذا المفهوم . الواقع انه نتيجة لهذا التغليط الذي نقع ضحيته، وقلما يتم الانتباه إليه نتصور عن وعي ان النزعة الانسانية كانت ولاتزال تمثل علامة فارقة وتابثة في الثقافة الغربية . لذلك فإن ما يميز الثقافة الغربية عن غيرها من الثقافات الأخرى، الشرقية ، كالثقافة الاسلامية، بالضبط هو النزعة الإنسانية. قد نصاب بالصدمة عندما نعثر على آثار تلك النزعة عند الثقافات الأخرى ، لدى كاتب عربي ما او عند مفكر صيني، مما يولد الانطباع بأننا نتوجه نحو كونية النوع البشري.
الواقع، أنه ليس فقط لاوجود لما نسميه النزعة الإنسانية في الثقافات الأخرى بل من المحتمل أيضاً ان تشكل في ثقافتنا شكلا من السراب.
يتداول في التعليم الثانوي بأن القرن السادس عشر هو عصر سيادة النزعة الانسانية بحيث عملت النزعة الكلاسيكية على الاهتمام بالمشكلات الكبرى للطبيعة الانسانية، وبأن القرن الثامن عشر ابتكر علوما وضعية سمحت بمعرفة الإنسان من منظور وضعي، وبكيفية عقلانية متمثلة في العلوم البيولوجية، وعلم النفس وعلم الاجتماع .
نتصور مبدئيا بأن النزعة الإنسانية تمثل قوة حيوية تؤثر في تطورنا التاريخي والتي هي ثمرة ومحصلة هذا التطور نفسه. باختصار تمثل النزعة الإنسانية المبدأ والغاية في تلك الحركية. ما يبهرنا في ثقافتنا الراهنة هو ان يكون همها الاهتمام بما هو إنساني . أما إذا حصل الحديث عن البربرية المعاصرة فإنه يتم الإشارة عرضا الى البعد الأداتي أو إلى بعض المؤسسات التي تبدو لنا أنها غير إنسانية.
كل تلك الادعاءات من قبيل الوهم لعدة اعتبارات :
تمفصل العنف والكلام في السياسة والشعر والفلسفة عند بول ريكور ـ ترجمة وتقديم د.زهير الخويلدي
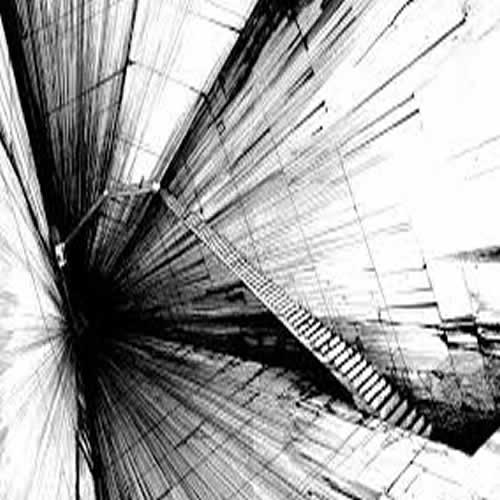 " مشكل الكلام في مواجهة العنف ليس مشكل بنية ، إنما مشكل معنى"1[1]
" مشكل الكلام في مواجهة العنف ليس مشكل بنية ، إنما مشكل معنى"1[1]
كيف تدرك العلاقة بين العنف والكلام وبين القوة والحق وبين الحرب والسلم وبين التنازع والتكاتف ؟ هل يبدو التعارض واضحا والاختيار بينهما من الأمور السهلة ؟ وكيف يتخيل المرء إمكانية الاختيار بين وضعيتين قصوويتين تتميزان برفضهما للتواصل بين الذوات والمجموعات بروز التوتر والتباعد في وجهات النظر والتصورات الكبرى للعالم ؟ وبماذا يضع الإنسان معايير قابلة للتطبيق للتفرقة بينهما؟
الجواب عند بول ريكور على هذه الأسئلة صعب ويقتضي المرور بطريق طويل من التدقيق والتقصي وزيارة الكثير من المرجعيات المتنوعة والتجارب المتعددة والتحلي بالحذر الفلسفي والنقد المنهجي. إذ تبدو اللغة بوصفها المسرح الذي يتجلي من خلاله العنف ويأتي إلى العالم ويتعلق بالشأن الإنساني من جهة أولى ولكن الكائن البشري بوصفه كائن الكلام والتفكير والاجتماع هو الوحيد الباحث عن معنى حياته والمتفهم لوضعيات وجوده وهو المبدع الوحيد لاستراتيجيات التنظيم وإعادة البناء وتسخير أشياء الكون لتحقيق مصالحه المادية والمعنوية والساعي إلى الحياة الجيدة والوجود الأصيل ولذلك يضع حدا للعنف من ناحية أخرى عن طريف أفعال الكلام ولغة الحوار وجدلية السؤال والجواب وصنع تاريخه المشرق. ما يسترعي الانتباه هو الإقرار الريكوري التالية: "لا مشروع ثوري بلا وعي وبلا امتلاك الوعي، إذن بلا تمفصل للمعنى". فهل تتوقف عملية انجاح المشروع الثوري على تقاطع فعل التكلم في السياسة والشعر والفلسفة؟ ألا يمنح العنف اللاّمعنى للكلام الثوري؟
جيل دولوز: "الفلاسفة الجدد" ـ ترجمة: عبدالعالي نجاح
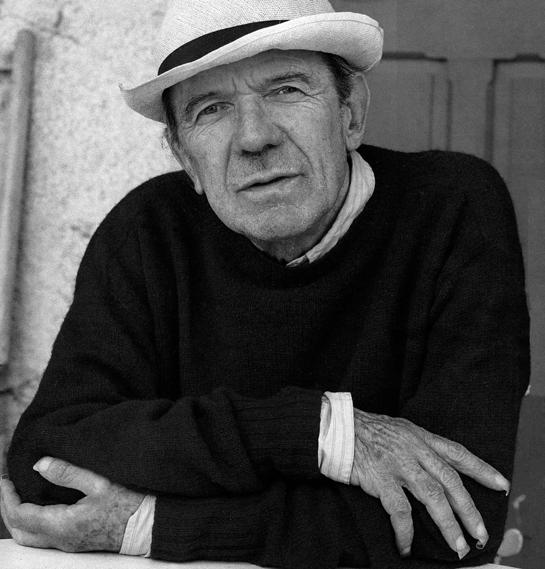 * ما رأيك في "الفلاسفة الجدد"؟ (*)
* ما رأيك في "الفلاسفة الجدد"؟ (*)
جيل دولوز: لا شيء. أظن أن تفكيرهم بدون قيمة. أرى سببان ممكنان لهذه الرداءة. بداية، إنهم يفكرون بواسطة مفاهيم كبرى، مثل أسنان مسوسة، القانون والسلطة والمعلم والعالم والتمرد والإيمان، الخ. ويمكنهم القيام بالتالي بمزيج فضيع، ثنائيات مختزلة، القانون والتمرد، السلطة والملاك. وفي نفس الآن، بقدر ما أن محتوى التفكير يكون ضعيفا، فإن المفكر يثير الاهتمام، وأن موضوع الطرح يأخذ أهمية في علاقة مع طروحات فارغة ("أنا، بصفتي متنور وشجاع، أقول لكم...؛ أنا بصفتي جندي المسيح...؛ أنا، من الجيل الضائع...؛ نحن، بصفتنا قد قمنا بأحداث ماي 68...). إنهم يكسرون العمل بهاتين الطريقتين في التفكير. لأنه منذ زمن مضى، وفي كل المجالات المختلفة، يشتغل الناس قصد تفادي هذه المخاطر. نحاول تشكيل مفاهيم بتمفصل جد دقيق، أو جد مميز، قصد عدم السقوط في الخاصيات الثنائية الكبرى. ونحاول استخراج وظائف إبداعية التي لا تمر قط بالوظيفة/كاتب (في الموسيقى وفي الصباغة وفي السمعي البصري وفي السينما وحتى في الفلسفة). تمثل هذه العودة المطردة إلى كاتب ما أو إلى موضوع فارغ وبدون معنى، وإلى مفاهيم نمطية مختزلة، قوة تفاعل مقلق. يطابق ذلك إصلاح آبي(1): تقليص خطير ل'برنامج" الفلسفة.
ألبرتو موراڤيا، فن الأدب القصصي، المقابلة السادسة ـ حاوره : آنّا ماريّا دي دومونيشس وَبن جونسون ـ ترجمة: ريوف خالد
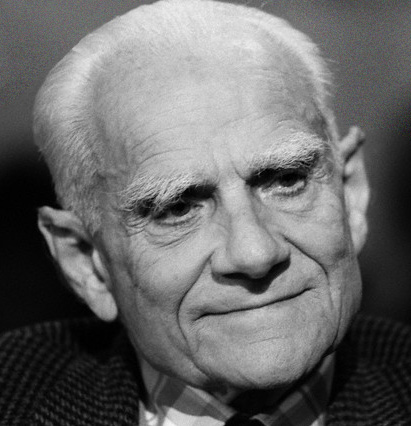 يقع شارع ڤياديلوكّا بالقرب من ميدان ﭙيازا ديل ﭙوﭙلو، الشارع المُشكّل بغرابة يتسع عند منتصفه وينتهي نهايتين متدرّجتين رفيعتين، في ممره القصير المرصوف الممتد من سد لونغوتيڤيريه إلى جانب من كنيسة سانتا ماريّا دي ميراكولي. أخذ شارع الإوزة "ڤياديلوكّا" اسمه، مثل شوارع عديدة في روما، من لافتة مطعم منسي منذ زمن.على جهة ممتدة دون انقطاع، من ضفة نهر تايبر إلى شارع ڤياريـﭙتّا، تنتشر بيوت الطبقة العاملة؛ طابور من المداخل الضيّقة بسلالمٍ رطبةٍ مظلمةٍ صغيرةٍ، نوافذ محشورة، خيطٌ من المتاجر الصغيرة، روائح فواكه محلّاة، متاجر ترميم، كحول كاستيلّي، عوادم المحركات، بكاء صبية الشارع، أزيز تجريب درّاجات غوزّيه الناريّة، ومواء من الساحة.
يقع شارع ڤياديلوكّا بالقرب من ميدان ﭙيازا ديل ﭙوﭙلو، الشارع المُشكّل بغرابة يتسع عند منتصفه وينتهي نهايتين متدرّجتين رفيعتين، في ممره القصير المرصوف الممتد من سد لونغوتيڤيريه إلى جانب من كنيسة سانتا ماريّا دي ميراكولي. أخذ شارع الإوزة "ڤياديلوكّا" اسمه، مثل شوارع عديدة في روما، من لافتة مطعم منسي منذ زمن.على جهة ممتدة دون انقطاع، من ضفة نهر تايبر إلى شارع ڤياريـﭙتّا، تنتشر بيوت الطبقة العاملة؛ طابور من المداخل الضيّقة بسلالمٍ رطبةٍ مظلمةٍ صغيرةٍ، نوافذ محشورة، خيطٌ من المتاجر الصغيرة، روائح فواكه محلّاة، متاجر ترميم، كحول كاستيلّي، عوادم المحركات، بكاء صبية الشارع، أزيز تجريب درّاجات غوزّيه الناريّة، ومواء من الساحة.
في الجهة المقابلة؛ المباني أطول، تخرج بعشوائية عن النطاق، يُشكّلها التعجرف الخالص للأفاريز المتّصلة والشُرفات الطافحة بمتسلّقات مؤصّصة، نباتات زاحفة مُعتنى بها؛ هذه منازل الأثرياء. هنا، في هذه الجهة، يعيش ألبرتو موراڤيا، في البناء العصري الوحيد في الحي. البناء الناتئ مثل سدّ بلون اليشب والعاج بالنسبة للمحيط الأحمر الذهبي.
يُفتح الباب من قِبل العاملة المنزليّة، فتاة سمراء ترتدي الثوب الأسود التقليدي والمريلة البيضاء. في المدخل، خلفها، يظهر موراڤيا متحقّقًا من وصول صندوق نبيذ، يستدير. ليذهب المحاور إلى غرفة الجلوس، حيث سيكون موراڤيا هنا حالًا.
أن تقتل طفلاً ـ قصة : ستيغ داغِرمان (Stig Dagerman) ـ ترجمة : فهد الملقي
 إنه يوم هادئ والشمس مائلة فوق السهل. قريباً ستُقرَع الأجراس؛ إنه يوم الأحد. بين حقلين من حقول الجاودار وجد يافعان درباً لم يسيرا فيه من قبل، وفي ضيعات السهل الثلاث يلمع زجاج النوافذ. رجالٌ يحْلقون ذقونهم أمام المرايا على طاولات المطابخ، ونساءٌ يدندنّ وهن يقطّعن الخبز الذي سيؤكل مع القهوة، وأطفال يجلسون على الأرض ويزرّرون قمصانهم. إنه صباح سعيد ليوم تعيس؛ فاليوم سيُقتل طفل في الضيعة الثالثة على يد رجل سعيد. لا يزال الطفل جالساً على الأرض ويزرّر قميصه، والرجل الذي يحلق ذقنه يقول إنه سيصحبهم اليوم بجولة في مركب ذي مجاذيف على طول النهر، والمرأة تدندن وتضع الخبز المقطّع في صحن أزرق.
إنه يوم هادئ والشمس مائلة فوق السهل. قريباً ستُقرَع الأجراس؛ إنه يوم الأحد. بين حقلين من حقول الجاودار وجد يافعان درباً لم يسيرا فيه من قبل، وفي ضيعات السهل الثلاث يلمع زجاج النوافذ. رجالٌ يحْلقون ذقونهم أمام المرايا على طاولات المطابخ، ونساءٌ يدندنّ وهن يقطّعن الخبز الذي سيؤكل مع القهوة، وأطفال يجلسون على الأرض ويزرّرون قمصانهم. إنه صباح سعيد ليوم تعيس؛ فاليوم سيُقتل طفل في الضيعة الثالثة على يد رجل سعيد. لا يزال الطفل جالساً على الأرض ويزرّر قميصه، والرجل الذي يحلق ذقنه يقول إنه سيصحبهم اليوم بجولة في مركب ذي مجاذيف على طول النهر، والمرأة تدندن وتضع الخبز المقطّع في صحن أزرق.
ميشيل فوكو: المفهوم العلمي لـ"الحقيقة" وعدم الفهم الفلسفي لـ"العلم"(1) ـ ترجمة: عبد العالي نجاح
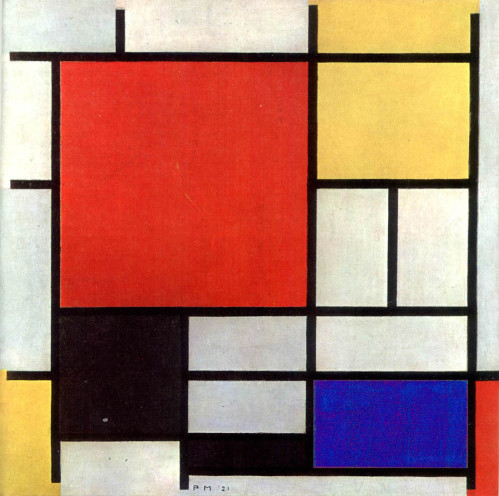 في الحقيقة، في العلوم، وفي المعنى المضاد للفلسفة حول موضوعها.
في الحقيقة، في العلوم، وفي المعنى المضاد للفلسفة حول موضوعها.
نجد في العلوم استعمالين متكررين للحقيقة، والذي يجب توضيحه. يخول الأول تجاوزا إقرار الاستعمال “الجيد” أو “الفاسد” للعلوم. القول عن برهان بأنه “خاطئ”، لا يعني القول بأن ضده “صائب”: يحيل “الخطأ” إذا على الغلط. يعني “الخطأ” الذي يكتبه أستاذ الرياضيات على هامش الورقة “أن الذي أقرؤه هنا ليس له معنى رياضي”. كما يمكن القول عن عبارة بأنها خاطئة نحوياً: إنها سيئة البناء بالنظر للمنهج المسبق الذي حددته.
يستعمل الثاني لتقييم فرضية منطقية: نقول عن فرضية بأنها صائبة، كما نقول عن أخرى أنها خاطئة. الصواب والخطأ قيمتان ممكنتان ومتبادلتان لفرضية ما. مثلا، أحدد بأن العبارة “(أ) و(ب) خطان متوازيان” صائبة. إنها القيمة المنطقية لهذه العبارة. كان بإمكاني أيضا تحديد أنها خاطئة. تعمل المسلمات الرياضية بنفس الطريقة. إلى ذلك، حيث يتمثل تمرين الرياضيات في إنتاج مسلمات بواسطتها يمكن تقريب الحقيقة، إلى حقيقة فرضيات أخرى، عن طريق تحليل يسمى “منطقي”. بمعنى أن إتباع قواعد معينة للاختبار يمكّن من إعادة تكوين مسلمة ما، المشروطة بفرضيات معينة والتي سبق إعطاؤها (اعتباطيا) قيمة “صواب”. لكن اعتباطية الحقيقة لا تنمحي البتة: إنها احتمت في اختيار مبدئي، المتعلق بمنطق ما. المنطق الجد كلاسيكي، والذي أصبح المعنى المشترك لدينا، يقر من بين ما يقر به، بأنه إذا كان (أ) يساوي (ب)، و(ب) تساوي (د)، فإن (أ) يساوي (د)*. كان بالإمكان تحديد بشكل آخر. تعمل بعض المنطقيات الجد ” فاعلة” بواسطة قواعد أخرى. في البيولوجيا، معطيات الاختبار تجريبية وليست منطقية. تكمن اعتباطية الحقيقة البيولوجية إذا في اختيار هذه المعطيات، الخ.












