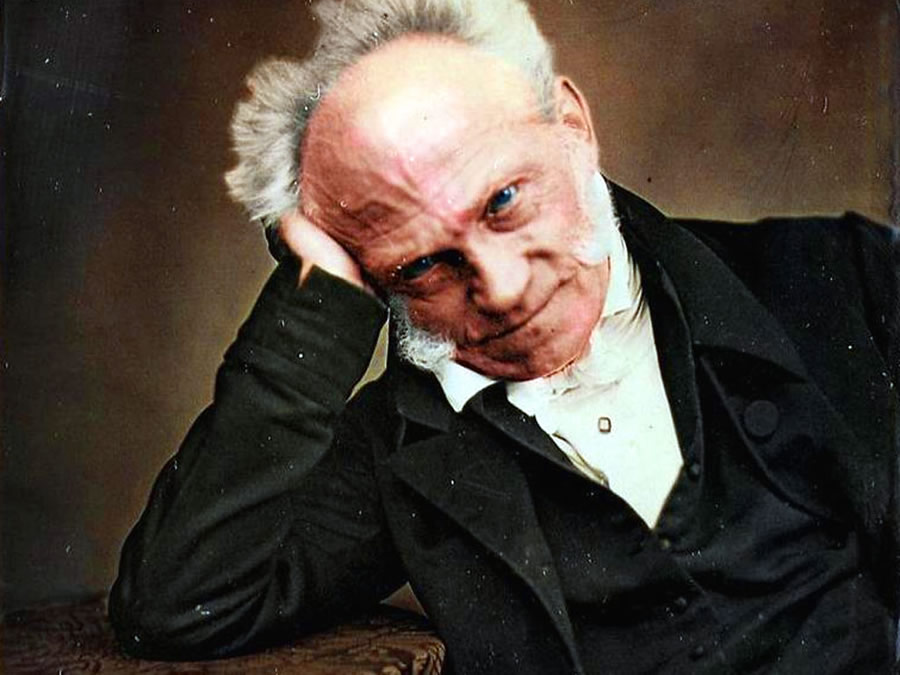الإلحاد الإبستمولوجي، ويُعرف أحيانًا بـ "اللاأدرية الإبستمولوجية"، يمثل توجهاً فلسفياً ينكر إمكانية الحصول على معرفة يقينية حول المسائل الميتافيزيقية، وبخاصة وجود الله. ينبثق هذا التوجه من مجموعة من الأطر الفكرية التي ظهرت في سياقات تاريخية مختلفة وأُثرت بفعل التيارات الفكرية التي اهتمت بالنظرية المعرفية (الإبستمولوجيا) وتطور العلوم، بالإضافة إلى نقد المعتقدات الماورائية.
و يُعرّف الإلحاد الإبستمولوجي كفكرة فلسفية تشكك بقدرة البشر على معرفة أو الوصول إلى حقيقة وجود الله أو الغيبيات عمومًا، فهو يرتبط باللاأدرية أكثر من الإلحاد بمعناه التقليدي، إذ ينصب التركيز على محدودية المعرفة البشرية وقيودها.
الجذور التاريخية والفلسفية للإلحاد الإبستمولوجي
ظهر الإلحاد الإبستمولوجي تدريجيًا مع تطور الفكر الفلسفي الغربي، ويمكن إرجاع جذوره إلى العصور القديمة، حيث بدأ الفلاسفة يناقشون حدود العقل والمعرفة البشرية. لكن الانتقال إلى موقف إبستمولوجي صريح حدث في الفترة الحديثة مع ظهور عدد من المفكرين الذين شككوا في قدرة العقل البشري على معرفة حقائق ميتافيزيقية نهائية.
1. الفلسفة الإغريقية والرومانية القديمة
بروتاجوراس والسفسطائيون: كانوا من أوائل المفكرين الذين قدموا أفكارًا حول نسبية الحقيقة والمعرفة البشرية، حيث ادعوا أن المعرفة لا يمكنها تجاوز نطاق التجربة الشخصية والمباشرة.
أبيقور: أبدى رؤية طبيعية بحتة للعالم واهتم بشرح الظواهر الطبيعية بدون اللجوء إلى الميتافيزيقا. وعلى الرغم من أنه لم يكن ملحدًا، إلا أن رؤيته العلمية الصارمة أثرت على النقاشات اللاحقة حول حدود المعرفة البشرية.