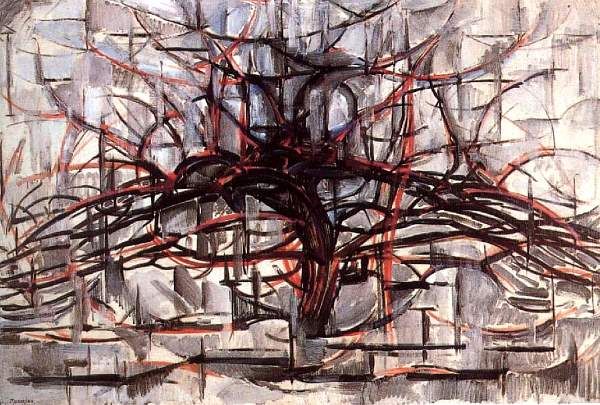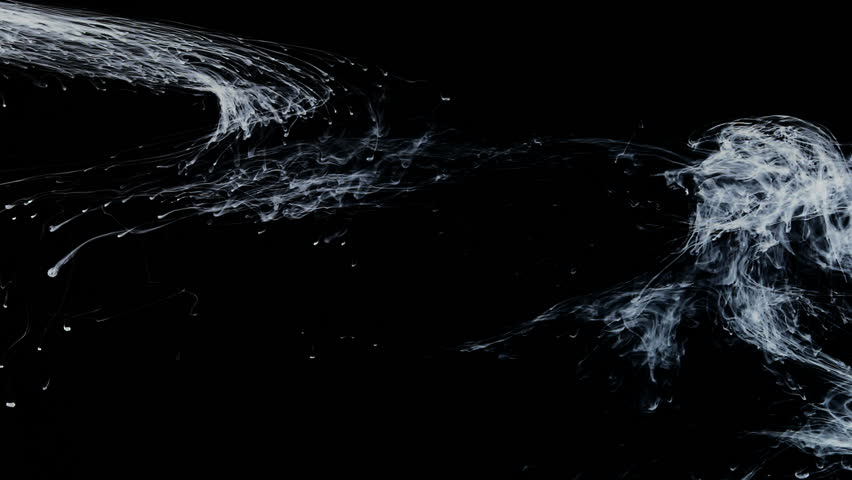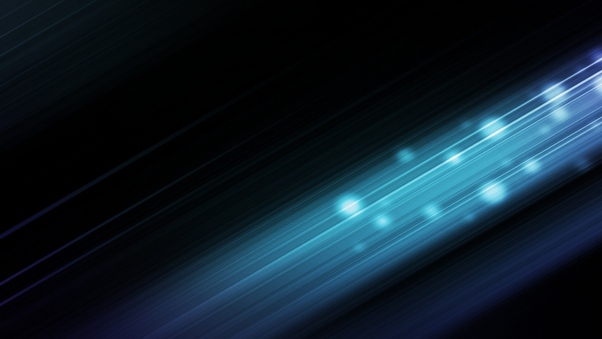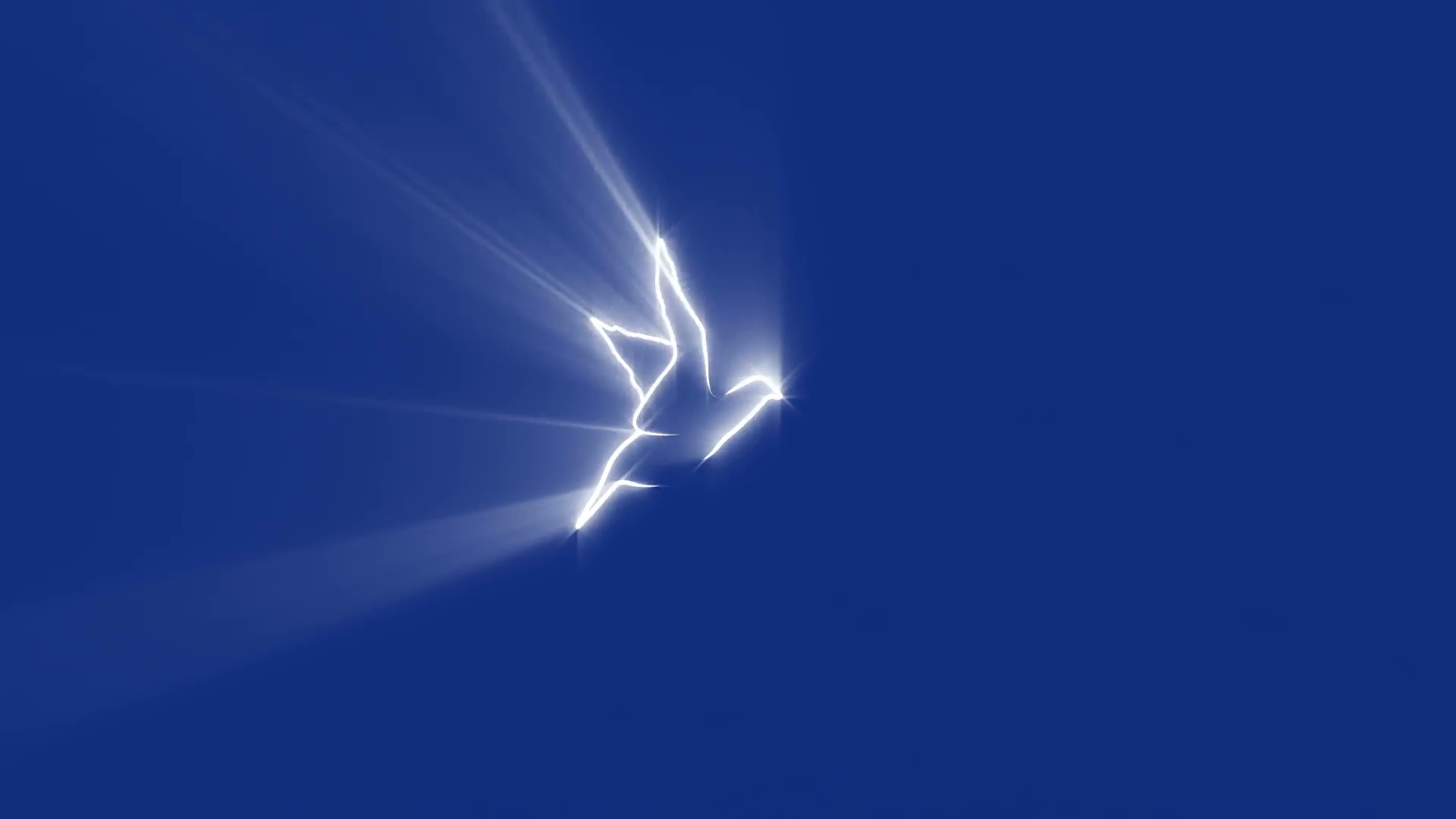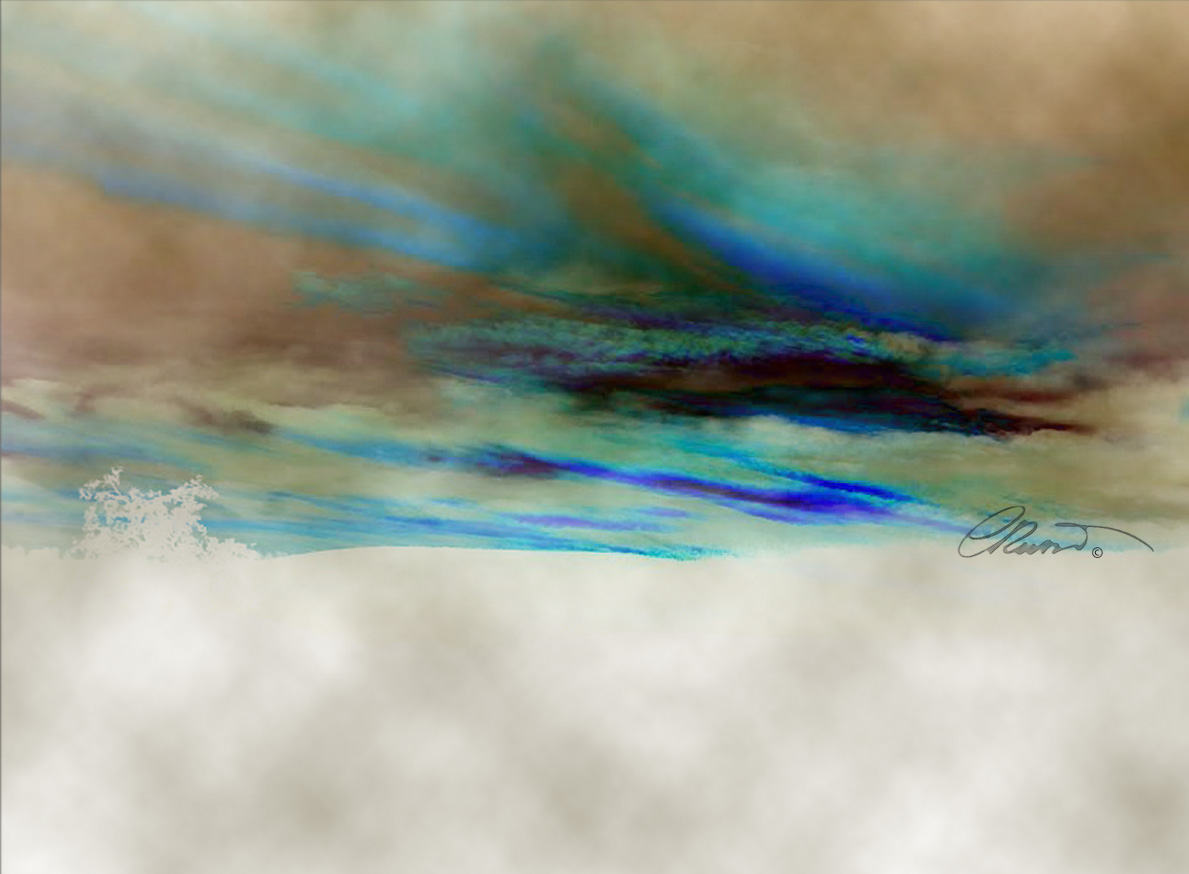كنا في عصر " ذوبان الثلوج " حيث فتحت نوافذ في الستار الحديدي لتهب منها رياح التغيير والتجديد في المجتمع السوفيتي . التغيير والتجديد كنت تحس بهما في مكتبة الأدب الأجنبي في موسكو تحديدا ، أكثر من أي مكان آخر في الإمبراطورية السوفيتية ، حيث تجد فيها آخر إصدارات الكتب والمجلات الأجنبية ب(140) لغة أجنبية ، وأرشيف ضخم للأدب العالمي والمعرفة الإنسانية .
كنت أزور هذه المكتبة كلما سمح لي الوقت بذلك . وكنت أنتهز يوم التأهيل العسكري للطلاب السوفيت - وهو يوم واحد في الأسبوع كان يخصص بأكمله للمحاضرات النظرية والتدريبات الحربية لزملائنا السوفيت ، ولم يكن يشمل الطالبات السوفيتيات والطلبة الأجانب ، وكنا نعتبره يوم عطلة لنا - لزيارة المكتبة ، واقضي فيها ما لا يقل عن ثلاث أو أربع ساعات في كل مرة ، طوال فترة إقامتي في عاصمة الثلج والأدب والفن والحب.
ميلاد فيلسوف الفراغ – قصة : كمال يحيى بربوش
شب حريق في الحقل المقابل لحينا ذات يوم من ايام الصيف القائظ .كان حقل الشعير عاريا إلا من بقايا تبن يابس ينتظر أن تلتهمه غنم صاحب الحقل و حبات شعير متناثرة كنا نلتقطها من الارض لنطعم بها حمام البيت و صغاره. وكان حقل الشعير ملاذنا من قسوة الحياة التي لم تمنحنا سبل العيش و وسائل اللهو، فكنا نستغل فضاء الحقل لنرتع و نلعب و لنصنع لعبنا بخشاش الأرض و قصب وادي كيس القريب من حينا.
الشجرة الصعلوك – قصة : العياشي ثابت
مفتولة الأغصان مثل عضلات مصارع السومو، تعددت فروعها وتشابكت تشابك عراك خانق، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، حتى بدت للصغيرة نانا في صورة صعلوك يتوسط الحديقة، ويمعن فيها فتكا وتخريبا وإتلافا... أو هكذا تخيلته. فقد كانت تمقت العابثين بنباتات الحديقة وأغراسها، وتعتبر أفعالهم المقيتة من وسوسة ذلك الصعلوك الغريب.
تناسلت بمخيلتها عشرات الأسئلة المحيرة، تحرج بها والدها الحكيم، الذي ما فتئ يجتهد في الردود كي يشبع فضولها...
الغرفة السوداء – نص : أسماء العسري
من داخل كل شخص هناك غرفة سوداء، قبو حُكِمَ عليه بتخزين ما خلفه الزمن فينا من لعب و مستلزمات الأثاث، ورسائل عِشقنا المنسية، وصور أحبائنا، و أقداحنا المكسورة.
ليس العيب فينا و لا في زماننا، و لكن أواننا لم يحن بعد لذلك الحب، لذلك صنعنا غرفة سوداء داخل قلوبنا أو في أحد أركان بيتنا، الأهم أنها غرفة سوداء ليست لوناً، بل طِلاءاً، طلاؤها وردي أو أحمر أو أصفر... كل الألوان مسموح بها في عوالمنا، المهم أنها تختلف في نظر عشاقها، فلكل عاشق لونه المفضل ليس الأحمر بالضرورة، نظراً لما يُسبغه عليهم من جو رومانسي يهز تحجُر قلوبهم، سوادها اللاوعي الذي سكن فينا و يخرج في زلات لساننا أو في أحلامنا، يطلب مكانا للعيش ولو بمقياس خُرم إبرة، فهل من مُجيب، لنواجه انكساراتنا وخيباتنا، أم سنرضى بالعيش باللاوعي على أساس أنه الوعي، وعينا هذا صفاء لدموعنا من مرارة الاستسلام و البكاء على الأطلال.
الوجه الآخر ـ قصة : العياشي ثابت
في صدر الخيمة الفسيحة ذاتَ عزاء، اقتعد "باعزوز" ذو السبعين عاما أو يزيد كرسيا، في جلسة تحيل على نخوة الزمن الجميل، وهو يجيل بصره بين الداخلين والخارجين، ويتفرس وجوه شبان مختلفين عما عهده من أبناء جيله: كانوا حليقي الرؤوس بأشكال غريبة ودهون وطلاءات تغطي وجوههم ورؤوسهم، وتلمع في أصابعهم الخواتم وفي أعناقهم السلاسل...
تحدث إلينا وهو يغمز من قناة الشبان قائلا: لقد كان من عادة القبائل في زماننا، كلما حلت أيام التشريق والأضاحي، أن يلاعبوا بعضهم البعض لعبة " الجلود" حيث يعمد شباب قبيلة ما، للهجوم المباغث على قبيلة أخرى، فيخطفون منهم جلود الأضاحي. وعادة ما يتم الهجوم على متن خيل أو بغال. ومتى تمكن المهاجمون من الفرار، أقاموا لذلك حفلات رقص وغناء، يتباهون بها إزاء القبيلة المنكوبة. فإن سقط أحد المهاجمين بيد الأهالي، فإن قواعد اللعبة تقتضي أن يجعلوا منه مثار نكبة واستهزاء للقبيلة الغائرة، إذ كانوا يلبسونه لباس النساء، ويغدقون عليه المساحيق من كحل وسواك وحناء، ويزفونه للقبيلة مثل عروس على ظهر بغلة عرجاء... وعادة ما تلاحقه تلك الشتيمة طول حياته...
عذرًا يا حمامة – قصة: أحمد العكيدي
حمامة بيضاء تتنقل من غصن إلى أخر، تعزف أحلى الألحان وأشجاها، ترقص أجمل الرقصات وأروعها، ترسم لوحات الحب على إيقاعات نسمات الرياح الهادئة، تسبح في الفضاء بدون هموم تثقلها...
توقف عن الكتابة فجأةً وأخد يعبث بقلمه، تارة يمرره من يد إلى أخرى بخفة ويدحرجه على الطاولة تارة أخرى، ثم تأمل أخر ما كتب :بدون هموم تثقلها.
رفع رأسه وتتبع حركاتها حتى سكنت واستقرت على جدار يقابل غرفته، استمع من جديد إلى هديلها كأنه يسمعه أول مرة، تصورها تعزف سمفونية الحب لحبيبها حينا وتشتكي حزنها ورتابتها أحيانا، ربما تفكر في الغد المجهول أو في الماضي القريب...
الواقع و السراب - قصة : رشيد بلفقيه
استفاق ، أو هكذا بدا له ، استغرق عدة لحظات ليتذكر أنه على موعد لاجتياز مقابلة أخرى من أجل وظيفة معينة بتوصية ما .
غسل سحنته الداكنة و بالكاد انتبه إلى أنه لم ينزعج من برودة الماء رغم البرد القارس . وصل في الموعد المحدد بالثانية ، وتوجه مباشرة إلى أول موظفة وقع عليها بصره ، كانت تجلس خلف مكتب منظم بشكل أنيق ، سرد لها سبب حضوره بدون مقدمات طويلة ، كانت تستمع إليه و هي تشتغل على مجموعة من الأوراق أمامها كانت جميلة ، و مع ذلك لم يقف طويلا عند هذا التفصيل ، خاطرة ما أوحت له بأنها تشبه الغزال تماما ، جميلة و لكنها هادئة أكثر من اللازم بل هادئة بشكل يدعو للتخمين أنها متبلدة الفكر ، لا شيء يمكن أن يعلق بالفكر بعد الحديث معها سوى الجمال الخارجي ، هذا ما أخبرته به نظرتها الساهمة . حولته بأقل مجهود إلى مكتب يوجد في طابق آخر .
قصة حياة – نص : امل عبدربه
منذ انعتاقي من عتمة العدمية
ومنذ علمي بأني كائن يدعى الانثى
وأنا اتلمس الظل
كي لا أسير في جنازة الوقت وحدي
عند منتصف الليل، أسرجت قنديل العودة. خضت بحار الوهم زمنا ثم عدت خالية الوفاض كما ذهبت.
وها أنا هنا، اخيرا عدت إلى محطتي الأولى في الحياة، مسقط رأسي.. بعد عذاب دام لأعوام في غربة قُدّرَ لي خوضها رغما عني.. عربة أرادها رجل لنفسه وأبى حظي إلا أن اشاركه حلمه.