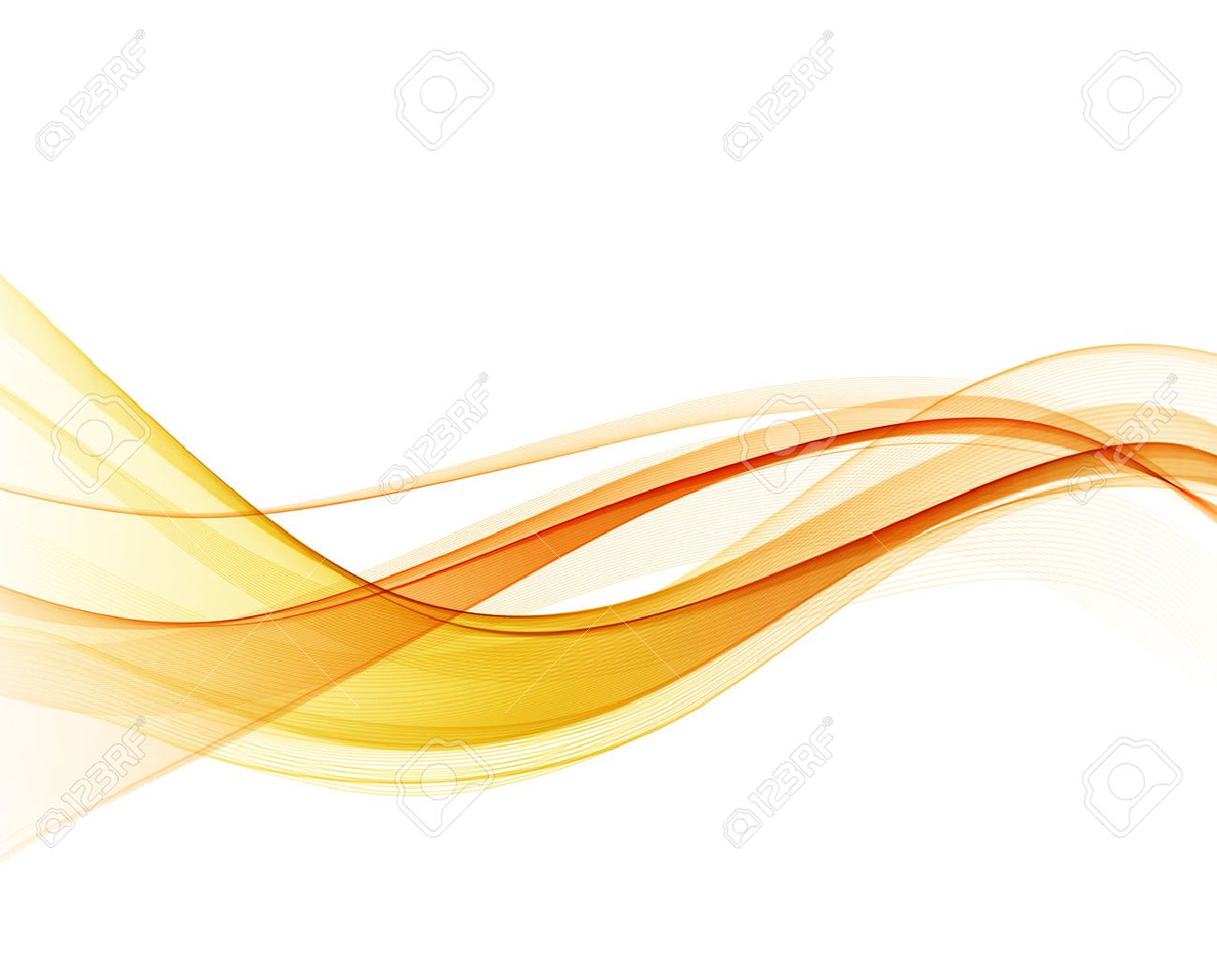دور المثقّف عضويٌّ ؛ ذلك ما سطَّره في القرن التاسع عشر المفكر الإيطالي أنطونيو غرامْشي . فالإبداع ، عموما ، هو الوجودُ في أبهى صوره . بموازاة ذلك فهو يأخذك، عن طريق الحلم و التخييل و الرؤيا ، إلى عوالمَ متعددةٍ ، و ترشِف من تجاربَ مختلفةٍ ، وأخيرا يمنحك طعم الوجود . علاوة على ذلك ، فهو يتسلل خِلسة ليعانق المحاكاة لشيء موجود . فعندما يبدع القاص قصة ؛ فهو يتغنى بواقع قد يكون موبوءا أو مثخنا بالجراح . فإبداع قصيدة ، مثلا ، مدعاة لمحكاة أصوات و غناء هو أصلا موجود في الطبيعة . إلى جوار ذلك، في الأدب العربي القديم ، سنجد الأعشى كان بارعا في الغناء ، بصوته العذب الرخيم ؛ ونتيجة لذلك عُرف بصَنُُّاجة العرب . يستخرج من القصيد أوزانا ، ويرددها بشكل طروب...
إن الأذن العربية ، كما هو معروف ، ألفت الموسيقى من خلال توليفات شعرية ؛ فحيثما وجد البديع والمحسنات البديعية ... وجد الغناء . فكثيرة هي القصائد المغناة من الشعر القديم و الحديث ... أطربت أجيالا و أجيالا ، وبصمت الأذن العربية بالفن الرفيع . فيها يسمو الذوق بألحان ممشوقة ، وبكلمات تغوص في الوجدان ، حافرةَ أخاديدَ من التأمل والمتعة معا . فقصيدة " دعوه ... مبذرا " لأبي الطيب المتنبي من الكامل ، غنَّاها الفنان البحريني المتميز أحمد الجميري ، والتي مطلعُها :
بأبي الشموسُ الجانحاتُ غواربا اللاَّبساتُ من الحرير جلاببـا
المنهباتُ عقــــولنا و قلــــــوبنـا وجنــاتهن الناهبات النـاهـــبا
إرهاصات الجدة والابتكار في قصص "ذات الوجه الطويل" ـ عبد النبي بزاز
بإصداره لأضمومته القصصية الثانية "ذات الوجه الطويل" يراهن القاص مصطفى الطاهري على رسم مسار كتابة سردية تروم المزاوجة بين نمطي القصة القصيرة والقصيرة جدا. فبعد أن تضمنت مجموعته الأولى "حين بكى الحصان" قصصا قصيرة جدا حبلى بتنوع وتعدد "التيمات" في أبعاد دلالية وجمالية تمتح من مرجعيات تاريخية ووجودية ودينية وفكرية ... متوسلة بلغة قوامها الاقتصاد و الاختزال بحمولات مرتهنة لحس رؤيوي تنتأ إرهاصاته وتتمظهر تجلياته عبر أشكال إيحائية وتلميحية تقتضيها طبيعة أجناسية النصوص( قصيرة جدا) بكثافتها اللغوية وومضاتها الدلالية لتنضاف المجموعة القصصية الثانية "ذات الوجه الطويل" بإرساء أواليات سيرورة قصصية تتغيا الإضافة والتطوير عبر نصوص قصصية قصيرة تستحضر فيها الشخوص والأحداث بشكل أوفر وفي حيز أرحب لرسم معالم عوالم سردية مشرعة على آفاق ممعنة في الاستعصاء والالتباس تستدعي التسلح بعدة من أسئلة تروم الاكتشاف والاختراق من خلال اجتراح عتبات مدخلاتها والخوض في غمار أكماتها وامتداداتها.
فنصوص مجموعة "ذات الوجه الطويل" تمتح من مرجعيات يطبعها التنوع والتعدد عبر الاستحضار والاستشراف بنفس سردي يتوسل بالوصف: " ظهرت قربته تتدلى من جنبه كبطن بقرة"، و" شمس حمراء ذابلة..." مما يمنح النصوص زخما زاخرا بأبعاد جمالية ودلالية تمعن في إيحاءات غنية بحمولات متعددة المرامي، متشعبة المقصديات ديدنها الاكتشاف والاستشراف المدجج بهواجس البحث وقلق السؤال: "أين بنوها؟ أمن حجر؟ أمن خشب؟"، و" ومن بعد خمسين عاما أحس بأني أسافر ضد البلاد..." لتأخذ منحى أكثر عمقا وثراء بتشكلات رمزية وتشعبات مسلكية: "تنحدر ببطء نحو خباء من ورق مقوى".
محمود رأفت ورقصته على( شبر مَّيه) ـ ممدوح مكرم
قليلةٌ هي العناوين التي تشد المتلقي؛ خاصةً في زمننا الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، والغث بالسمين، والمزيف بالحقيقي؛ وذلك مرتبطٌ بغيابِ حركة ٍنقدية ٍحقيقية ٍتؤطرُ للإبداع وتحاول أنْ تواكب هذه الكثرة على الساحة الأدبية وبشكل خاص على مستوى قصيدة العامية.[ رقصة على شبر ميَّه] عنوان ديوان للشاعر: محمود رأفت ابن محافظة الدقهلية، ومحمود رأفت شاعر في عقد العشرينات من عمره، ولكن رغم ذلك هو صاحب تجربة فريدة في قصيدة العامية وفي الرسم، إنه شخصٌ متعدد المواهب. تتميز قصيدة محمود بخفتها ورقتها وشجونها وآلامها، وكذلك بإيقاعها وموسيقاها الصاخبة أحيانا كثيرة، هي قصيدةٌ غنائيةٌ أيضًا، قصيدة محمود تعكس توترنا في زمن العولمةِ، وزمن اللامعنى، تعكسُ هذه المسوخ التي تحيطُ بنا، ولذلك تأتي أحيانا قصائد حادة أو عبثية، أو حتى ساخرة بمنطق عبثي ٍ لا مبالي، من يتابع محمود سيدرك ذلك.
وديوان [رقصة على شبر ميَّه ]هو ديوان فاز بجائزة الشهيدة شيماء الصباغ (الجائزة الأولى للإبداع الشعري في العام 2016م) وصدر عن ك ت ب للنشر، ودار ابن رشد، وصدر الديوان عام 2017م، ويضم الديوان 33 قصيدة ( ليست مرقمة أو مفهرسة). و العنوان لافتٌ وجاذبٌ للمتلقي( لذلك قلتُ في البدء: قليلةٌ هي العناوين التي تشد المتلقي) فماذا عن الرقص؟ وحتى ندلف إلى الديوان يجب أنْ نكونَ ماهرين في الرقص، خاصة إذا كان الرقصُ على شبر ماء، الموضوع سيكون أصعب كثيرا!!
كتابة الأوليبو: أهي شعر الرياضيات أم رياضيات الشعر؟ ـ أبو إسماعيل أعبو
يؤشر هذا السؤال المركب، على كتابة غربية حداثية، ترتهن في سيرورة اشتغالها، بضديدين يتلابسان فيها، إلى الحد الذي يتباعدان فيه عن حديهما، ويعدلان عن قصديهما.
أولهما، الشعر الذي يخرج عن كيانه الرمزي، ونسقه الإبداعي الإلهامي، ويتجرد من رعشته الجوانية، ويطرح عنه ثراءه الذاتي.
وثانيهما، الرياضيات التي تخرج عن تجريديتها المنطقية العقلية، وانضباطها الموضوعي، وتطرح عنها صرامتها العلمية النظرية.
فهما ضديدان تترتب عنهما، في تلابسهما النصي، احتمالات تسرد لغوي رياضي غير متواتر، فيه من التنوع النسقي ما لم تعهده الكتابة من قبل، فعن تراكبهما ينتظم الشعر تبعا لإجراءات رياضية تبديه لعبة دلائل، التي تؤول به في حركية استرسال الدوال والمدلولات إلى أنساق لغوية مشحونة باللامنتظر، فيكون الهاجس المحرك آنئذ هو "تنصيص" الرياضي ضمن كتابة شعرية تنتظم في اشتغالها وفق إجراءاته، وتختلق لذة لعبية، تستغرق الكاتب، وتأخذ بذهن المتلقي بمتعتها وبتنوع احتمالاتها.
نحن بهذا المنحى الذي يتوالج فيه الشعر مع الرياضيات، إزاء سؤال ينسحب على كتابة، تنم عن استراتيجية لعبية، يتلابس في صميمها النسبي بالإطلاقي، والذاتي بالموضوعي، والمعرفي بالتمرني، والتأويلي بالوصفي تلابسا يحدو بها إلى ارتياد أفضية كتابة الغرابة.
فإلام تنسب هاته الكتابة؟
محمد أنقار و التحليل النصي للكون الأدبي ـ الصادق بنعلال
" أبرزت التجارب النقدية العميقة أن التحليل هو محك كل ادعاء نقدي على أساس أن يكون التحليل مقنعا و منسجما " : محمد أنقار
الأدب و تعميق الوعي الإنساني :
شهد النقد الأدبي العربي في الثمانينيات و التسعينيات من القرن العشرين صحوة بالغة الأهمية ، بفضل انفتاح الدارسين و المعنيين بمقاربة المعطى الأدبي على الفكر النقدي العالمي ، و نجاحهم في أكثر من محطة في التوفيق الإيجابي بين ما زخر به تراثنا الأدبي من رؤى نقدية راجحة و بين اجتهادات إنسانية معاصرة ، توخت الانتقال بالمنجز النقدي من وضعية التناول العفوي و ربما الذاتي إلى وضعية النزعة العلمية العقلانية ، و في هذا السياق هيمنت في هذين العقدين الساخنين تيارات نقدية رامت ملامسة نصية العمل الأدبي " داخليا " ، و ذلك بالانطلاق من " قناعة " مفادها أن العمل الأدبي شعرا أو سردا أو مسرحا يكفي ذاته بذاته ، و بالتالي فإن مهمة النقد الأدبي تنحصر في الغالب في استجلاء " أدبية الأدب " أي المكونات الأدبية الثابتة في النصوص الإبداعية ، ابتداء من مساهمة الشكلانيين الروس و مرورا بالجماعات النقدية البنيوية و النزعات السيميائية و التفكيكية .. و لئن كانت مختلف هذه الجهود المعرفية قد استقرأت جل الآليات المتحكمة في التكوين و التكون الأدبي الداخلي و بشكل يثير الإعجاب ، إلا أنها ظلت دون مستوى تطلعات النقد الأدبي بحصر المعنى ، ذلك النقد الذي لا يقبل الاقتصار على إعادة بناء جزئيات النصوص و الدوران في محراب هيكلها الثابت ، بقدر ما يروم محاورة الإبداع الأدبي لتعميق الوعي البشري بوجود الإنسان و العالم المحيط به . و لعل الناقد المغربي محمد أنقار ( 1946 - 2018 ) من النقاد العرب القلائل الذين كانوا مدركين لمخاطر المواكبة غير المحكمة للمناهج النقدية الحديثة ، و المبالغة في القراءة المبتسرة للإنتاج الأدبي .
مُدن من الكلمات أو : بيان مانغويل ضد التعصب ـ حميد بن خيبش
لاشك أن التعصب، بمعناه الإيجابي الذي يحيل على الاعتزاز و الاستعلاء، هو أحد البُنى الكامنة في أعماق كل جماعة بشرية. وقد يشكل وقودا للتضحية و البذل والريادة. إلا أن المشكلة تكمن في تغلب جانبه السلبي، واستهدافه العلاقة مع الآخر. لذا من الطبيعي أن يرتبط المفهوم ذاته في أذهان الناس بصور التحامل و الإقصاء، وطغيان الدم لغة وحيدة لتأكيد الذات.
بخلاف الباحثين الاجتماعيين، يقدم "القارئ" والمؤلف الموسوعي ألبرتو مانغويل نهجا مغايرا لتناول قضايا الهوية والتعصب، ورصد سبل التعايش واحترام التعددية الثقافية. حيث تسمح الرحلة إلى عالم الكلمات والقصص، ومتعة الإنصات إلى الروائيين و الشعراء باستعادة المفاتيح المخبوءة في دولاب الفكر و الأدب، لتبديد سوء الفهم، وتدشين سلسلة من القراءات المتجددة لتمتين الرابط الإنساني.
يقدم مانغويل عبر (مدينة الكلمات) تجربته الخاصة في محاولة تهدئة العالم عن طريق الكلمات، ومنح اللغة الإبداعية فرصة تجميع هوياتنا المشوشة و الحائرة. من يدري؟ فقد تنجح القصص في مَدنا بالقدرة على احتمال العيش المشترك وتغيير العالم !
تجربة المنفى طورت إدراك الروائي الألماني ألفريد دوبلن للغة لتصبح أداة تعيد صياغة الواقع وفهمه. إنها صيغة من حب الآخرين الذين لا نحتاج إليهم قطعا كي نتنفس، لكننا بحاجة إليهم للتحدث !
في حب العقاد: قيم خالدة في ذكرى رحيله الرابعة والخمسين ـ إبراهيم مشارة
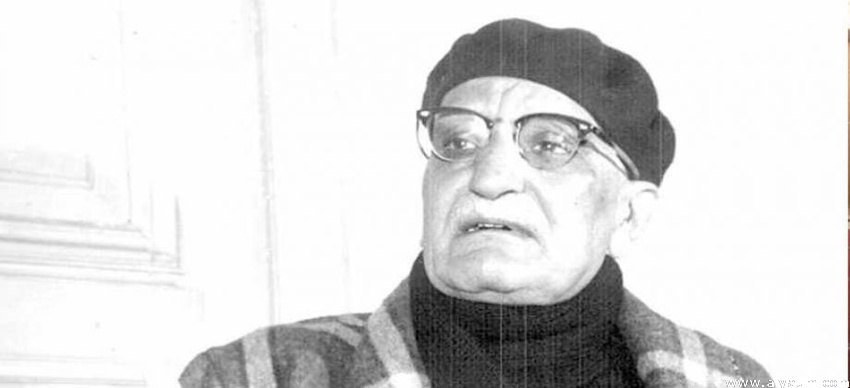 إذا شيعوني يــــــــــوم تقضى منيتي
إذا شيعوني يــــــــــوم تقضى منيتي
وقالـــــــــــوا أراح الله ذاك المعذبـــــــــا
فلا تحملوني صامتين إلى الثرى
فإني أخاف اللحد أن يتهيــــــــــبا
وغنوا فإن الـــــــــــــــموت كأس شهية
ومــــــــــازال يحلو أن يغنى ويشربا
ولا تذكروني بالبـــــــــــــــــكاء وإنما
أعيدوا على سمعي القصيد فأطربا
وصية العقاد لمشيعي جثمانه
رحل العقاد الجبار في آذار من عام 1964 ومن عجائب الأقدار أن يكون يوم دفن جثمانه بمسقط رأسه أسوان هو يوم 13 مارس هل غلب الرقم 13 العقاد الذي تحدى مظاهر الشؤم ومنها الرقم 13 نذير الشؤم والنحس؟ العقاد الذي يعيش بعقل الناقد والممحص وبروح الاستعداد والمواجهة بارز حتى هذا الرقم لا مبارزة دونكشوت لطواحين الهواء لكن بفروسية أبي زيد الهلالي فسكن في البيت رقم 13 بشارع السلطان سليم بمصر الجديدة واختار يوم 13 لإعادة بناء بيته القديم بأسوان هل هزمه هذا الرقم ؟ كلا وإنما هي محض مصادفة.
وحدة الرّؤية الفكرية والصياغة الفنية في تجربة محمد زفزاف القصصية :قصّة " أطفال بلد الخير "أنموذجا - عاتق نحلي
يكثف عنوان القصة الأولى" أطفال بلد الخير"لمحمد زفزاف الواردة ضمن المجموعة القصصية الموسومة ب "العربة " مضمون القصّة نفسها ،وقد تختزل دلالته الرؤية الفكرية للكاتب المتحكمة في المجموعة ككل.
جاء عنوان القصة تركيبا اسميا ف"أطفال " مبتدأ ،وهو مضاف ،و"بلد" مضاف إليه و"الخير "مضاف إليه كذلك .في حين أنّ الخبر يمكن تقديره انطلاقا من القصة ذاتها ب "جائعون ".
نلاحظ أن كلمة (أطفال)معرّفة بالإضافة ،وليس بأل ،وهناك فرق دلالي ينتج عن حالتي التعريف هاتين .فالتعريف بأل يضفي على المعرّف سمة التّحدد والتعيّن من تلقاء ذاته .أمّا التعريف بالإضافة ،فينزع عنه هذه السّمة ؛إذ يجعله مفتقرا إلى غيره ،كافتقار (الأطفال )إلى خير (البلد).
إنّ العنوان يصوّر البلد كرقعة جغرافية مفتقدة لأي بعد إنساني ،فالبلد مجرّد وعاء لا غير بالنّسبة للأطفال الذين لا حق لهم في خير بلدهم .
وتتضح دلالة تعريف البلد بالإضافة عند مقابلتها بدلالة تعريف كلمة الخير.،فتعريفها بأل يدل على التّحدّد والتّعين ،فخير البلد إذن ،حقيقة ثابتة.وإذا كان الأطفال لا يستفيدون من ثرواته ،ويتضح ذلك من قول السارد :"وهناك ثلاثة أطفال بعيدون عنه بعدّة أمتار يتحرّشون به ،وهم يأكلون قشور البرتقال[1]".ويعانون من الجوع "لكن مع ذلك فالخير موجود ،وبالرّغم من أنه موجود ،فقد كان الأطفال خلف الضاوية جياعا [2]".
إن هناك من يحرم الأطفال الثلاثة من إشباع جوعهم ،ويستفيد من إبقائهم على الطوى ،وهو ليس فردا ،بل طبقة اجتماعية ،مستغلة ترمز إليها القصة ب "الفيلات "
نقف بدءا من العنوان إذن ؛على موضوع القصة .بما هو تصوير لواقع الصراع الطبقي بالمغرب.
-في المتن :
تصوّر القصة صراع الضاوية من أجل العيش ،وذلك من خلال بيعها للبرتقال،و تحملها مسؤولية تربية ابنها تربية صالحة بمقاييسها الخاصة ،هكذا تجهد نفسها لثنيه عن مرافقة أطفال الشارع ،هؤلاء الذين يتضورون جوعا ؛مما يدفع بهم إلى التخطيط لسرقة بضع ليمونات من ليمون الضاوية .وحين يغير القمع على الباعة ،وتفرّ الضاوية تاركة وراءها ما تبقى من سلعتها البرتقالية ،يتعاورها أطفال الشارع ،ويشرعون في التهامها غير عابئين بما يدور حولهم.