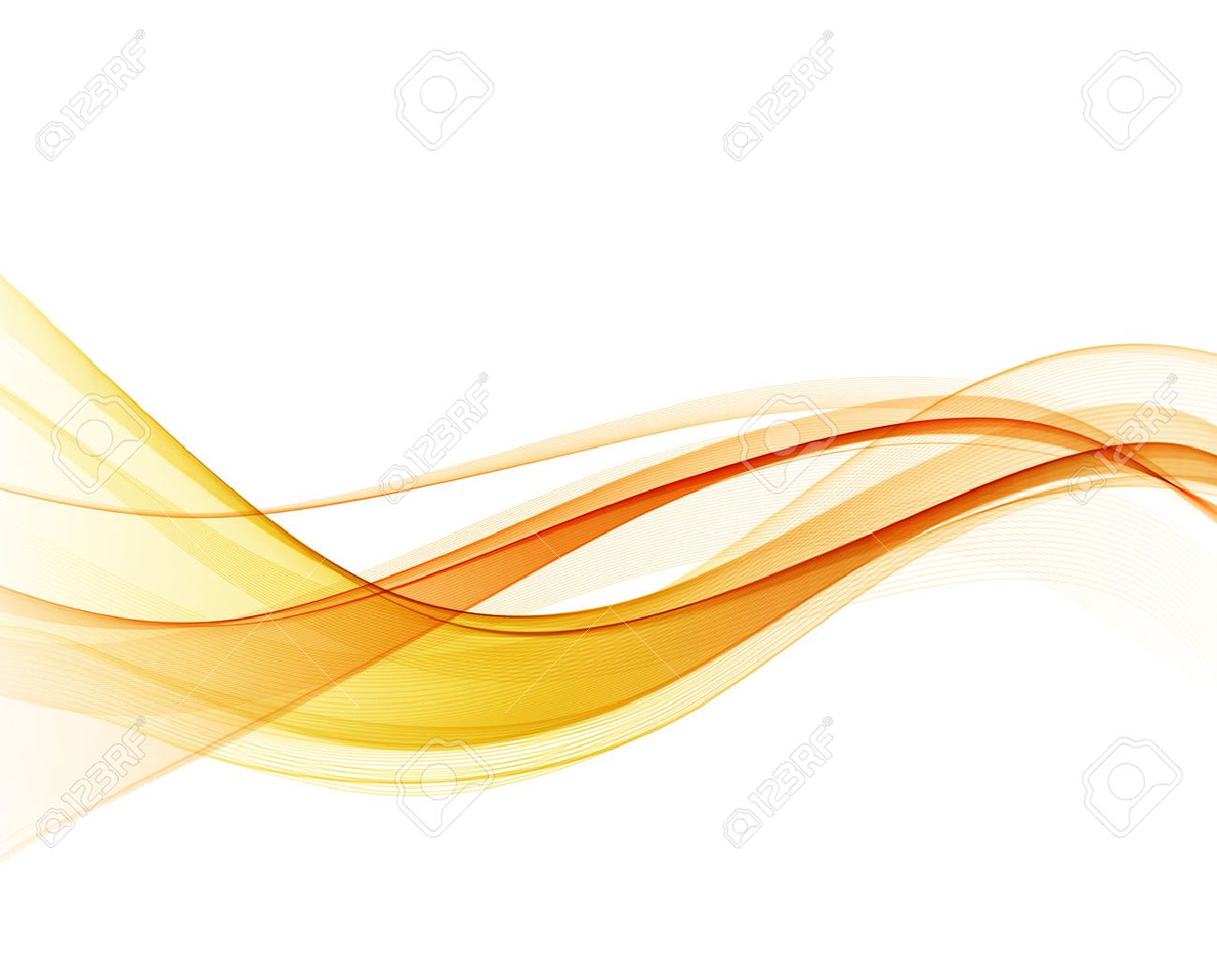يمثل الشاعران الكبيران أبو القاسم الشابي وبدر شاكر السياب علامتين فارقتين في أدبنا الحديث، فقد حققا من النجاح وأحرزا من التفوق مالم يحرزه شاعر آخر على الرغم من حياتهما القصيرة فقد ولد الشابي بقرية الشابية ناحية توزر عام 1906 وتوفي عام 1934، بينما ولد بدر شاكر السياب في جيكور قرب البصرة عام 1926 وتوفي بالكويت عام1964 .
وكأن الرسالة التي بدأها الشابي منضويا تحت جناح جماعة ” أبولو ” التي أسسها الدكتور أحمد زكي أبو شادي، كانت تلك الرسالة تحمل هم التجديد وقلق الإحياء وهاجس البعث لأدبنا العربي بعد أن نام أحقابا طويلة في مغارات التاريخ مغمضا جفنيه عن مباهج الحياة، مخلصا ضميره من هم النهضة والتقدم مكتفيا بالإجترار والتقليد والرياء والتصنع وفي تصيد الولائم والمناسبات ومباركة السلاطين والأمراء.
كان شعر الشابي الذي يوحي عنوان ديوانه بالحركة والنماء والخصوبة” أغاني الحياة ” كما يوحي بالبهجة والفرح والتبشير بقيام طائر العنقاء من رماده صحيحا معافى.
مفهوم الأدب الإسلامي بين الرفض والقبول: مقاربة تحليلية نقدية ــ محمد سمير سرحان
لقد أصبح مفهوم الأدب الإسلامي مفهوما مرفوضا لدى بعض النقاد الأدبيين الذين يرون أن وصف الأدب بالإسلامي يجعله يحتكم لعدة قيود وقوانين تنفي عنه إبداعه الفني والأدبي، وهذا الصنف من النقاد قد انقسم إلى قسمين اثنين:
قسم أول؛ يرى أن مفهوم الأدب الإسلامي يضع القيود على الإبداع الفني ويجعل الأديب سواء كان شاعرا أم روائيا أم مسرحيا...، يلتزم بهذه القيود، ويخرج عن دائرة هذا الصنف كل من لم يلتزم أو كان ليس مسلما.
القسم الثاني؛ يرفض من أجل الرفض، يرفض كلمة "إسلامي" لأجل أنها نسبة للإسلام فقط، وليس من أجل الدافع المذكور أعلاه، ذلك أن هناك من النقاد من يرفض الإسلام كدين فما بالك بكون أن يجعل صنفا من الأدب ينتمي إليه ويسمى إسلاميا. وفي الغالب نجد هؤلاء لا يقبلون النقاش حول سبب رفضهم هذا، لأنهم وبكل بساطة لا يجدون مخرجا من المأزق الذي قد يقعون فيه أثناء نقاشهم حول قضية أدبية.
إن هذا الصراع القائم بين القبول والرفض يجعلنا أمام طرح إشكالي عميق تنتج من وراءه عدة تساؤلات حول مفهوم "الأدب الإسلامي" أبرزها، ماذا نقصد بالأدب الإسلامي؟ وهو سؤال جوهري، هل الأدب الإسلامي كل أدب ينتسب للإسلام، أم يمكن إدخال أنواع أخرى قد لا يكون أصحابها مسلمون؟
إننا قبل أن نقف عند مفهوم الأدب الإسلامي كصنف من أصناف الأدب الحديث والمعاصر، لا بد أن نقف عند مفهوم الأدب كمفهوم مجرد من انتسابه لأية جهة، فنرى ما تحمله الكلمة من معنى، لنرى بعد ذلك نقطة الالتقاء بين الاثنين، ثم نستأنف الحديث عن الأدب الإسلامي كمركب إضافي بما يحمله من معاني تفوق كل تلك الاعتراضات أو حتى القيود المزعومة التي وضعت له، والتي سنستعرض بعضها بإذن الله. لنبين للقارئ أن الأدب الإسلامي يفوق الوصف المتعارف عليه بين أصناف عديدة من الناس اليوم، سواء المؤيدين أو المعارضين لنقول، ماذا نعني أولا بكلمة "أدب"؟
الشاعرة اللبنانية فاطمة منصور... صور الإقامة بين معنَيَيْن ـ احمد الشيخاوي
هذه الفراشة تسبح في الضوء،و ما تنفكّ تجترح لذاتها حظوظا ضمن حدود الكتابة الأنيقة التي تنمّ عن صدق وحرارة التجربة،فهي لا تغري بالقول الشعري فقط، بل تمارس كتابة واعية تروم من خلالها مراوغة الأنساق وخوض مقامرات اللاشكل على نحو يضفي على بوحها شفافية وهشاشة آسرة لجوارح التلقّي،ممهّدة لصعقة المابعد،مُقَوْلبة تبعا لانسيابية إيقاعية تحاول تدشين صور الانتصار على الذات والغيرية والحياة.
راكمت فاطمة منصور نتاجات ضاجّة بتيمات الرومانسي مغلّفا بفلسفة تأويل منظومة مفاهيمية والج في جملتها الاستنطاق الهوياتي إذ يمتح من مرحلة قبلية يتحفظّ عليه إلى حدّ أقصى، واقع الحرب الأهلية،بما هو نظير أو محاكاة لثورة خفيضة تلبس حمّاها الذات الإبداعية،وتكرّس لانفلاتات هذيانية تجري على ألسن الحالة الواعية ، تجيء على مقاسات معاناة مختزلة تغذّيها كتلك خلفيات.
تعدّ مجموعة " من وحي القيود" باكورة شاعرتنا ،وهي بعتبة مزلزلة،لاشك، ومحيلة على أيقونة هواجس ودوال تفيد توريطنا بلعبة كلامية تتغيا انفتاحا كليا على معطى الحرية في أفق النسبية بالطبع.
إنها تفتح جرحا قديما بغرض التنفيس ،ومنح صياغات جديدة للمكون الماضوي، من شأنها أن تقحم الذات والآخر في مسرح استعراضي لتاريخ قد يعاقبنا على أخطائنا بالطبع، بقدر ما يتيح لنا مساحات للتملي وقطف الحكمة والعبر.
المثل في الأغنية المغربية ـ عبدالرحمان شباب
تعريف المثل لغة واصطلاحا:
في لسان العرب:
والمثل والمثيل كالمثل والجمع أَمْثالٌ، وهما يَتَماثَلانِ؛ وقولهم: فلان مُسْتَرادٌ لمِثْلِه وفلانةُ مُسْتَرادةٌ لمِثْلِها أَي مِثْلُه يُطلَب ويُشَحُّ عليه، وقيل: معناه مُسْتَراد مِثْله أَو مِثْلها، واللام زائدة: والمثل: الحديث نفسه.
وقوله عز وجل: ولله المثل الاعلى ؛ جاء في التفسير: أَنه قَوْلُ لا إِله إِلاَّ الله وتأْويلُه أَن الله أَمَر بالتوحيد ونَفى كلَّ إِلهٍ سِواهُ، وهي الأَمثال؛ قال ابن سيده: وقد مَثَّلَ به وامْتَثَلَهُ وتَمَثَّلَ به وتَمَثَّله؛ قال جرير: والتَّغْلَبيّ إِذا تَنَحْنَح للقِرى، حَكَّ اسْتَهُ وتَمَثَّلَ الأَمْثالا على أَن هذا قد يجوز أَن يريد به تمثَّل بالأَمْثال ثم حذَف وأَوْصَل
وامْتَثَل القومَ وعند القوم مَثَلاً حَسَناً وتَمَثَّل إِذا أَنشد بيتاً ثم آخَر ثم آخَر، وهي الأُمْثولةُ، وتمثَّل بهذا البيتِ وهذا البيتَ بمعنى.
والمثل: الشيء الذي يُضرَب لشيء مثلاً فيجعل مِثْلَه، وفي الصحاح: ما يُضرَب به من الأَمْثال. قال الجوهري: ومَثَلُ الشيء أَيضاً صفته.[1]
في القاموس المحيط:
المثل محركة : الحجة والحديث ..
في الصحاح في اللغة
المثل ما يضرب من الامثال
مجنون دير هرقل : حوار الشعر والخبر ـ عبد الباسط مرداس
لحكايات مصارع العشّاق طَعم خاص، أخبار مُتنوّعة المبنى ومُتوحّدة المعنى، تُقحمنا في عالم فرط المحبّة الجارف والغرام الصارخ. أخبار سارت بها الركبان فاستوطنت كتب الأدب والأخبار. مادّة قصصية وحكايات مثالية متينة التكوين ومختلفة التلوين. تحوم حول الشعر، تُحاذيه وكأنّهما عاشقان يحتضنان. خبر يُلازم الشعر يصاحبه كظلّه وكأنّ بينهما نسب وقرابة. يلقي رؤية ويُطيل خيالاً. يُسلّي لكنّه يرسم إطاراً للقصيدة ويحتويها، فلا ندري هل سبق الشعر الخبر أم وُلدا معاً من رحم الإبداع والأدب. يُلازم الشعر الخبر، يُرادفه ويستدعي كلّ واحد منهما الآخر، تارة بوضوح وأخرى باستحياء. فأحياناً يعيد الخبر فكرة الشعر وأخرى يمطّطها ويجعلها طُعماً للخيال. هذا ما سنعالجه بعجالة في هذا المقال من خلال خبر ذاع صيته فتلقّفته كتب الأدب. حكاية من حكايات الشعراء العشّاق المجانين الذين أحرقهم البين فصاروا متيّمين.
كلّ من تصفّح كتاب مصارع العشاق للسراج يلتقي بأخبار غاية في الجمال، أصحابها رجال وقعوا في حبائل العشق والصبابة فعانوا مرارة البين والفراق. فإذا كان لمجنون ليلى حظّ وافر في المخيال الأدبي عند القرّاء والمستمعين، وقد أصبح مُتربّعاً على عرش العشق والجنون، فهناك أسماء كثيرة ذكرها العارفون بالأدب. حكايات تلعجك منذ اللّقاء الأول فيغمر فؤادك الألم والحُرقة. فمن منّا لم يطرب لسماع قصيدة " لمّا أناخوا قُبيل الصبح عيسهم" بصوت ناظم الغزالي وصدْح صباح فخري. ومن منّا يعرف علاقة هذه القصيدة بخبر شاعر مجهول يلقّب بــ"مجنون دير هرقل" أو "هِزِقْل " حسب الروايات.
النسق اللغوي للومضة القصصية مجموعة: "غربة" لمحمد لقمان نموذجا ـ أبو إسماعيل أعبو
إن من يقرأ ما يحتويه كتاب غربة(1) من ومضات قصصية، موجزة الألفاظ ومكثفة المعاني، لا يخالجه أدنى شك في ريادته، فهو كتاب أحرز به كاتبه المصري محمد لقمان، قصب السبق في ارتياد آفاق جنس أدبي أحدثه، ونظر له، واستدل على توسيماته الجنسية المميزة، الأديب المصري مجدي الشلبي، الذي لم يلبث ان تدبر حركته التأسيسية وفعله الإبداعي، متيحا مجال التجربة للكتاب والنقاد والقراء، تحت لواء الرابطة العربية للقصة الومضة، التي بوأتها منزلة مركز الجاذبية والإشعاع ضمن تشكيلة الأجناس الأدبية.
وإذا كان القاص، قد أمعن في تمثل النمذجة الجنسية للومضة القصصية، ومرجعياتها النظرية، وفقما نظر لها مبتكرها، فإنه في الآن ذاته قد أمعن في استثمارها استثمارا أفضى بكتابته إلى خصوصية مميزة لها، لهذا لا غرو إن استثرنا بصددها سؤالين متفاعلي الإجابة، أولهما ما الصيغة التي تتجلى فيها ومضاته القصصية، وتتشكل عليها مناويلها الإبداعية مبنى ومعنى؟، وأي جمالية يخلص إليها القاص في كتابه غربة؟
إن القصة الومضة في هذا الكتاب، تقوم على فكر هندسي، أتى استجابة لميل في العصر الحالي، إلى الكتابات المختزلة، التي تومض بما قلَّ من الألفاظ، بمعان تستتيح متعة القراءة والاستمتاع بجمالية المقروء، لذا لا غرابة إن استوت معالمها، على بنية لغوية نسقية محكمة، تنتظم وفق شطرين متوازيين، تفصل بينهما علامة النقطة الفاصلة، الدالة على أن الثاني منهما سبب للأول:
شاعرة
عشقتِ الحروف؛ زفتْ لبيت القصيد. ص:45.
المثقفُ بين الغائيّة و الغنائيّة ـ رشيد سكري
دور المثقّف عضويٌّ ؛ ذلك ما سطَّره في القرن التاسع عشر المفكر الإيطالي أنطونيو غرامْشي . فالإبداع ، عموما ، هو الوجودُ في أبهى صوره . بموازاة ذلك فهو يأخذك، عن طريق الحلم و التخييل و الرؤيا ، إلى عوالمَ متعددةٍ ، و ترشِف من تجاربَ مختلفةٍ ، وأخيرا يمنحك طعم الوجود . علاوة على ذلك ، فهو يتسلل خِلسة ليعانق المحاكاة لشيء موجود . فعندما يبدع القاص قصة ؛ فهو يتغنى بواقع قد يكون موبوءا أو مثخنا بالجراح . فإبداع قصيدة ، مثلا ، مدعاة لمحكاة أصوات و غناء هو أصلا موجود في الطبيعة . إلى جوار ذلك، في الأدب العربي القديم ، سنجد الأعشى كان بارعا في الغناء ، بصوته العذب الرخيم ؛ ونتيجة لذلك عُرف بصَنُُّاجة العرب . يستخرج من القصيد أوزانا ، ويرددها بشكل طروب...
إن الأذن العربية ، كما هو معروف ، ألفت الموسيقى من خلال توليفات شعرية ؛ فحيثما وجد البديع والمحسنات البديعية ... وجد الغناء . فكثيرة هي القصائد المغناة من الشعر القديم و الحديث ... أطربت أجيالا و أجيالا ، وبصمت الأذن العربية بالفن الرفيع . فيها يسمو الذوق بألحان ممشوقة ، وبكلمات تغوص في الوجدان ، حافرةَ أخاديدَ من التأمل والمتعة معا . فقصيدة " دعوه ... مبذرا " لأبي الطيب المتنبي من الكامل ، غنَّاها الفنان البحريني المتميز أحمد الجميري ، والتي مطلعُها :
بأبي الشموسُ الجانحاتُ غواربا اللاَّبساتُ من الحرير جلاببـا
المنهباتُ عقــــولنا و قلــــــوبنـا وجنــاتهن الناهبات النـاهـــبا
إرهاصات الجدة والابتكار في قصص "ذات الوجه الطويل" ـ عبد النبي بزاز
بإصداره لأضمومته القصصية الثانية "ذات الوجه الطويل" يراهن القاص مصطفى الطاهري على رسم مسار كتابة سردية تروم المزاوجة بين نمطي القصة القصيرة والقصيرة جدا. فبعد أن تضمنت مجموعته الأولى "حين بكى الحصان" قصصا قصيرة جدا حبلى بتنوع وتعدد "التيمات" في أبعاد دلالية وجمالية تمتح من مرجعيات تاريخية ووجودية ودينية وفكرية ... متوسلة بلغة قوامها الاقتصاد و الاختزال بحمولات مرتهنة لحس رؤيوي تنتأ إرهاصاته وتتمظهر تجلياته عبر أشكال إيحائية وتلميحية تقتضيها طبيعة أجناسية النصوص( قصيرة جدا) بكثافتها اللغوية وومضاتها الدلالية لتنضاف المجموعة القصصية الثانية "ذات الوجه الطويل" بإرساء أواليات سيرورة قصصية تتغيا الإضافة والتطوير عبر نصوص قصصية قصيرة تستحضر فيها الشخوص والأحداث بشكل أوفر وفي حيز أرحب لرسم معالم عوالم سردية مشرعة على آفاق ممعنة في الاستعصاء والالتباس تستدعي التسلح بعدة من أسئلة تروم الاكتشاف والاختراق من خلال اجتراح عتبات مدخلاتها والخوض في غمار أكماتها وامتداداتها.
فنصوص مجموعة "ذات الوجه الطويل" تمتح من مرجعيات يطبعها التنوع والتعدد عبر الاستحضار والاستشراف بنفس سردي يتوسل بالوصف: " ظهرت قربته تتدلى من جنبه كبطن بقرة"، و" شمس حمراء ذابلة..." مما يمنح النصوص زخما زاخرا بأبعاد جمالية ودلالية تمعن في إيحاءات غنية بحمولات متعددة المرامي، متشعبة المقصديات ديدنها الاكتشاف والاستشراف المدجج بهواجس البحث وقلق السؤال: "أين بنوها؟ أمن حجر؟ أمن خشب؟"، و" ومن بعد خمسين عاما أحس بأني أسافر ضد البلاد..." لتأخذ منحى أكثر عمقا وثراء بتشكلات رمزية وتشعبات مسلكية: "تنحدر ببطء نحو خباء من ورق مقوى".