 " الديمقراطية بصفتها نظاما يتضمن التحكم بالمواطنين وفصل السلطات وتعددية الآراء وصراع الأفكار هي الدواء الشافي للسلطان المطلق لجهاز الدولة وجنون السلطة الشخصية."[1]
" الديمقراطية بصفتها نظاما يتضمن التحكم بالمواطنين وفصل السلطات وتعددية الآراء وصراع الأفكار هي الدواء الشافي للسلطان المطلق لجهاز الدولة وجنون السلطة الشخصية."[1]
ماهو بديهي أن طبيعة الدولة التي تتبني خيار الاستبداد هو تعليق كل ممارسة ديمقراطية وإلغاء التعددية واحتكار ثروات المجتمع من طرف الطبقة الحاكمة وسن القوانين التي تحافظ بها على مصالحها وتعيد إنتاج هيمنتها على المكونات والقوى المتنافسة بشكل دائم. ومن الواضح والمعروف أن إعلان نظام سياسي ما تبني خيار الديمقراطية والشروع في تفعيل آليات معينة لتجسيم هذا الخيار هو كفيل بالتخلص من الاستبداد والحكم الفردي والكف عن تسيير الشأن العام باستخدام القوة واعتماد التشريعات الجيدة واحترام نصوص الدساتير. لكن المفارقة تظهر عندما تتجمل الأنظمة الاستبدادية بالديمقراطية وتستعمل هذه الفكرة الحقوقية النبيلة من أجل توطيد أركان الحكم المطلق وتبقى عليها في الواجهة وتتبجح بالشعارات السياسية الفضفاضة لا غير وتتناقض معها في ميدان الممارسة ومجريات الأحداث اليومية.
الإنسان العربي بين الحلم وإكراهات الواقع ـ فتحي الحبّوبي
 أنا يا صديقة
أنا يا صديقة
متعب بعروبتي
فهل العروبة
لعنة وعقاب
نزار قباني
تأسيسا على أن المواطنة، في أبعادها القانونية والسياسية والاجتماعية وحتّى الادارية، بما تعنيه من مساواة بين الأفراد دون تمييز قائم على الدين أو الجنس أو اللّون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري. وبما يترتب عنها من حقوق وواجبات ترتكز على قيم عليا، نذكر من بينها المساواة أمام القانون والقضاء فيما يعرف بعلويّة القانون، وحرية تأييد أو معارضة أيّة قضية اجتماعية أو موقف سياسي، وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات أو المشاركة فيها. وتأسيسا كذلك على أن أبعاد المواطنة سالفة الذكر وما يترتب عنها من حقوق، مفقودة جميعها أو بعضها في البلدان العربية، حسب درجة وعي شعوبها وقدرتها على المطالبة بها وانتزاعها اثر نضالات مريرة. فقد تعمّدت في العنوان استعمال عبارة الإنسان وليس المواطن لاعتقادي الجازم أن الانسان في كافة أرجاء الوطن العربي المشرذم، ودون استثناء، يعامله حكّامه باعتباره رعيّة لا مواطنا كامل الحقوق التي من شأنها أن تحفظ الكرامة وتحقّق إنسانيّة الانسان. بما يجعل أمامه معوقات كثيرة تعرقل مسيرة حياته الشقيّة في الأغلب الأعمّ. فلا هو يستفيد من حياته ولا هو يفيد المجموعة الوطنية التي ينتمي إليها.
مصر أكبر من مماليكها : محمد علي فرحات
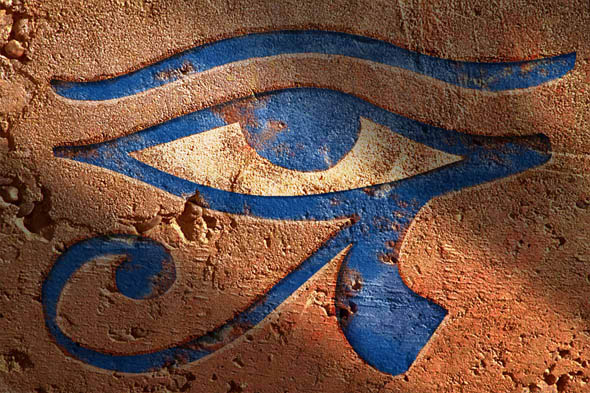 العفيف الأخضر، النهضوي التونسي المتحـــمس، نموذج مفكرين يعتقدون أن قربهم من النــــاس يقتضي بعدهم من أجواء التدين، وموقفــــهم هذا يستند إلى نهضة أوروبية وصلــــت إلى حدّ عبادة العقل رداً على التحالف الظالــــم بين الإقطاع والإكليروس. كانت المدينة تنمــــو وترســــم أفقاً جديداً للإنتاج يتعدى الزراعة ويقــــودها. إنها المدينة الأوروبية الناهــــضة التي انتقلت شظايا أفكارها إلى بلادنا، ولا زلــــنا نتفاعل معها من دون إبداع يستـــند إلى قاعدتنا الاقتصادية والثقافية. انظر إلى أدبيات النهضة العربية، وكيف أنها عالقة بمادية شبلي الشميل الوثوقية واجتماعيات عبدالرحمن الكواكبي وسلامة موسى ومعاصريهما.
العفيف الأخضر، النهضوي التونسي المتحـــمس، نموذج مفكرين يعتقدون أن قربهم من النــــاس يقتضي بعدهم من أجواء التدين، وموقفــــهم هذا يستند إلى نهضة أوروبية وصلــــت إلى حدّ عبادة العقل رداً على التحالف الظالــــم بين الإقطاع والإكليروس. كانت المدينة تنمــــو وترســــم أفقاً جديداً للإنتاج يتعدى الزراعة ويقــــودها. إنها المدينة الأوروبية الناهــــضة التي انتقلت شظايا أفكارها إلى بلادنا، ولا زلــــنا نتفاعل معها من دون إبداع يستـــند إلى قاعدتنا الاقتصادية والثقافية. انظر إلى أدبيات النهضة العربية، وكيف أنها عالقة بمادية شبلي الشميل الوثوقية واجتماعيات عبدالرحمن الكواكبي وسلامة موسى ومعاصريهما.
عندما يتفوق مرسي على مبارك ـ عبدالله إسكندر
 نجح الرئيس محمد مرسي، وحزبه جماعة «الإخوان المسلمين» ومن معها، في سنة واحدة ما اقتضى أكثر من ثلاثة عقود للرئيس السابق حسني مبارك وحزبه وأزلامه، لتحقيقه. لا بل تفوق مرسي على مبارك، لكونه تمكن من أن يجمع بعد سنة واحدة من الحكم، من المعترضين في الشوارع والميادين اكثر بكثير مما جمع مبارك ضده، بعد طول حكم واستبداد وفساد. لكن ما يُحسب لمبارك أنه أدرك استحالة الاستمرار في المأزق الذي أوصل حكمه البلاد إليه، فتنحى لتبدأ مرحلة أخرى انتقالية.
نجح الرئيس محمد مرسي، وحزبه جماعة «الإخوان المسلمين» ومن معها، في سنة واحدة ما اقتضى أكثر من ثلاثة عقود للرئيس السابق حسني مبارك وحزبه وأزلامه، لتحقيقه. لا بل تفوق مرسي على مبارك، لكونه تمكن من أن يجمع بعد سنة واحدة من الحكم، من المعترضين في الشوارع والميادين اكثر بكثير مما جمع مبارك ضده، بعد طول حكم واستبداد وفساد. لكن ما يُحسب لمبارك أنه أدرك استحالة الاستمرار في المأزق الذي أوصل حكمه البلاد إليه، فتنحى لتبدأ مرحلة أخرى انتقالية.
وإذا لم يستوعب مرسي، وقبله مكتب الإرشاد للجماعة، هذه المفارقة، فان كل حديث عن حوار ومصالحة ليس سوى ذر للرماد في العيون.
نظرية القيم السياسية : نموذج قيمة العدالة في الإسلام عند جمال الدين الأفغاني ـ الحافظ النويني
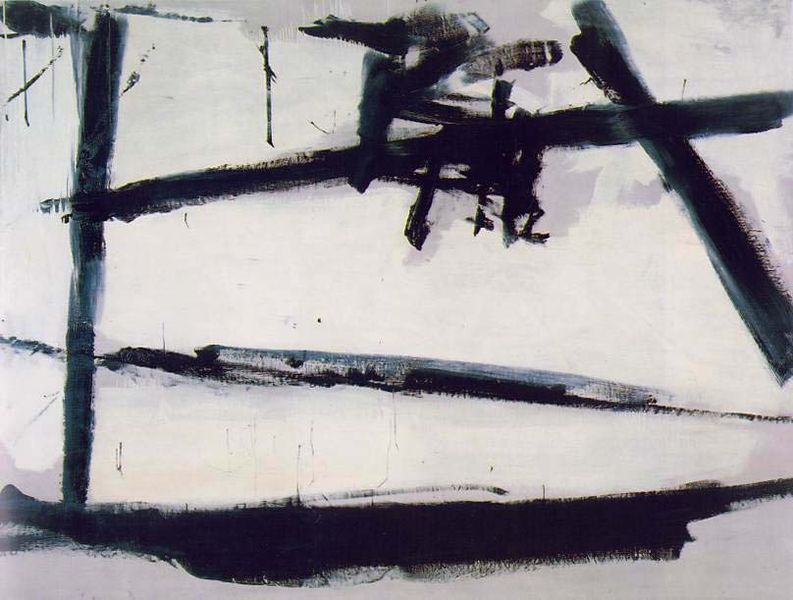 مقدمة:
مقدمة:
لا يوجد شعب في العالم كله و عبر التاريخ, الا و اجتاحته في وقت من الزمن موجة عنف, و في هذه الظروف تختلط الموازين فيصبح كل احد من اطراف الصراع يدافع عن طرحه معتقدا انه صاحب الحق, و يحاول الطرف الاخر ان يدافع عن طرحه هو الاخر . و كلهم رافعون شعار العدل , و راية العدالة الاجتماعية.
و مسألة العدل و العدالة لا تطرح مطلقا في عالم الحيوان , الذي تسوده شريعة الغاب , اما المجتمع الانساني و الانسان فإنه يطرح مسألة العدالة و يطالب بالعدل و الانصاف, و قد اقدم على وضع قوانين للعدالة منذ القدم و قبل نزول الرسالات السماوية . اما الاديان فقد وضعت قواعد للعدالة و اقامت الحدود, و الاسلام كونه اخر الرسائل السماوية فقد اتى بتشريعات مفصلة و قوانين شاملة لتنظيم الانسان على اساس العدل .
دور الشباب في تنمية المجتمع المدني ـ نورالدين الوردي
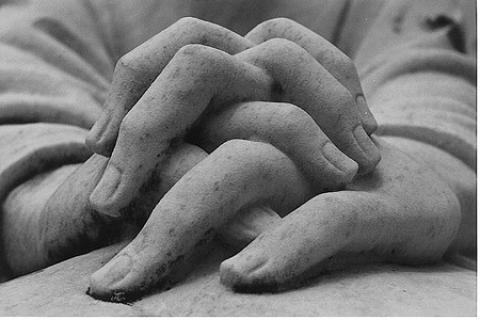 يقول فريديريك نيتشه أن لا أمل في أن يمتلك الإنسان وجوده وكينونته إلا بالنضال من أجل إرادة القوة، والتي لا يمكنها أن تتحقق إلا بمجابهة تمثلات الواقع ومسلماته، والتضحية بالحياة واحتقارها، بحثا عن حياة ثانية كلها مجد وكرامة؛ لأن الإنسان كائن يمتلك الإرادة الحقيقية على تغيير نفسه وتغيير العالم من حوله، بحيث لا يظل الإنسان عبدا يتحكم في حياته الأسياد ويحجرون على تفكيره وحركته.
يقول فريديريك نيتشه أن لا أمل في أن يمتلك الإنسان وجوده وكينونته إلا بالنضال من أجل إرادة القوة، والتي لا يمكنها أن تتحقق إلا بمجابهة تمثلات الواقع ومسلماته، والتضحية بالحياة واحتقارها، بحثا عن حياة ثانية كلها مجد وكرامة؛ لأن الإنسان كائن يمتلك الإرادة الحقيقية على تغيير نفسه وتغيير العالم من حوله، بحيث لا يظل الإنسان عبدا يتحكم في حياته الأسياد ويحجرون على تفكيره وحركته.
إن تراجع الدولة عن دورها في الميادين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ساهم في تزايد مبادرات أفراد المجتمع في الانتظام وبشكل منظم جماعيا داخل تنظيمات وجمعيات مختلفة من حيث الأهداف، وعرفت وثيرة متنامية ومتسارعة في العقود الأخيرة من الزمن، قوامها الأساس مبدأ "التطوع" في مختلف المجالات من أجل تحقيق أهداف مجتمعية في حياد واستقلالية عن الدولة.
ثورات القوة الناعمة في العالم العربي : من المنظومة إلى الشبكة ـ إبراهيم أيت إزي
 استفاق العالم صبيحة 17 ديسمبر 2010 على حدث اسثنائي زحف على المشرق العربي وبلدان المغارب، كان هو صباح الرجة الثورية التي قلبت موازين القوى، وتهتز معها اوضاع راكدة وتسقط أنظمة سياسية عاتية وتتهاوى أصنام ايديولوجية خاوية، الأمر الذي غير مجموعة من المعطيات وقلب المعادلات وخلخل الحسابات. وذلك عن طريق احتلال الحلبة السياسية من طرف شباب الإعلام الاجتماعي الثائر، الذي اقتحم الفضاءات العمومية مطالبا ومصرا على إحداث تغيير جذري في الأنظمة السياسية، حيث شق آفاقا فكرية جديدة وفتح باب الحرية أمام الجميع، أمام النخب المثقفة والمعارضة السياسية والانسان العادي، كما غير قناعات الاسلاميين الذين أعلنوا قبولهم بالدولة المدنية الديموقراطية، دون أن ننسى الحضور القوي للجنس الناعم.
استفاق العالم صبيحة 17 ديسمبر 2010 على حدث اسثنائي زحف على المشرق العربي وبلدان المغارب، كان هو صباح الرجة الثورية التي قلبت موازين القوى، وتهتز معها اوضاع راكدة وتسقط أنظمة سياسية عاتية وتتهاوى أصنام ايديولوجية خاوية، الأمر الذي غير مجموعة من المعطيات وقلب المعادلات وخلخل الحسابات. وذلك عن طريق احتلال الحلبة السياسية من طرف شباب الإعلام الاجتماعي الثائر، الذي اقتحم الفضاءات العمومية مطالبا ومصرا على إحداث تغيير جذري في الأنظمة السياسية، حيث شق آفاقا فكرية جديدة وفتح باب الحرية أمام الجميع، أمام النخب المثقفة والمعارضة السياسية والانسان العادي، كما غير قناعات الاسلاميين الذين أعلنوا قبولهم بالدولة المدنية الديموقراطية، دون أن ننسى الحضور القوي للجنس الناعم.
هذا الحدث أثار مجموعة من المثقفين والكتاب حيث تعددت القراءات والمقاربات كل من زاوية اختصاصه فمن آل التاريخ والسوسيولوجيا إلى العلوم السياسية كل حاول الوقوف على الحدث وسبر أغواره. ومن هؤلاء نجد حضور صاحب أوهام النخبة المفكر اللبناني علي حرب[1] صاحب الأسلوب الكتابي الرشيق وحلاوة العبارة المولع بالتفكيك متأثرا بجاك دريدا.
مفهوم المجتمع المدني: النشأة و التطور التاريخي ـ حسام هاب
 يعتبر مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم المتداولة بشكل واسع في الخطاب الثقافي الغربي و العربي ، و من هنا تكمن ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل هذا المفهوم ، عبر إعادة صياغته و تحديد مدلولاته النظرية و العملية ، مما يستدعي رصد مكوناته المعرفية و العودة إلى الفضاء الزماني و المكاني الذي شهد ولادته لرسم الملامح العامة للتطورات و التمايزات التي طرأت عليه في سياق صعود أوربا الصناعية الرأسمالية ، باقتصادها و فلسفاتها و حراكها الاجتماعي الاصلاحي المتدرج و الثوري التغييري ، أي في جملة العوامل و الأحداث التي ساهمت في تكريس قطيعة متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى . و نظرا للطابع الإشكالي الذي ينطوي عليه مفهوم المجتمع المدني ، باعتباره تجريدا ذهنيا لواقع اجتماعي شديد التعقيد و التباين ، يزخر بالتناقضات و لا يتوقف عن التغيير ، فقد عمدت هذه الدراسة إلى تحديد مكونات مفهوم المجتمع المدني النظرية ، كما تبلورت في إطار النظرية الليبرالية بمفرداتها الأساسية : العقد الاجتماعي مقابل نظريات الحق الإلهي للملوك ، التعددية السياسية بديلا للحكم المطلق ، إقرار حق المواطنة و الحريات العامة في الحياة و الملكية و العمل و الرأي و المعتقد بعد أن كانت هذه الحريات مقتصرة على الملك و النبلاء ، أي على أقلية أرستقراطية تمتلك حق التصرف في شؤون الدنيا و الآخرة و أخيرا الانتقال إلى مبدأ سيادة الأمة المشتق من حق المواطنة الذي جاء تعبيرا عن تجاوز الانتماء التقليدي في صيغه الدينية و المذهبية و الاثنية ، باتجاه علاقات اجتماعية طوعية و تعاقدية و حرة ، ينتظم فيها الأفراد لتحقيق غايات و مصالح مشتركة . وقد جاء مبدأ فصل السلطات و استقلالية الأجهزة القضائية و التشريعية عن السلطة التنفيذية ليحد من تمركز السلطات ، و يعيق إمكانية التحكم غير الشرعي في شؤون الدولة و المجتمع .
يعتبر مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم المتداولة بشكل واسع في الخطاب الثقافي الغربي و العربي ، و من هنا تكمن ضرورة العمل على المستوى المفاهيمي لتأصيل هذا المفهوم ، عبر إعادة صياغته و تحديد مدلولاته النظرية و العملية ، مما يستدعي رصد مكوناته المعرفية و العودة إلى الفضاء الزماني و المكاني الذي شهد ولادته لرسم الملامح العامة للتطورات و التمايزات التي طرأت عليه في سياق صعود أوربا الصناعية الرأسمالية ، باقتصادها و فلسفاتها و حراكها الاجتماعي الاصلاحي المتدرج و الثوري التغييري ، أي في جملة العوامل و الأحداث التي ساهمت في تكريس قطيعة متعددة الوجوه مع عالم العصور الوسطى . و نظرا للطابع الإشكالي الذي ينطوي عليه مفهوم المجتمع المدني ، باعتباره تجريدا ذهنيا لواقع اجتماعي شديد التعقيد و التباين ، يزخر بالتناقضات و لا يتوقف عن التغيير ، فقد عمدت هذه الدراسة إلى تحديد مكونات مفهوم المجتمع المدني النظرية ، كما تبلورت في إطار النظرية الليبرالية بمفرداتها الأساسية : العقد الاجتماعي مقابل نظريات الحق الإلهي للملوك ، التعددية السياسية بديلا للحكم المطلق ، إقرار حق المواطنة و الحريات العامة في الحياة و الملكية و العمل و الرأي و المعتقد بعد أن كانت هذه الحريات مقتصرة على الملك و النبلاء ، أي على أقلية أرستقراطية تمتلك حق التصرف في شؤون الدنيا و الآخرة و أخيرا الانتقال إلى مبدأ سيادة الأمة المشتق من حق المواطنة الذي جاء تعبيرا عن تجاوز الانتماء التقليدي في صيغه الدينية و المذهبية و الاثنية ، باتجاه علاقات اجتماعية طوعية و تعاقدية و حرة ، ينتظم فيها الأفراد لتحقيق غايات و مصالح مشتركة . وقد جاء مبدأ فصل السلطات و استقلالية الأجهزة القضائية و التشريعية عن السلطة التنفيذية ليحد من تمركز السلطات ، و يعيق إمكانية التحكم غير الشرعي في شؤون الدولة و المجتمع .












