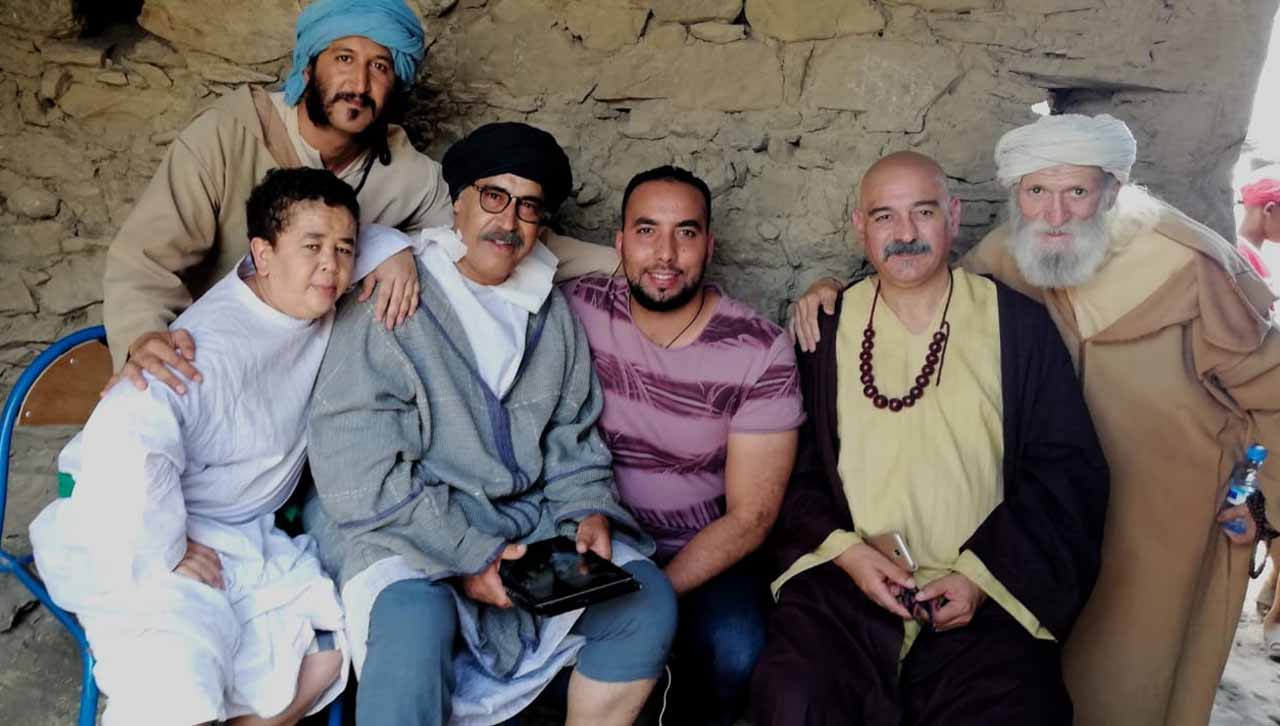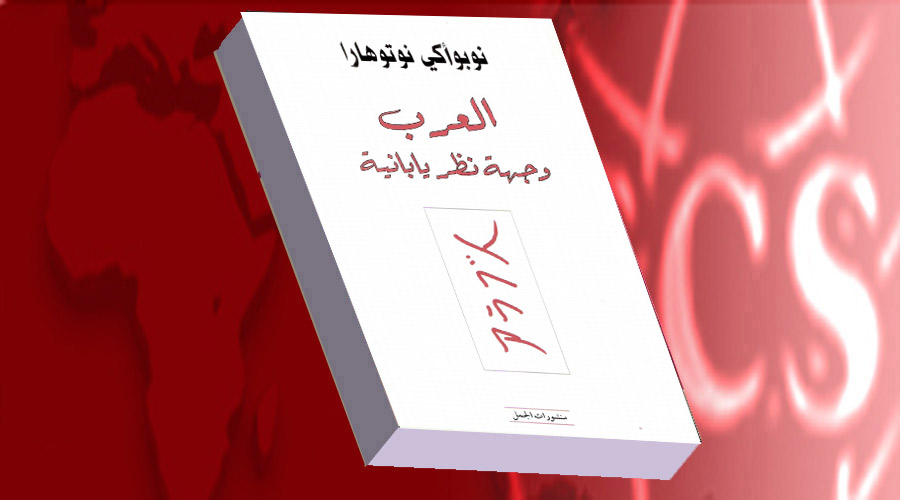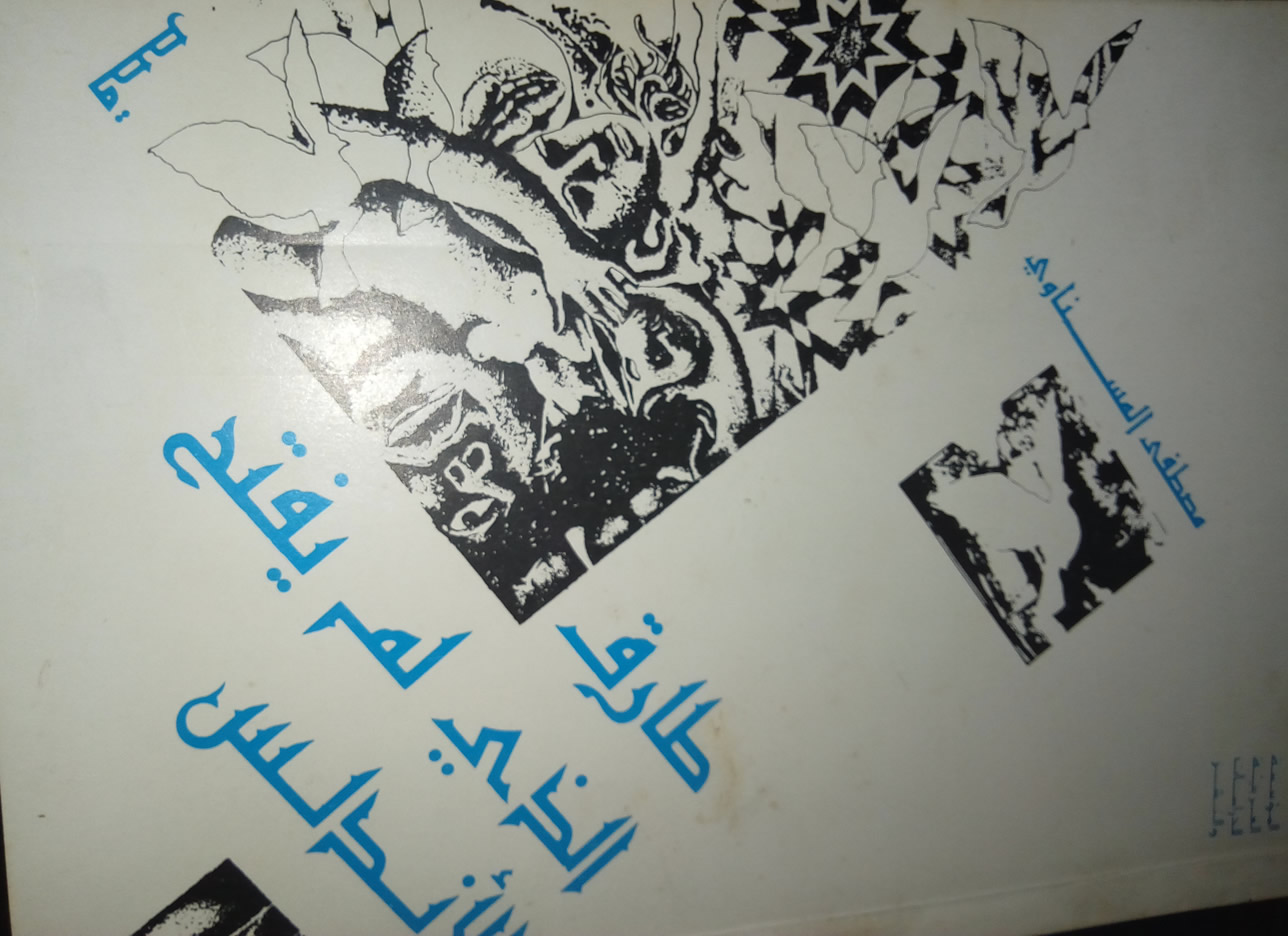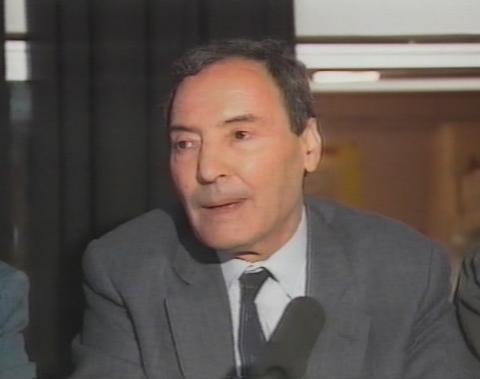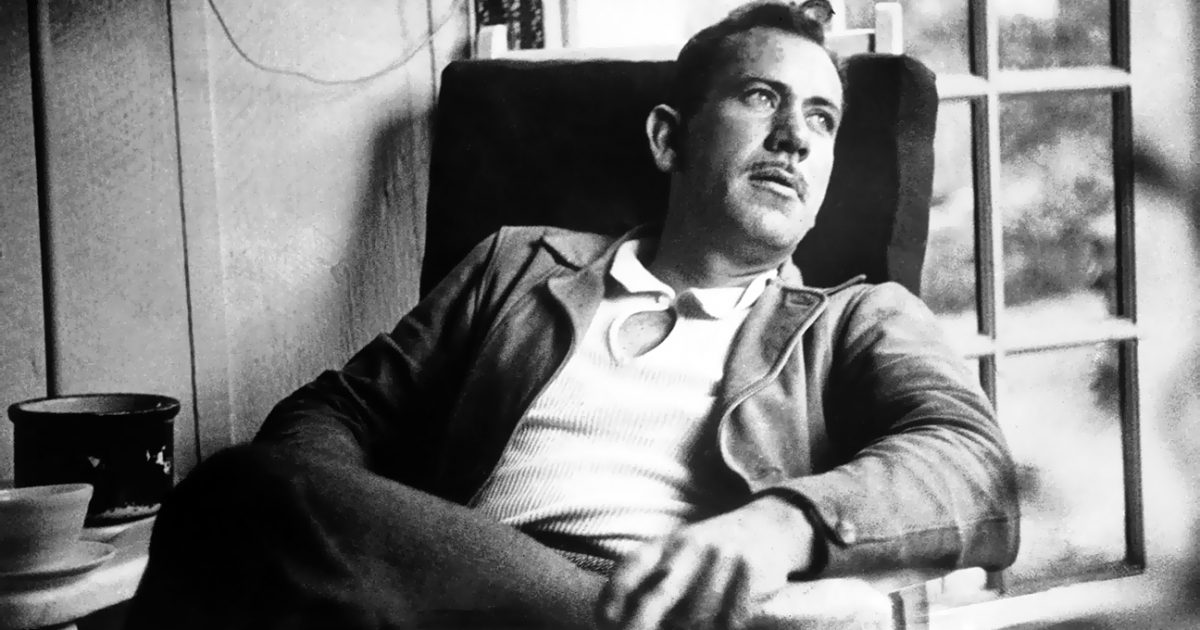مقدمة :
تبدو الرواية المنجزة مؤخرا للرّوائي الجزائري واسيني الأعرج الموسومة بـــــــ ليليات رمادة من بين النُّصوص التي تثير أكثر من إشكال، فبالإضافة إلى نسختها الرّقمية المُتَاحَة على شبكة التّواصل الاجتماعي التي كُتِبَت مُنَجَّمَة ومصحُوبة بتعليقات القُراء فإن النّص الذي صدر حديثا - سيصدُرُ قريبا عن دار الآداب اللبنانية في مطلع شهر أكتوبر- [1] قد تغير كثيرا عن نسخته المُنجَّمة ليتحول في بنائه ونهايته وأشكال تفاعله .
و يُحيلُ النّص الرّوائي أساسًا من خلال عمليَّات تراكُميَّة مُتنوِّعة على دلالات وقيم مُختلفة ترسم ملامح النّص وتفضح عُمقه الإيديولوجي الذي يحتاجُ إلى إنعام وتفحُّص لكشف ما يحمله من أفكار. ولكنّ هذه الأفكار تظلّ دائما محكومة بما يُحيلُ عليه النّص المحايث أو العتبات هي رؤى حمّالة للدَّلالات والمعاني كاشفة لمنظُومة القيم يصدر عنها النّص .إذ لا يُمكن قراءة الواقع من منظور واحد .هو أشبه بمُفترق طرق للمعايير والقيم المتداخلة والمتشابكة ....ويتمثّلُ دور الروائي في تفكيك وتفصيل هذه التَّقاطعات واختزالها إلى عناصرها العميقة والأساسيّة . [2]