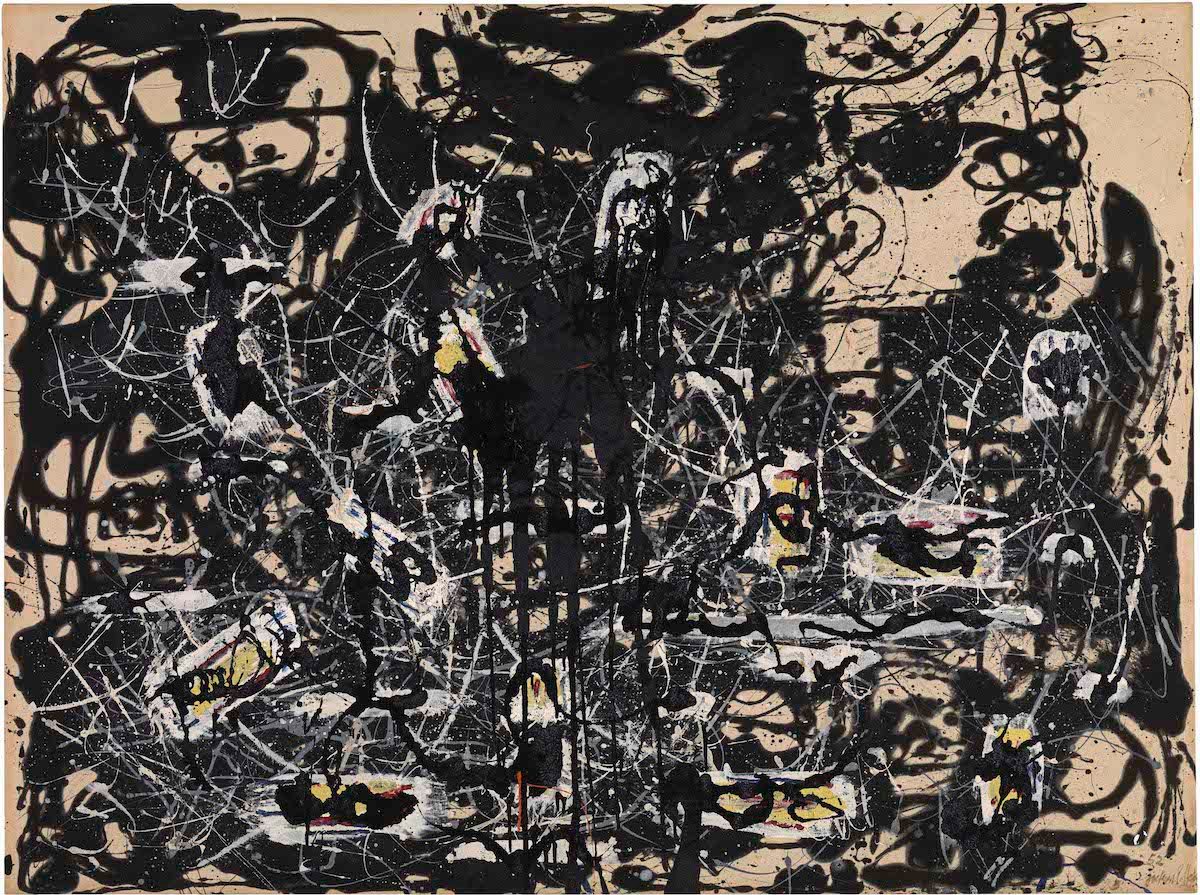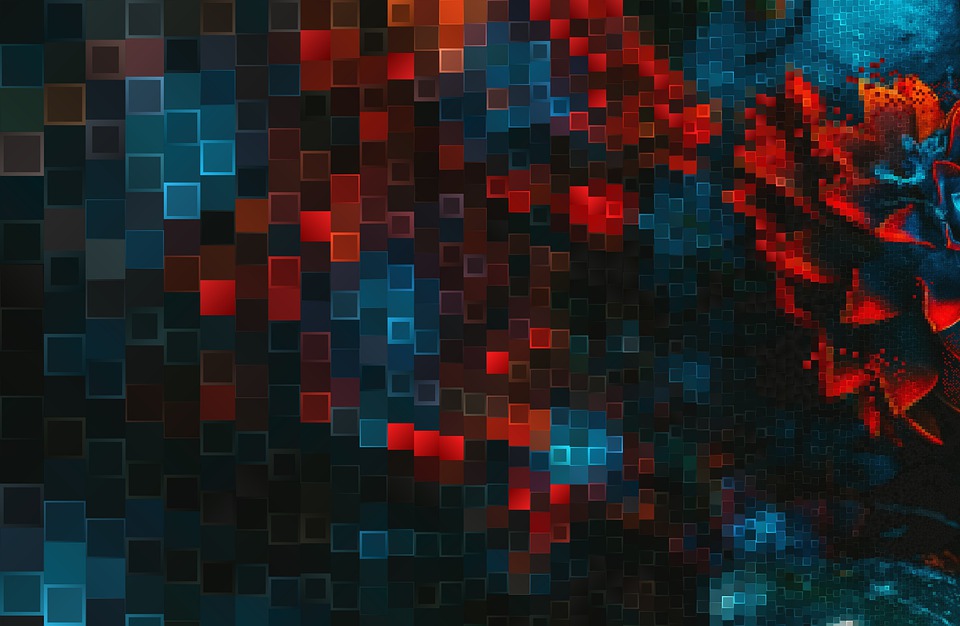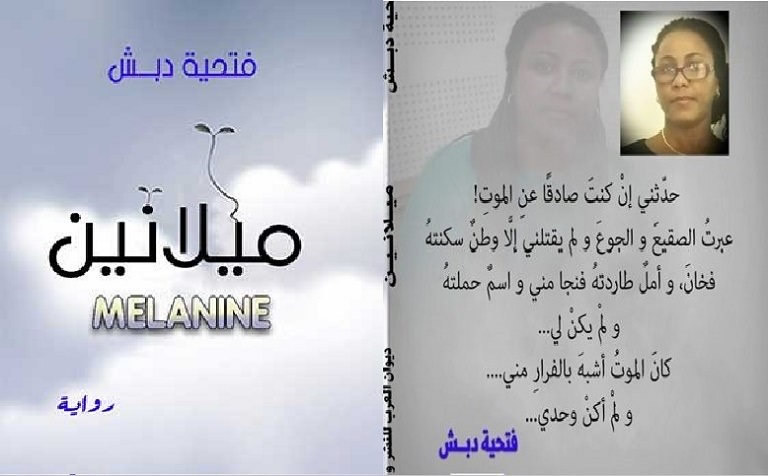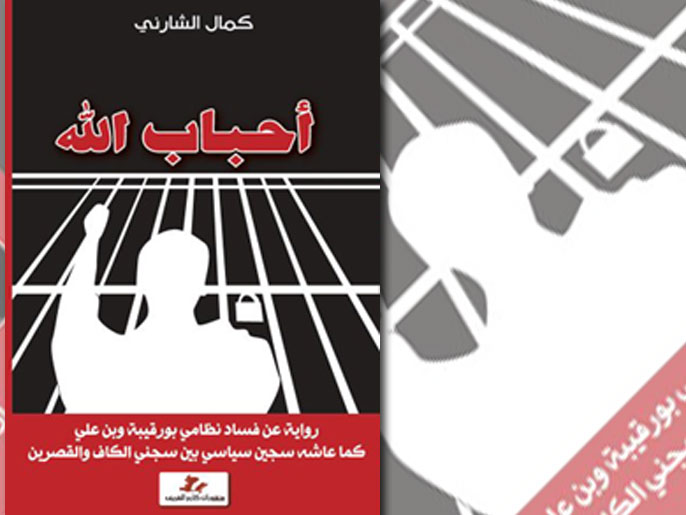مشكلة التجنيس:
يطرح تجنيس النصوص إشكالا حقيقيا يرتفع إلى مستوى "المعضلة"، وقد عبر غير واحد من الدارسين عن هذه المشكلة التي تواجه المشتغلين بالأدب عامة وبنظريته خاصة، من هؤلاء جيرار جونيت الذي عرض لهذا الإشكال في كتابه "مدخل لجامع النص"، حيث انتهى من تقليب النظر في هذه المسألة إلى أنه بالرغم من الاجتهادات العديدة المطروحة داخل نظرية الأجناس، فإنه لا يوجد من بين هذه "الاجتهادات" موقف، في ترتيب الأنواع، "أكثر طبيعية" أو "مثالية" من غيره، ذلك صريح قوله:
"نرى أنه لا يوجد بشأن ترتيب الأنواع الأدبية موقف يكون في جوهره أكثر "طبيعية" أو أكثر "مثالية" من غيره، ولن يتوافر هذا الموقف إلا إذا أهملنا المعايير الأدبية نفسها كما كان يفعل القدماء ضمنيا بشأن الموقف الصيغي. لا يوجد مستوى "جنسي" يمكن اعتماده كأعلى "نظريا" من غيره، أو يمكن الوصول إليه بطريقة "استنباطية" أعلى من غيرها، فجميع الأنواع أو الأجناس الصغرى والأجناس الكبرى لا تعدو أن تكون طبقات تجريبية، وضعت بناء على معاينة المعطى التاريخي، وفي أقصى الحالات عن طريق التقدير الاستقرائي انطلاقا من المعطى نفسه؛ أي عن طريق حركة استنباطية قائمة هي نفسها على حركة أولية استقرائية وتحليلية أيضا. ولقد رأينا بوضوح هذه الحركة في الجداول (الحقيقية أو القابلة للوجود) التي وضعها أرسطو وفراي، حيث ساعد وجود خانة فارغة (السرد الهزلي، السرد العقلاني، المنفتح) على اكتشاف جنس كان بالإمكان ألا يدرك مثل المحاكاة الساخرة"[1].