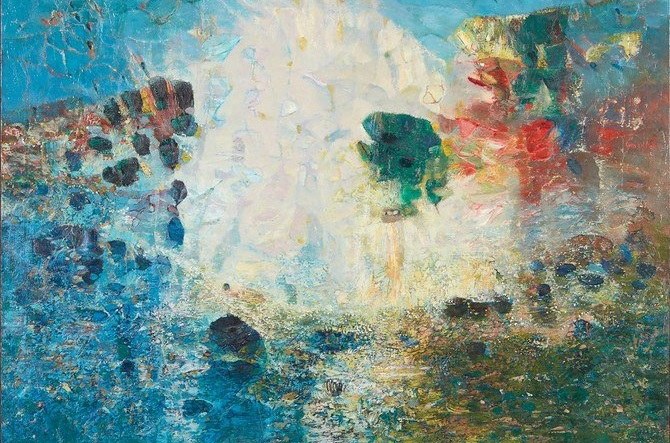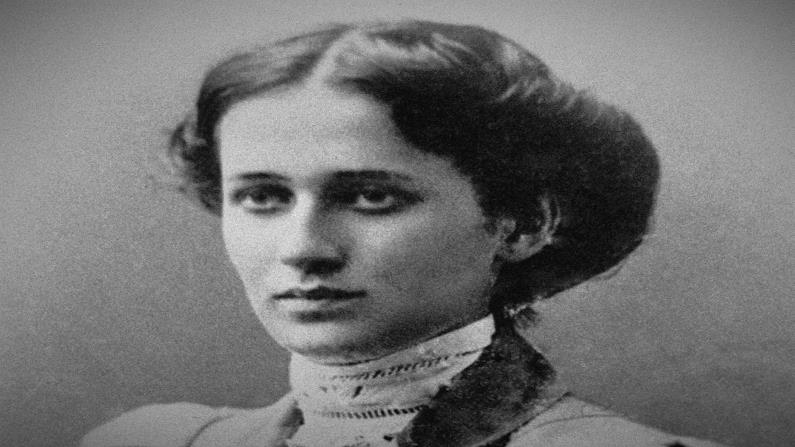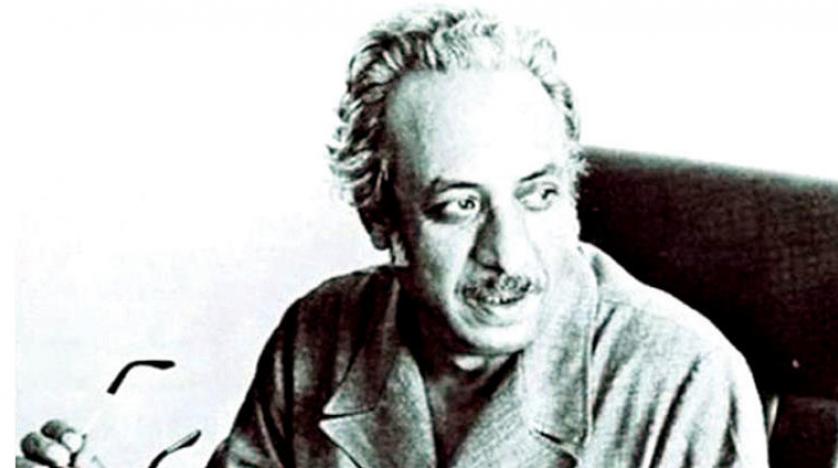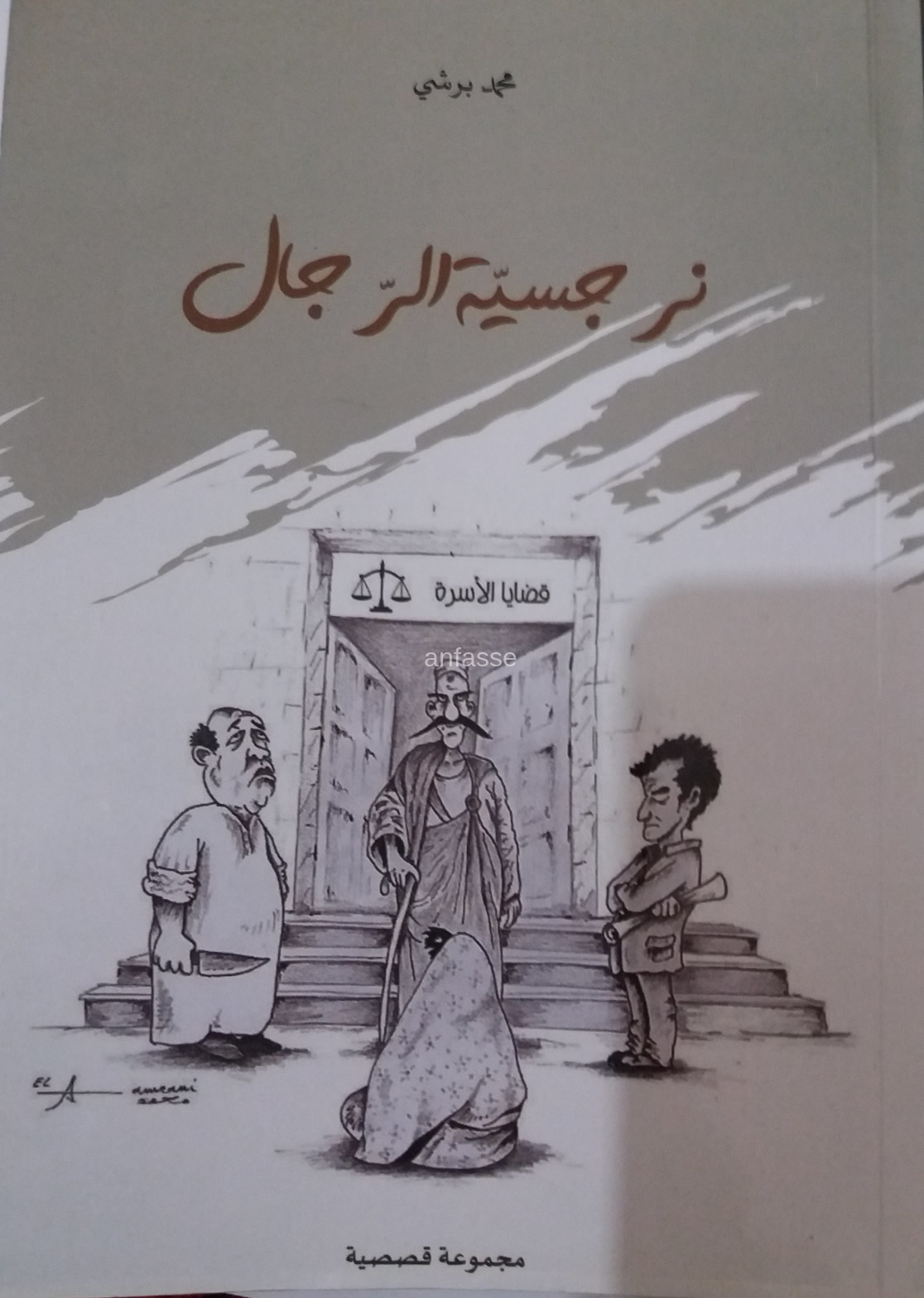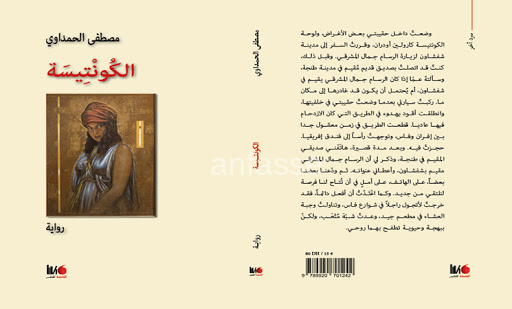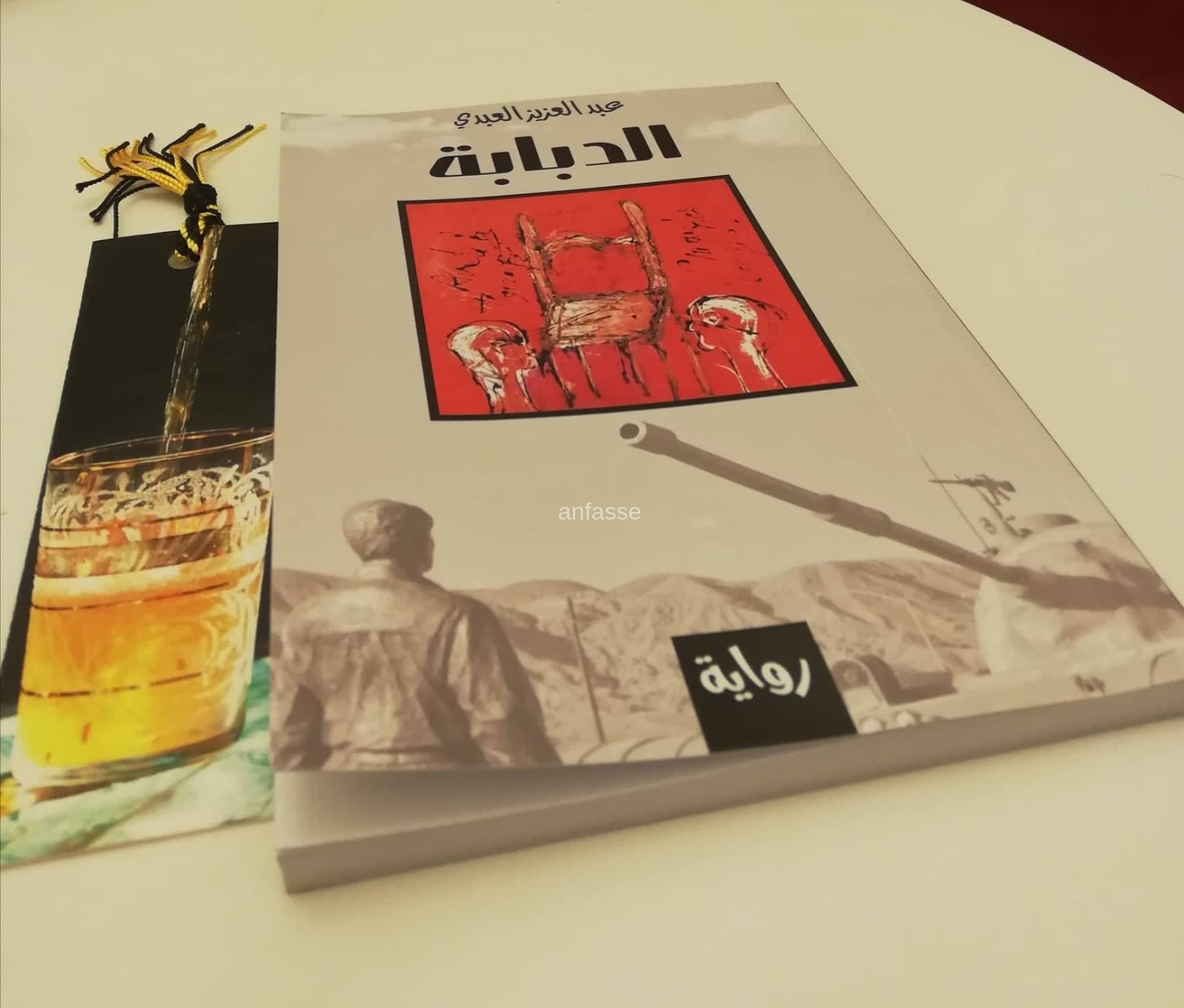مقدمة:
إن المأثور لدينا في موقف البحث عن أصل اللغة، خلق إشكالا كبيرا منذ البدايات الأولى في فلسفة اللغة مع محاورة كراتيلوس، التي تناولت مسائل رئيسة حول اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالفكر والمنطق من جهة، وبالواقع والتاريخ والقصدية من جهة أخرى، ذهبت بالفلاسفة مذاهب عديدة، كان فيها بون شاسع في حسم قضايا مرتبطة باللغة، أسها البحث في أصل اللغة، وهو ما تسعى هذه الورقة إلى مقاربته وإبانة ما زبر به علماء العرب من مواقف وآراء تختلف باختلاف مذاهبهم، بتخصيصنا للفيف من علماء اللغة، الذين كانت لهم مزية السبق في كشف حجب أصل اللغة بتقديم أدلة حول كل موقف الذي يتراوح بين التوفيق(الاصطلاح، والوضع) والتوقيف( الالهام، والطبع).
المحور الأول: الأسس والمفاهيم: