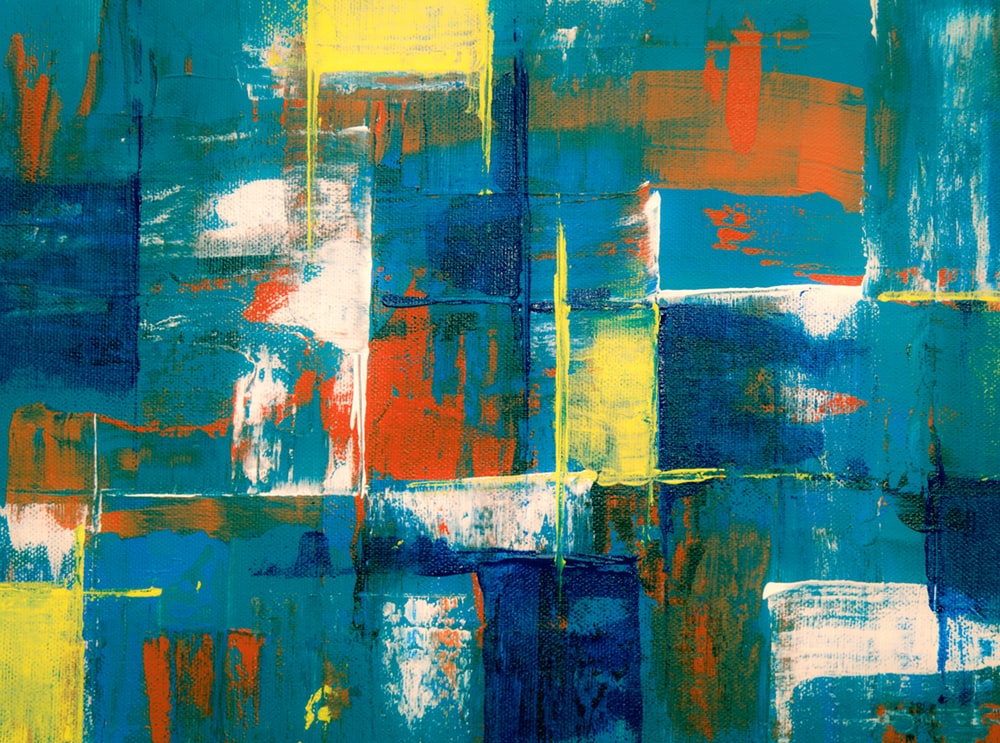1. مقدمة منهجية
فضلنا في هذه الدراسة الوقوف عند التجليات الدلالية في قصيدة (القدس عاصمة السماء، القدس عاصمة الجذور) للشاعر والناقد الفلسطيني عز الدين المناصرة؛ الذي يمثل أحد الوجوه البارزة في المشهد الشعري المعاصر للإسهامات التي قدمها ولا يزال في صناعة القصيدة الشعرية المنفتحة على ثيمات محددة ومتنوعة أيضا، لا تخرج عن المقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه.
1.1. واقع الدراسات العربية والمحددات المنهجية للقراءة
قبل أن نباشر تحليل هذه القصيدة، نستوقف القارئ لحظة لنحدثه عن المقاربات المنهجية التي تقف وراء معالجة النص عموما وشعر عز الدين المناصرة على وجه الخصوص.
تاريخانية الأدب - ذ. رشيد سكري
من أجل مُساءلة الأدب ، في صيرورة تواصلية دائمة ، لابد أن نعود إلى تاريخ المعرفة وإلى مراحلها و تطوراتها . حيث إن التاريخانية ، حسب المفكر و المؤرخ عبد الله العروي ، تسيج امتدادات الدرس الأدبي في الثقافة الإنسانية . فما من حديث عن ظاهرة أدبية إلا واندغمت بهذا الشرط التاريخي ، الذي يرسم حدودا زمنية للقول والكلام ؛ كاشفا ، بذلك ، عن أهم إبدالاتها و جدواها . فعلى امتداد ما يزيد عن خمسين سنة لكتاب " الأيديولوجية العربية المعاصرة " ، الذي أقر فيه العروي أن المناهج العلمية ، التي عولج بها الأدب العربي ، لا تقوم لها قائمة من دون تاريخ الأفكار ، ليأتي بعد ذلك كتابه " السنة والإصلاح" ، مجيبا عن تساؤلات ساخنة الوطيس متعلقة بالانتماء و الهوية والدين والتاريخ والأدب .
لما بكى ابن الرومي - إبراهيم مشارة
شاعر فذ من شعراء العصر العباسي لم ينل حقه من الإعجاب والتقدير حتى العصر الحديث حين قيضت له الأقدار عباس محمود العقاد فكتب عنه كتابه المشهور" ابن الرومي حياته من شعره" واقفا على أسرار حياته، غائصا في أدق دقائق سريرته متحمسا لشعره، كاشفا عن مكامن الفن فيه وآيات التفرد. وقد أنصف العقاد ابن الرومي كما أنصف غيره من الذين اعتقد أن الإجحاف والنكران لحقا بهم .
وإذا كان ابن الرومي غريب الأطوار وأخص خصيصة فيه تشاؤمه وتطيره بالناس إلى الحد الذي كان يلازم فيه بيته أياما إذا تطير بشخص، كما عرف عنه الشره، ولئن كان في حياته قد عانى من إهمال نقاد الشعر له وعدم احتفاء البلاط به فقد آذته هذه المعاملة الماكرة في نفسه وهو الذي كان يقدر مواهبه وعبقريته .لا جرم أنه شعر بالضيم واجتر المرارة ونزف الجرح في أعماقه غير مندمل فانقلب لسانه سوطا يسوم به خصومه سوء المقال تشفيا منهم ومن الزمن الذي غمطه حقه وبخسه ثوابه، أوليس هو القائل:
الألم والإبداع: الروح في حضرة الموت - إبراهيم مشارة
لاشئ يجعلنا عظماء غير ألم عظيم "ألفريد دي موسيه "
الألم كظاهرة جسمانية أو نفسية مظهر من مظاهر النقص في الكائن البشري وآية عدم سويته، إنه يصيب الإنسان بالعجز ويحسسه بانسحاقه وبعدم قدرته على مزاولة حياته اليومية كغيره من بني جنسه.
وسواء أكان الألم جسديا أم نفسيا فإنه يلقي بظلاله الشاحبة على عالم اللاوعي ويمسح بكآبته على سراديب الروح فيحس الفرد بنقصه وربما عدم كفاءته -على الأقل- في ممارسة الحياة العادية كعامة الناس.
الرواية الفلسطينية بين الغربة و الاغتراب - رشيد سكري
تظل الرواية ظاهرة مثيرة للجدل ، لا على مستوى البناء الحداثي الذي تصبو إليه من خلال أعمال رائدة فحسب ، بل على مستوى المضامين أيضا ، التي تؤلف بين بنياتها ، والقضايا الحاسمة و المصيرية ، التي تتشكل من داخلها . فإن كانت الغاية التي تطمح إليها هي خلخلة واقع موبوء و نفض الغبار عن مصير أو انتماء ؛ فإنها ، بذلك ، تشغل بال الفكر وتؤرق الواقع أيضا ، بل تذهب إلى حدود أن تلامس الوجدان الإنساني ، مادامت المعاناة قضية شاملة للوجود ككل ، بما هي ـ أي المعاناة ـ خيط ناظم ، على امتداد التاريخ الثقافي والفكري ، للكل التجارب الإنسانية . فبالحديث عن الرواية ، كتجربة إبداعية ، نطل من خلالها على رمزية الوجود في أسمى معانيه . فضلا على استبانة ، أمام ضمير العالم ، حق تقرير المصير الفردي والجماعي .و خصوصا إذا ما انفتحت الرواية على تجربة الآخر ، من خلال نقلها إلى لغات أخرى بفعل الترجمات ، التي غالبا ما تفنن في صيد وانتقاء مفرداتها ، وعباراتها السابحة في ماء الحكاية . فمن بين الروايات العربية التي تتقلب في وجداننا و تقض مضاجعنا ، بل تنغص الضمائر الحية ، وتجعلنا أمام شلال من الأضواء الكاشفة للذات و للآخرين ؛ الرواية الفلسطينية .
مقاربة وقراءة في مؤلف: "باب لقلب الريح" لمحمد آيت علو - صلاح مفيد
قراءة في نصوص منفلتة ومسافات.. محمد آيت علو: "باب لقلب الريح... من أجل كوة فرح"
وكان، ويا ما كان..!
العبارة الأثيرة في السردية العربية، بها تبتدئ الحكاية، ولا تنتهي، إلا بانتهاء الحكي المباح، واستئناف الكلام اللا مباح، المرغوب بذاته، كاكتمال لغواية الحكي...
نبتدئ بها نحن أيضا مقاربة نص عزيز على القلب، قرآناه ونعيد قراءته. رغم بعد المسافة ـ والمسافة مسافات ـ لا يختلف المذاق في الفم، ولا الأثر في القلب. الأحاسيس نفسها، رغم مرور الزمن، وربما تعتقت ببعد المسافة ـ والمسافة مسافات...
كيف يغدو العالم مظلّة صغيرة تجمعنا؟ - نزهة في " ضيف على العالم" لمحمود الريماوي - بسمة الشوالي
عادِ إلّي يْعَجِّزْ في بْلادَهْ غِيرْ إلّي يْعجِّزْ ضِيفْ/ الأبنودي
تمنح قصّة " ضيف على العالم" عنوانها لكامل المجموعة الصادرة في 2017 عن "فضاءات" للنّشر والتوزيع، والمؤلّفة من ثمان وعشرين قصّة، وتقع منها في المرتبة السادسة والعشرين، تليها قصّتا روابط عائليّة و" النائمون الجميلون". وهي إلى ذلك القصّة الطويلة الثانية مقارنة بالبقية التي تقتطع من النفس السرديّ للكاتب عشر صفحات.
آلامُ بوريس باسترناك - د.جودت هوشيار
في منزل باسترناك
قبل عدة اسابيع ، زرت منزل ( الآن متحف ) الشاعر بوريس باسترناك في ( بريديلكينا ) ، بلدة الكتّاب في العهد السوفيتي ، الواقعة في ضاحية موسكو الشمالية. هنا عاش الشاعر بين عامي 1939-1960 . وهنا تلقى نبأ فوزه بجائزة نوبل في الأدب لعام 1958 . وهنا توفي في 30 مايو 1960.
منزل خشبي من طابقين مثل كل منازل البلدة . غرفة نوم ، ومكتب الشاعر ومكتبته الشخصية الثمينة في الطابق الثاني . اثاث البيت متواضع ، ولكن البيانو الأسود العائد لوالدته ، روزاليا باسترناك ، واللوحات الفنية الرائعة ، والصورالمعلقة على جدران غرفة المكتب والصالة – وهي من ابداع والده الفنان الشهير ليونيد باسترناك - تدل على ان الشاعر نَشَأَ وَشَبَّ في اجواء فنية راقية، حيث كان يتردد على منزل العائلة العديد من كبار الفنانين والادباء وبضمنهم الكساندر سكريابين وليف تولستوي.