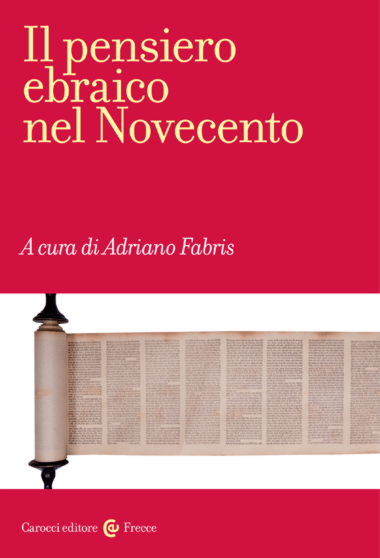منذ 11 شتنبر 2011، ظهرت على السطح مسألة تأثير العامل الديني في النزاعات التاريخية. اليوم، بينما ينخرط المجتمع الغربي في الدنيوية (sécularisation) ينكب كبار المثقفين في دراسة ومناقشة العلاقة التي يقيمها الجنس البشري مع التعالي. فبعد مسار سياسي ملتزم ، يعود ريجيس دوبري إلى جو الدراسات (يدرس حاليا الفلسفة بجامعة ليون 3) ليؤسس علما اجتماعيا جديدا: الميديولوجيا (علم الوسائط. نشر مؤخرا بحثا حول فكرة الله عبر مختلف الحضارات تحت عنوان “الله، بيان رحلة” (مطبوعات أوديل جاكوب).
اما الباحث الأنثربولوجي روني جيرار، الأستاذ منذ مدة طويلة بجامعة ستانفورد الأمريكية، فقد قام بإعادة قراءة المسيحية بواسطة العلوم الاجتماعية. جعلت منه نظريته حول “الرغبة التكيفية” و”كبش الفداء” أحد المفكرين الأكثر أصالة. في كتابه الأخير المعنون “الذي أتت على يده الفضيحة” (مطبوعات ديسلي دوبروار) يعطي خلاصة لأبحاثه. من أجل تسليط بعض الأضواء على مسألة عودة الديني في الوقت الراهن، ارتأت مجلة “لوفيغارو ماغزين” الفرنسية الجمع بين ذينك المفكرين وإثارة الحوار بينهما عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة فكان هذا النقاش الذي نعرض فيما يلي لأهم ما جاء فيه.
الاستلاب الإنساني في شخصية المتدين وتمهيده للتطرف والعنف ـ رسلان جادالله عامر
لا يختلف مفكران في مسألة التناسب الطردي والتفاعل الجدلي بين درجتي المحظورات السلوكية والفكرية والتناقضات الاجتماعية في كل مجتمع من ناحية، وبين هذه وتلك ومستوى التخلف في أي مجتمع من ناحية أخرى!
وفي واقع غارق في التخلف كواقعنا العربي الطافح بالتناقضات والتوترات ليس غريبا أن نجد ذلك الكم الضخم من الحظورات والمحظورات على كافة الصعد، التي يتصدرها بالطبع ثالوث الدين والسياسة والجنس، وهذا ما يجعل مسألة الكتابة والنشر عن أي منها أمرا على درجة عالية من المشقة غالبا، بل والخطر في كثير من الأحيان، وليس من النادر أن يتهرب الناشرون من النشر في هذه المسألة بذرائع شتى تجنبا للعواقب المختلفة، فمثلا عند التوجه إلى ناشر بموضوع حساس يتعلق بالدين أو يمسه، فاحتمال رفض هذا الموضوع بدعوى الابتعاد عن إثارة الحساسيات والنعرات والعصبيات الطائفية وما شابه هو عادة عال، وكأن السكوت عن العيوب الجمة والضخمة في واقعنا الديني هو الموقف السليم والكافي لمعالجة هذه العيوب!
الكنيسة ودانتي أليغييري.. الصّلح خير ـ جانفرانكو رافازي ـ ترجمة : عزالدين عناية
استهلال
جدير أن يحوز دانتي مقاما عليّا في المخيال الإيطالي بوصفه رمزا من الرموز الثقافية البارزة، في بلد كابد لأجل تحقيق وحدته الوطنية، وذلك لما لعبه الشاعر من دور في صياغة هوية إيطاليا اللغوية. فإيطاليا التي قامت على أنقاض ممالك وجمهوريات وإمارات عدة، تبقى مَدينةً لصاحب الكوميديا في نحت لسانها وتوحيده؛ في ذلك المسار العسير الذي دحضت فيه الإيطالية الدانتية، أو بالأحرى إيطالية فلورانسا، سائر الألسن الأخرى، السردينية والنابوليتانية والفريولية واللادينو والأوشيتانية وغيرها كثير، حتى أبقتها في حدود الاستعمالات الضيقة.
وضمن تنافس المتنافسين على دانتي أطلّت كنيسة روما، وإن حصل ذاك متأخرا، في محاولة لاحتضان إرثه الثقافي، رغم أن الرجل أولج بابواتها أبواب البرزخ مثل نيقولا الثالث وبونيفاس الثامن وكليمنت الخامس. فهل هي صحوة كنَسيّة لمراجعة التاريخ أم هي استراتيجية الأمر الواقع؟ صحيح أن دانتي كان كاثوليكيا ولكنه ما كان من أنصار الثيوقراطية وحشْرِ السيفين في غمد واحد، كما رنت الكنيسة طيلة العصور الوسطى، مستلهمة ما ورد في إنجيل لوقا (22: 38): "يا رب ها هنا سيفان". فقد انتقد دانتي الكنيسةَ في مسألتين رئيستين: فساد الإكليروس وغواية السلطة، بوصف فساد المدينة متأت من هذا الزيغ. فالنشيد التاسع عشر من "الكوميديا الإلهية" هو مانيفستو صريح ضد الانحدار الخلقي، منذ أن هلّت "حقبة الفجورقراطية"، أو "حكومة الفاجرات" التي جثمت على الكنيسة، حتى سماهم دانتي بالسيمونيين نسبة إلى الساحر سيمون الوارد ذكره في سفر "أعمال الرسل" لبولس. (المترجم)
من التثاقف الى عمليات المثاقفة، من الأنثروبولوجيا الى التاريخ ـ تقديم وترجمة: أحمد رباص
عادة ما نفهم من كلمة acculturation (ثتاقف أو مثاقفة) تمثل فريق بشري، كليا أو جزئيا، للقيم الثقافية لفريق بشري آخر، وقد تعني لنا على مستوى أصغر أقلمة فرد أو تأقلمه مع ثقافة أجنبية متصل بها. لكن ليس متاحا للجميع القيام بجولة عبر أرجاء السياق العام الذي احتضن نقاشا خصبا ومثيرا في آن لهذا المفهوم بين الباحثين المتخصصين في العلوم الاجتماعية. من أجل القيام بإطلالة على هذا السياق الحافل بالمغامرات، ارتأيت ترجمة مقال سيسيليا كوربو Cécilia Courbot المنشور بموقع الكتروني أكاديمي توجها وطابعا، والذي هذا رابطه: https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2000-1-page-121.htm.
بطريقة مختزلة إلى حد أدنى، تبسيطية تقريبا، يمكن تعريف مصطلح التثاقف أو المثاقفة على أنه صيغة تصف جميع الظواهر والعمليات التي تصاحب اللقاء بين ثقافتين مختلفتين. هذا المصطلح مستمد من الأنثروبولوجيا الأنجلو سكسونية حيث ظهر بالفعل في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، لم يتطور استعماله في العلوم الاجتماعية الا انطلاقا من سنوات الخمسينيات من القرن الماضي.
يطرح مفهوم التثاقف مشكلة مفهوم الثقافة الذي يعد من جذوره. وليس هناك تعريف للثقافة واضح لا لبس فيه. فالتعاريف المقرتحة لمصطلح التثاقف هي إذن متعددة، وهذا صحيح حتى في المجال الذي نشأ فيه المصطلح. وقد أدت المناقشات المختلفة الناتجة عن استخدامه إلى العديد من إعادات التعريف والاحتياطات في استعماله، من دون حل صعوبات التعامل مع هذا المفهوم.
يبقى مصطلح التثاقف هذا مرتبطا بمواضيعية خاضعة للجدل. ويؤدي استخدامه في أغلب الأحيان إلى معالجة مفاهيم سجالية مثل مفاهيم العرق، الإثنية، العلاقة بين المجتمع المهيمن / المجتمع المهيمن عليه، الاستعمار. وهكذا، من أجل إعادة النظر في استخدام هذه الكلمة في مجال التاريخ، كان من الضروري أن نفهم بشكل أفضل تطورها مسبقا في إطارها الأصلي.
التصلّب اللاهوتي وأزمة العقل الكنَسي ـ عزالدين عناية
يشكّل مطلب "الأَجُورْنامِنْتو" (التجديد) تحدّياً عويصاً للمسيحية المعاصرة، بوصفه الرهان الملحّ لإخراج اللاهوت من ربقة البراديغم القروسطي وولوج عصر الحداثة، بعد أن باتت الكنائس خاوية والساحات عامرة، كما يتردد في أوساط المراقبين للشأن المسيحي. فمنذ اعتلاء البابا بنديكتوس السادس عشر (جوزيف راتسينغر) كرسي البابوية، وإلى حين تخلّيه المباغت والصادم عن مهامه في الثامن والعشرين من فيفري 2013، تمحورَ هاجسُه في الإلحاح على خوض غمار تحوير مؤسسة الكنيسة. بقصد تحريرها من براثن المؤسساتية الطاغية وجهازها البيروقراطي الجاثم، الذي يوشك أن يخنق روح الدين، كما أوضح راتسينغر في كتابه "نور العالم" (روما، 2010). بعد أن تحوّلت الكنيسة إلى مؤسسة دنيوية متلهفة على الربح والسطوة والجاه. فقد لمس راتسينغر، خلال فترة بابَويته، أزمة الكنيسة، الأمر الذي جرّه إلى أن يعلن أمام الكوريا الرومانية -هيئة كبار الكرادلة- قبل اتخاذ قرار الاستقالة "إن جوهر أزمة الكنيسة هي أزمة لاهوتية. وفي حال تعذّر إيجاد حلول، وعدم استعادة الإيمان حيويته، لِيصبح قناعة عميقة وقوة حقيقية بفضل اللقاء مع يسوع المسيح، فإن مجمل الترقيعات الأخرى لا معنى لها".
حفريات في الفكر اليهودي المعاصر - عزالدين عناية
شهد الفكر اليهودي إبان الفترة الحديثة تحولات جذرية تغيرت على إثرها براديغمات النظر للذات وللعالم، وذلك مقارنة بما ساد طيلة الفترة القديمة الموسومة بسيطرة الرؤى التلمودية وهيمنة شروحات الأحبار، أو كذلك بما ساد على مدى الفترة الكلاسيكية المتأثرة بأجواء الحضارة العربية الإسلامية، ولا سيما التأثر بالجدل العقائدي والمذاهب الكلامية وبوادر تشكل رؤى "الاعتزال" اليهودي، التي بدت ملامحها مع ابن عزرا الغرناطي (ت. 1167م) والسّموءل بن يحيى المغربي (1130-1174م) وموسى بن ميمون (1135-1204م)، إلى أن تلقّفها باروخ سبينوزا مع بداية التحول الفكري اليهودي الحديث خصوصا في كتابه "رسالة في اللاهوت والسياسة". غير أن الصرامة العقلية المبكرة لسبينوزا، في زمن مازال فيه الفكر اليهودي محكوما بطابع المحافَظة، كلّفه طردا من الجماعة السيفاردية بوصفه خارجا عن الملّة. في حين جاءت براديغمات النظر التي طبعت الفكر اليهودي الحديث متأثرةً بأوضاع العالم الأوروبي، وبقضايا التنوير، وفكر الحداثة، وأجواء العلمنة والبحث عن اندماج في المجتمعات الحديثة, وانعكست تلك المؤثرات على رؤى المفكرين اليهود وعلى علاقتهم بالإرث الديني.
الخلدونية والمكيافيلية وإشعاع فكر وسيط في المتوسط ـ عبد السلام انويكًة
في البحث والدراسة والنقاش العلمي والذاكرة..، يحضر ابن خلدون كأحد أعلام تراث عربي اسلامي وكوني شامخ، ويحضر كجرأة علمية وتحليلِ عَالِمٍ لا يزال مثار أسئلة بهيبة معبرة في حقول معرفيةٍ انسانيةٍ عدة ومتداخلة. ولعل هذا العلامة المؤرخ هو القرن الرابع عشر والعالم العربي الإسلامي ومجمل ما عرفه حوض المتوسط من تحولات على أكثر من صعيد، وهو التاريخ والعقل والذاكرة والذكاء والدهاء السياسي... أخذ العلم فتوفق وفاض علماً وطلب السياسة فاعتلى مناصب وتعرض لِما تعرض من حسدٍ وسجنٍ..، وارتحل شرقاً وغرباً وركب مخاطر بحر وقصد مصر والشام والقدس والحجاز... وعندما يذكر ابن خلدون تذكر مُقدمته التي اشتهر بها واشتهرت به، كعمل علمي أثار عناية كل فئات مجتمع البلاد العربية الإسلامية والعالم، فأحيط ولا يزال بكثير من الدراسة والبحث والجدل... هو تونسي مولداً (1332 م) بوسط أسري كان بأثر بليغ في تكوينه، بكيفية خاصة والده الذي كان محبا للأدب والعمل السياسي ما جعله أول أساتذته. وبقدر قيمة تميزات حياته ومنهجه وفلسفته في الحياة، بقدر ما كان بأثر في مجال تماساته تحديداً حوض المتوسط، من خلال ما كان عليه من إشعاع علمي وعلاقات ودرجة تواصل وتأثير بين أطراف وعاء بحري عميق الحضارة، ما كان بصدد تحولات دقيقة وعميقة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، حيث معالم نهضة في ضفة شمالية ومظاهر انحطاط وضعف في ضفة جنوبية.
الإنتاج الفلاحي خلال الفترة الوطاسية :جوانب من تفاعلات المغاربة مع المناخ والمجال ـ فخرالدين القاسمي
تعددت الأنشطة الفلاحية بمغرب الفترة الوطاسية، ولاشك بأن للمجال الطبيعي تأثيرا واضحا في توزيعها؛ فالتضاريس والمعطيات المناخية تحدد وتوجه نشاط الإنسان، والتربة والشبكة المائية تفرضان توجها فلاحيا معينا ، والإنسان بمهارته يحاول التأثير على شكل المعطيات، والتكيف معها، والإستفادة منها، أو عكس ذلك يسخرها دون أدنى مجهود واضح لإستغلال المعطيات ذاتها إستغلالا ناجعا. ان الأقاليم الفلاحية كانت تتبع الأشكال التضاريسية دون أن يكون هناك تخصص تام؛ فالمناطق المرتفعة تعاطت خاصة لتربية الماشية، كما تواجدت بها الأشجار المثمرة، أما التلال فكانت تحمل الكروم خاصة، كما كانت بها بعض الحقول تقام بها بعض الزراعات، أما الأودية فتعاطى فيها للزراعة وتربية الماشية من أبقار وخيول، إضافة إلى تعاطي قاطنيها للزراعات الشجرية المثمرة، أما المناطق السهلية فكانت تزرع بها الحبوب والقطاني من فول وعدس وكذلك الكتان، كما كانت تربى بها الماشية. وعاشت هذه المناطق السهلية بالواجهة الأطلنتية تحت رحمة المغيرين البرتغال. لقد تدخلات عوامل طبيعية ومناخية وسياسية وثقافية في نوعية الأنشطة الفلاحية الممارسة خلال الفترة الوطاسية، كما تحكمت في مقادير المحاصيل(المردودية)، وفي توزيع خريطة الإنتاج، وكذا في تغليب بعض الأنشطة عن أخرى. إذ لم تكن الظروف الطبيعية والمناخية في معظم الأحيان المسؤول الوحيد عن تردي الإقتصاد الفلاحي، والذي يمكن إرجاعه إلى البنية الإجتماعية والعقارية والذهنية أكثر منها إلى التغييرات المناخية، المتسببة كذلك في تقلص المساحات المزروعة.
ومن أهم العناصر المناخية والمجالية المتحكمة نجد:
· المناخ .