 إن ما يميز الممارسة الفلسفية هو التأمل والتفكير في كل شيء حتى في التفكير نفسه، وما دام الأمر كذلك فسيكون من المشروع أن نفكر في طبيعة التفكير الفلسفي، وبالخصوص "الدرس الفلسفي" وهو ما نروم معالجته من خلال هذه الأسطر. فكيف يتفاعل المتعلم مع هذا الدرس؟ ما طبيعة لقائه الأول مع الفلسفة؟ما هي تمثلاته القبلية حولها؟ ما هي مقومات هذا النوع من التفكير وإلى أي حد تسهم الظروف المحايثة في ممارسته بالشكل اللائق؟وما مدى مساهمة هذا النمط من التفكير في خلخلة الأفكار والمواقف وتصحيحها ومن ثم خلق تلك الشخصية المتأملة،الناقدة،والحائرة والمندهشة بالمعنى الفلسفي؟
إن ما يميز الممارسة الفلسفية هو التأمل والتفكير في كل شيء حتى في التفكير نفسه، وما دام الأمر كذلك فسيكون من المشروع أن نفكر في طبيعة التفكير الفلسفي، وبالخصوص "الدرس الفلسفي" وهو ما نروم معالجته من خلال هذه الأسطر. فكيف يتفاعل المتعلم مع هذا الدرس؟ ما طبيعة لقائه الأول مع الفلسفة؟ما هي تمثلاته القبلية حولها؟ ما هي مقومات هذا النوع من التفكير وإلى أي حد تسهم الظروف المحايثة في ممارسته بالشكل اللائق؟وما مدى مساهمة هذا النمط من التفكير في خلخلة الأفكار والمواقف وتصحيحها ومن ثم خلق تلك الشخصية المتأملة،الناقدة،والحائرة والمندهشة بالمعنى الفلسفي؟
لعل أهم ما تُعلمنا إياه الفلسفة هو التفكير والصرامة المعرفية. فهل عندما ندرُس الفلسفة نصل إلى عمقها أم نظل قابعين في السطح؟ هل نأخذ من الفلسفة عمقها وحقيقتها أم الحقيقة كما يراها الناس عنها؟ إن ما يمنع المتعلم من الإمساك بناصيتها هو تمثلاته المسبقة الجاهزة والمطلقة،التي يأتي محملا بها والتي غالبا ما تكون ضدها. إضافة إلى ذلك فهو يسمع أفكار جديدة ومفاهيم جديدة لأول مرة،مجردة في أغلبها،وتمس مواقفه وذاته كإنسان وكموجود أيضا (العقل،الميتافيزيقا،النسبية،الإطلاق،الوعي،اللاوعي،الإيديولوجيا...).هذا النوع من التجريد ربما يصادفه لأول مرة،واختلاف المواقف أيضا وتضاربها؛ فهو دائما تعوّد أن لا يرى إلا رأيا واحدا،بينما هذا الفكر يتيح له امكانية الانفتاح على مواقف متعددة حول الموضوع الواحد،وإن كان هذا مفيدا في شيء فإنما سيكون مفيدا من حيث الحث على التفكير والدعوة إلى اجتناب الفكر الوثوقي. لكن هل هذا فعلا ما يصل إليه المتعلم؟ لقد تربى على الحفظ،ويحاول التعامل مع المادة بالكيفية نفسها التي يتعامل بها مع باقي المواد، وهذا غير ممكن، خصوصا وأنها مما يُحتاج له ولا يحتاج لغيره،فالمفروض أن يعينك المنهج والطريقة الفلسفية على التعامل مع باقي المواد كما هو الأمر مع الحياة بشكل عام.
جَاذبيَّة المَدرسة ـ اسماعيل العمري
 كثيراً ما يكون خبرُ تغيب الأستاذ نبأ تنتشي به جماعة الفصل، أو بداية العطلة الدراسية مناسبة تعدُّ أيام اقترابها على رؤوس الأصابع،حيثُ الانتظار على احرِّ من الجمر و كثيرا ما يكون انصرام أيامها جحيماً لايطاقُ حيث السّاعات و الدقائقُ تعدو ثواني تمر بسرعة البرق.علَّ هذا الشعورَ بالتخلص من جو المدرسة أو الفصل يضمرُ وراءه عوامل و مسببات قد يكون الأستاذ و المؤسسة و الأسرة و المجتمعُ قوى فاعلة في تشكيله لدى المتعلم .هل يعني ذلك بأن المدرسة فاقدة للجاذبية المطلوبة؟هل للأستاذ نصيب وافرٌ في نفور المتعلم من المدرسة؟هل المجتمعُ استقلَ من دوره التعبوي والتَّوعَوِي بأدوار ألمدرسة. ماذا عن الأسرة التي جعلت من المدرسة مكاناً للتخلص من أبنائها ،هل فعلا الأسرة تسير في اتجاه ما تريده المدرسة ؟ علّها أسئلة نتاج تجربة متواضعة كتلميذ و كفاعل في الحقل التربوي سأحاول الاجابة عنها واحدة تلوى الاخرى.
كثيراً ما يكون خبرُ تغيب الأستاذ نبأ تنتشي به جماعة الفصل، أو بداية العطلة الدراسية مناسبة تعدُّ أيام اقترابها على رؤوس الأصابع،حيثُ الانتظار على احرِّ من الجمر و كثيرا ما يكون انصرام أيامها جحيماً لايطاقُ حيث السّاعات و الدقائقُ تعدو ثواني تمر بسرعة البرق.علَّ هذا الشعورَ بالتخلص من جو المدرسة أو الفصل يضمرُ وراءه عوامل و مسببات قد يكون الأستاذ و المؤسسة و الأسرة و المجتمعُ قوى فاعلة في تشكيله لدى المتعلم .هل يعني ذلك بأن المدرسة فاقدة للجاذبية المطلوبة؟هل للأستاذ نصيب وافرٌ في نفور المتعلم من المدرسة؟هل المجتمعُ استقلَ من دوره التعبوي والتَّوعَوِي بأدوار ألمدرسة. ماذا عن الأسرة التي جعلت من المدرسة مكاناً للتخلص من أبنائها ،هل فعلا الأسرة تسير في اتجاه ما تريده المدرسة ؟ علّها أسئلة نتاج تجربة متواضعة كتلميذ و كفاعل في الحقل التربوي سأحاول الاجابة عنها واحدة تلوى الاخرى.
الأستاذ شخصٌ منَفِّرٌ أم محَبّْبٌ.
يحتل الأستاذ مكانة و مرتبة عالية داخل الوسط المدرسي نظرا للمهمة الملقاة على عاتقه من جهة و الدور الذي يلعبه في علاقته بالمتعلم حيث يشكل بالنسبة لديه مصدر المعرفة و مصدر تغذية الجانب الأخلاقي و الوجداني و السيكولوجي…،فمهمة الأستاذ أو المدرس تنطلق من داخل القسم إلى خارجه ،في تجاوز للدور المعرفي إلى ماهو تربوي ،حيث يغدو الأستاذ مصدر إلهام للمتعلم و نموذجه الذي يحتذي به في التربية و الأخلاق في محاولة إزالة الصورة النمطية التي تحبسُ الأستاذ في قوقعة التلقين و الإلقاء الفج.إن ممارسة المدرس لدوره المعرفي و التربوي في آن واحد لن يتأتى إلا من خلال جانبين أساسين :
مشروع المؤسسة : خطوة نحو إرساء المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج ـ المختار شعالي
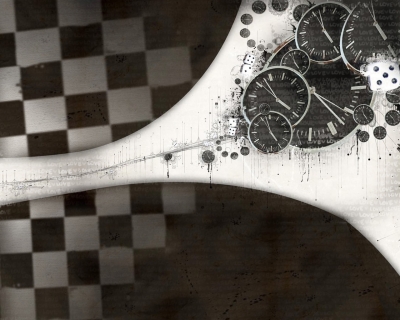 أصدرت وزارة التربية الوطنية بالمغرب بلاغا صحفيا، تحث عنوان ‹‹مشروع المؤسسة خطوة نحو إرساء المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج وتحسين جودة التعلمات››. ويشير هذا البلاغ إلى أن الوزارة أعطت الانطلاقة الرسمية يوم 20 فبراير 2014 لأجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة. اعتمدت إذن الوزارة مشروع المؤسسة كخيار استراتيجي يجعل من المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية. ‹‹ويهدف مشروع المؤسسة إلى إرساء أسس الحكامة الجيدة وسياسة القرب والمقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج›› (البلاغ). ما هو مشروع المؤسسة؟ ما هي المقاربة التشاركية؟ وما هو التدبير بالنتائج؟
أصدرت وزارة التربية الوطنية بالمغرب بلاغا صحفيا، تحث عنوان ‹‹مشروع المؤسسة خطوة نحو إرساء المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج وتحسين جودة التعلمات››. ويشير هذا البلاغ إلى أن الوزارة أعطت الانطلاقة الرسمية يوم 20 فبراير 2014 لأجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة. اعتمدت إذن الوزارة مشروع المؤسسة كخيار استراتيجي يجعل من المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية. ‹‹ويهدف مشروع المؤسسة إلى إرساء أسس الحكامة الجيدة وسياسة القرب والمقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج›› (البلاغ). ما هو مشروع المؤسسة؟ ما هي المقاربة التشاركية؟ وما هو التدبير بالنتائج؟
ما هو مشروع المؤسسة؟
مشروع المؤسسة هو خطة عمل تحدد كل الأنشطة والوظائف والمهام التي تقدم عليها المؤسسة، وتبلورها على شكل أهداف وبرامج للعمل بناء على استراتيجية تنمية النظام التربوي المحلية الذي تحددها المؤسسة في ضوء الإطار الاستراتيجي التربوي الأكاديمي والمركزي. ويشارك في تحديد مشروع المؤسسة كل المجموعة التربوية (هيئة التدريس والأطر الإدارية والتربوية وهيئة التوجيه وجمعية الآباء والتلاميذ..) ويساهم في ذلك أيضا الشركاء الخارجيين (الجماعات الترابية، السلطات الأكاديمية، مراكز التوجيه والإعلام، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة...). إنه إذن رؤية جماعية تروم الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المدرسة.
الدماغ يتعلم.. ـ حميد بن خيبش
 لم يخل مسار الفكر البشري من إشارات دالة بشأن قابلية الدماغ للنمو والتعديل والإثراء,وإن ظلت هذه الإشارات حبيسة التخمين والحدس الذي تعوزه وسائل التحقق المخبري.لقد دافع سقراط عن فكرة أن الإنسان يمكنه أن يدرب عقله كما يدرب الرياضي عضلاته,وهو ينطلق من التصور السائد لدى الإغريق آنذاك بأن الطبيعة كائن حي ضخم. وفي سنة 1762 تصدى الفيلسوف السويسري جان جاك روسو للنزعة الميكانيكية التي اعتبرت أجهزتنا العصبية آلات رائعة تقوم بوظائف استثنائية لكنها غير قابلة للتغيير أو الاستبدال,وتمسك بمقولة أن الطبيعة حية وتتغير مع الزمن, وبأن بالإمكان تمرين حواسنا وقدراتنا العقلية تماما كما نفعل بالنسبة لعضلاتنا:" ينبغي علينا أن نعنى برياضة جميع الحواس التي توجه قوانا وتهديها,ويجب أن نستخلص من كل حاسة من حواسنا أقصى ما تستطيعه, ثم نُقوم تأثير كل حاسة في الحواس الأخرى.ولا ينبغي أن نستخدم قوة من قوانا من غير حساب دقيق للمقاومة وللمجهود,وليكن رائدنا أن يسبق تقدير الأثر استخدام الوسيلة"(1).
لم يخل مسار الفكر البشري من إشارات دالة بشأن قابلية الدماغ للنمو والتعديل والإثراء,وإن ظلت هذه الإشارات حبيسة التخمين والحدس الذي تعوزه وسائل التحقق المخبري.لقد دافع سقراط عن فكرة أن الإنسان يمكنه أن يدرب عقله كما يدرب الرياضي عضلاته,وهو ينطلق من التصور السائد لدى الإغريق آنذاك بأن الطبيعة كائن حي ضخم. وفي سنة 1762 تصدى الفيلسوف السويسري جان جاك روسو للنزعة الميكانيكية التي اعتبرت أجهزتنا العصبية آلات رائعة تقوم بوظائف استثنائية لكنها غير قابلة للتغيير أو الاستبدال,وتمسك بمقولة أن الطبيعة حية وتتغير مع الزمن, وبأن بالإمكان تمرين حواسنا وقدراتنا العقلية تماما كما نفعل بالنسبة لعضلاتنا:" ينبغي علينا أن نعنى برياضة جميع الحواس التي توجه قوانا وتهديها,ويجب أن نستخلص من كل حاسة من حواسنا أقصى ما تستطيعه, ثم نُقوم تأثير كل حاسة في الحواس الأخرى.ولا ينبغي أن نستخدم قوة من قوانا من غير حساب دقيق للمقاومة وللمجهود,وليكن رائدنا أن يسبق تقدير الأثر استخدام الوسيلة"(1).
غيرأن العلماء,متأثرين باكتشافات غاليليو(1642-1564), سيعممون تصوره بشأن القوى الميكانيكية التي تحرك الكواكب على الطبيعة والكائنات الحية,بل حتى على أعضائنا الجسدية.وعلى امتداد حقبة طويلة ستصبح العدمية العصبية مقاربة وحيدة لعمل الدماغ والجهاز العصبي,وسيردد التلاميذ حتى أوائل الستينات أن رحلة الدماغ من الميلاد إلى الوفاة تتلخص في فقدانه يوميا لمائة ألف خلية عصبية غير قابلة للتعويض أوالاستبدال,وأن الذكاء محدد منذ الولادة ولا سبيل لتعديله خلال مراحل الحياة!
التكوين المستمر وتحليل الحاجات ـ ذ. محمد الجيري
 التكوين مطلب مجتمعي ومقوم من مقومات التنمية الاجتماعية، يروم تأهيل الإنسان وإحداث تغييرات إيجابية على مستوى معارف ومهارت واتجاهات فرد أو مؤسسة. ولما باتت مسألة أهمية العنصر البشري في كل مشروع تنموي في حكم المؤكد البديهي، فإن تأهيل هذا العنصر والرفع من أدائه باستمرار لن يتأتى إلا بفضل ممارسة التكوين ممارسة عملية وموجهة لتلبية حاجات المؤسسة المدرسية والاستجابة لخصوصيتها في ظل محيط يتسم بالديناميكية والتطور.
التكوين مطلب مجتمعي ومقوم من مقومات التنمية الاجتماعية، يروم تأهيل الإنسان وإحداث تغييرات إيجابية على مستوى معارف ومهارت واتجاهات فرد أو مؤسسة. ولما باتت مسألة أهمية العنصر البشري في كل مشروع تنموي في حكم المؤكد البديهي، فإن تأهيل هذا العنصر والرفع من أدائه باستمرار لن يتأتى إلا بفضل ممارسة التكوين ممارسة عملية وموجهة لتلبية حاجات المؤسسة المدرسية والاستجابة لخصوصيتها في ظل محيط يتسم بالديناميكية والتطور.
ولأن كل مشروع تكويني يخلف آثارا إيجابية في مجموعة أفراد ما يجعلهم أكثر كفاية ومقدرة لأداء مهامهم من خلال تكوين عادات فكرية وعملية مناسبة واكتساب خبرات جديدة، فإن الدافع الى الاستثمار في التكوين لن يكون سوى تحقيق التأقلم والتكيف مع التطورات والتحولات الداخلية والخارجية.
التربية الجديدة، مغامرة تستحق أن نعيشها مرة أخرى : فيليب ميريو- ت. محمد أبرقي
 لم تفِ البيداغوجيات البديلة دائما بوعودها،غير أنه بتأكيدها على دور التحفيز واللذة في فعل التعلم،قد أثارت،واستبقت عددا مهما من الأبحاث الحالية.
لم تفِ البيداغوجيات البديلة دائما بوعودها،غير أنه بتأكيدها على دور التحفيز واللذة في فعل التعلم،قد أثارت،واستبقت عددا مهما من الأبحاث الحالية.
وعلى الرغم من أننا نستطيع تمييز البدايات الأولى لحركة التربية الجديدة منذ القرن الثامن عشر، فإنها لم تتهيكل سوى مع المراحل المبكرة في القرن العشرين .
إننا نرى فعلا في سنوات التسعينات، تطورا لمبادرات بيداغوجية أصيلة على هوامش الأنظمة التربوية،والتي انتظمت حول بعض المبادئ الأساس: “يتعلم الطفل بالممارسة” ، “ينبغي تعبئة التلاميذ حول مشاريع حقيقية تماثل ما هو موجود في الحياة” ،”تُكتسب المعارف بطريقة طبيعية-عفوية وليس عبر سلطة البرامج”،” ينبغي للقواعد والمادة نفسها أن تنبع من الجمعي ذاته بهدف تكوين مواطنين حقيقيين” ...إلخ.هكذا تكون نوع من المذاهب ، وترسخت خلال مؤتمرCalais سنة 1921 ، مع الإعلان الرسمي عن العصبة الدولية للتربية الجديدة .
برزت التربية الجديدة- داخل قارة أوربا التي أنهكتها الحرب العالمية الاولى، وصارت تطمح إلى بناء مجتمع الأخوة- كترياق ضد كل أشكال “الترويض” المنتجِة للعدوانية والعنف،وازداد الاتفاق حول التربية الجديدة قصد انتقاد “البيداغوجيات التقليدية”،ورغم ذلك فإن تلك التربية الجديدة بعيدة عن أن تكون منسجمة:
في الحاجة إلى التربية الموسيقية ـ حسن أوزال
 "لَوْلاَ الموسيقى ، لَغَدَتِ الحياةُ خطأ" نتشه
"لَوْلاَ الموسيقى ، لَغَدَتِ الحياةُ خطأ" نتشه
"إني لا أعرف إلا معارضة واحدة وحقيقية، هي معارضة مؤسسات بؤس الحياة للمؤسسات الثقافية" نتشه
لا مراء أن المغرب، هُوَّ مَنْ يُعاني مؤخرا، أكثر من أي وقت مضى، أزمة كبيرة على مستوى التعليم ومحاربة الأمية، ولا أدل على ذلك، من تلك المراتب المتأخرة التي صار يحتلُّها ضمن قوائم العديد من التقارير الدولية، حيث تقهقر حسب المؤشر العالمي للتنمية البشرية من الرتبة 126 سنة 1999، إلى الرتبة 129 سنة 2014. أما فيما يخص تَمَوْقُعه في التصنيفات العالمية لأنظمة التربية و التكوين و البحث العلمي، وبخاصة منها، التصنيف العالمي للجامعات المعروف بـ“تصنيف شنغاي” والذي يعتمد أساسا على المنشورات العلمية ، فالمعلوم أن أول جامعة مغربية و هي القاضي عياض، قد جاءت في المرتبة 3962 من ضمن 5000 جامعة.وأمام هذا الوضع الكارثي ، يمكننا التوكيد على أن ما يثير الاستغراب بالرغم من ذلك، إنما هو أننا كلما تساءلنا عن السبب، الكامن وراء هذا التقهقر، والتخلف الذي أصاب البلد إلا وجاءنا الجواب مُطَمْئِنا، على لسان أصحاب الحال، ومدبري الأحوال، سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين، رجال تربية أو فرسان بيداغوجيا، بدعوى أن الأزمة هي مجرد هفوات تقنية و خلل في التدبير، يقتضيان فقط، التدخل على نحو سريع تعديلا للبرامج المُقرَّرَة أحيانا(على نحو سطحي، من قبيل إضافة مواد تافهة لأخرى أكثر تفاهة) و استبدالا شكليا لمنهج بآخر أحيانا أخرى. هكذا، وعلى إثر هذه المواقف الهجينة و المتذبذبة ، تم اللجوء إلى إجراء إصلاحات فوقية لا تمس جوهر المشكل، بحيث تقرر الانتقال من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الإدماج، مثلما جرى بعدئذ العمل بالبرنامج الإستعجالي(بل هو بالأحرى مجرد إصلاح تقني بطيء الوتيرة) الذي رُصِدت له أموال طائلة(بدل أن ترصد بالأحرى، للبنية التحتية المتدهورة، والوضع الاجتماعي الفقير لرجال التعليم) لينتهي الأمر بالتخلي عنه فيما بعد.
وأمام هذه العشوائية في اتخاذ القرارات ، طبعا لا يمكن للأوضاع إلا أن تزداد سوءا، سيما لما تقرر مرة أخرى، إدراج اللغة الأمازيغية كمادة أساسية ضمن المنهاج التربوي، وذلك دونما التوفر حتى على ما يكفي من المدرسين . وفي هذا الإطار، فنحن اليوم ، لا نملك بكل صراحة إلا أن نتأسف على نظامنا التعليمي المفلس، الذي بسببه بتنا نتخلف حتى عن بعض الدول الموجودة في حالة حرب.
التوجيه التربوي أداة للتفكير في المآل ـ المختار شعالي
 ينحصر دور مدرستنا في اكتساب مجموعة من المعارف في مجالات متعددة انطلاقا من الاعتقاد أن امتلاك هذه المعرفة المجردة يمكن الأفراد من النجاح في الحياة. غير أن هذا المنظور قد تعرض منذ مدة لانتقادات متعددة ... وتتمثل أهم هذه الانتقادات في كون التلاميذ لا يدركون العلاقة بين ما يتعلمونه في المدرسة وما سيقومون به في الحياة بعد تخرجهم من النظام التعليمي. كما لا يجدون مغزى لوجودهم في المدرسة، ولا معنى للدروس التي تعطى لهم، كونها غير مرتبطة بحاجاتهم إلى فهم ذواتهم ومحيطهم والمآل، وبالتالي فإنها غير جديرة بالاهتمام وغير محفزة على التعلم.
ينحصر دور مدرستنا في اكتساب مجموعة من المعارف في مجالات متعددة انطلاقا من الاعتقاد أن امتلاك هذه المعرفة المجردة يمكن الأفراد من النجاح في الحياة. غير أن هذا المنظور قد تعرض منذ مدة لانتقادات متعددة ... وتتمثل أهم هذه الانتقادات في كون التلاميذ لا يدركون العلاقة بين ما يتعلمونه في المدرسة وما سيقومون به في الحياة بعد تخرجهم من النظام التعليمي. كما لا يجدون مغزى لوجودهم في المدرسة، ولا معنى للدروس التي تعطى لهم، كونها غير مرتبطة بحاجاتهم إلى فهم ذواتهم ومحيطهم والمآل، وبالتالي فإنها غير جديرة بالاهتمام وغير محفزة على التعلم.
ذلك أن التفكير في النجاح في الحياة المدرسية والتفكير في النجاح في الحياة المهنية في المستقبل يحدثان في أوقات منفصلة، حيث لا يتم التفكير في المستقبل إلا أثناء عتبات التوجيه أو بعد نهاية التمدرس، إذ يجد الفرد نفسه أمام نقص كبير في معرفة ذاته وحاجاته واهتماماته ومعرفة الإمكانات المتوفرة في محيطه والتطورات الحاصلة فيه، ونقص في تراكم تجارب وقدرات وخبرة في بلورة مشروع في التوجيه وفي الحياة.
الرصيد الاصطلاحي لمفاهيم التقويم الذاتي ـ مراد ليمام
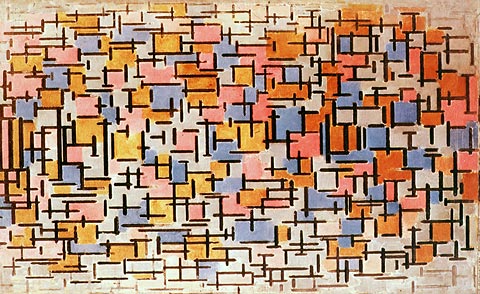 يقترح الباحثون مجموعة من المفاهيم نستطيع من خلالها الربط بين تعاريف المصطلحات والمجال البيداغوجي الذي تتأسس عليه كل مقاربة للتقويم التكويني تستهدف إشراك المتعلم بجعله فاعلا في سيرورة التقويم . "فالمعارف الموجودة بمجال معطى تنتظم وتصطف انطلاقا من رصيد اصطلاحي يغطي مجموع المفاهيم المرتبطة" (1) . لذلك كان الوعي بهذه المقاربة يقتضي التحكم بالرصيد الاصطلاحي والفهم الجيد له والتوظيف المفاهيمي الخاص بالمقاربة . من هنا ركزنا على أهم المصطلحات التي بدت لنا ضرورية لتعميق فهمنا ووعينا بهذه المقاربة:
يقترح الباحثون مجموعة من المفاهيم نستطيع من خلالها الربط بين تعاريف المصطلحات والمجال البيداغوجي الذي تتأسس عليه كل مقاربة للتقويم التكويني تستهدف إشراك المتعلم بجعله فاعلا في سيرورة التقويم . "فالمعارف الموجودة بمجال معطى تنتظم وتصطف انطلاقا من رصيد اصطلاحي يغطي مجموع المفاهيم المرتبطة" (1) . لذلك كان الوعي بهذه المقاربة يقتضي التحكم بالرصيد الاصطلاحي والفهم الجيد له والتوظيف المفاهيمي الخاص بالمقاربة . من هنا ركزنا على أهم المصطلحات التي بدت لنا ضرورية لتعميق فهمنا ووعينا بهذه المقاربة:
1ـ التقويم الذاتي (L’Auto-évaluation):
يراد به تقويم العمل الذي أنجزه المتعلم و الذي يقوم بمراقبة نفسه - طيلة مراحل الفعل - وإلى أي حد يتوافق إنتاجه مع مواصفات الإنتاج ، انطلاقا من نظام داخلي يقوده المتعلم نفسه أثناء فعله . حيث يقارن "التصميم المتبع بالتصميم المقترح ، المنتوج المحصل عليه بالصورة الأولية (L’image Intiale) للمنتوج ، العمليات المنجزة بالأفكار التي ترسم طريقة الفعل بكل عملية . إنه نشاط تعديلي ذاتي يتوقف نجاحه على مدى تماسك النموذج الداخلي للمقوّم والجهاز التقويمي الموظف"(2).
الجامعة و الفلسفة و إشكالية تغيير الواقع ـ المسعودي محماد
 هي القمة التي يلتقي فيها كل شيء لصالح الحضارة الأخلاقية ، حيث يزدهر التعليم في معناه الأعمق للكلمة ، وهي أيضا المدينة العلمية ، و مصير المعرفة داخل المجتمع مرتبط بمصيرها ، كونها مكرسة لحضارة العقل ، إنها الجامعة التي لم تكن فكرة إنشائها رديئة .
هي القمة التي يلتقي فيها كل شيء لصالح الحضارة الأخلاقية ، حيث يزدهر التعليم في معناه الأعمق للكلمة ، وهي أيضا المدينة العلمية ، و مصير المعرفة داخل المجتمع مرتبط بمصيرها ، كونها مكرسة لحضارة العقل ، إنها الجامعة التي لم تكن فكرة إنشائها رديئة .
فالجامعة و منذ نشأتها و حتى اليوم مرت بمتغيرات عدة على مستوى البنيات و الوظائف ، فبالرغم من أن إرث الأكاديمية الأفلاطونية ، و كذا الجامعة القروسطية ظهر بشكل جلي في ملامح الجامعة الحديثة ، إلا أن جامعة ما بعد الحداثة ستعرف تطورا منقطع النظير مع مرور الزمن ، هذا التطور الذي شهدته الجامعة سيكسبها خصائص معينة ، بحيث ستصبح مكانا للامتياز العقلي، و المعرفة الموضوعية ، و فضاء متميزا لجميع و مختلف التيارات الفكرية ، حيث يسود النقاش و الاختلاف . هذه الخصائص و السمات ستصير من محددات هوية الجامعة الجديدة ، التي ستشكل المنطق الخاص المتحكم في بنياتها و صيرورة تطورها .
- إذا كانت الجامعة في الدول المتقدمة تضطلع بمهام متعددة ، في مقدمتها صناعة الإنسان و تغيير الواقع ، إلى جانب المهام الكلاسيكية المتمثلة في التكوين و البحث العلمي ، فإن الجامعة عندنا فشلت تقريبا في الكثير من الوظائف المنوطة بها ، فهي تختزل جميع العناصر المكونة لازمة النظام التعليمي .
المعلّم ومهام التربية على المواطنة البيئيّة ـ عبدالله عطيّة*
 التربية مشغل مجتمعيّ حسّاس ودقيق ،وحساسيته مردّها انتظارات المجموعة الوطنيّة منه في كلّ قطر، ولذلك فالاستثمار في المعرفة اليوم رهانٌ تتنافس من أجله الأمم والشعوب ،ويُباهي بإنجازاته بعضُها البعضَ، فضلا على أنّ مقياس رقيّ المجتمعات أضحى تربويّا ومعرفيّا. فالتربية مدرسيّة مثلما هو معلوم ،والمدرسة هي المؤسّسة المُناط بعهدتها وظائف ثلاث :الوظيفة التربويّة والوظيفة التعليميّة والوظيفة التأهيليّة ،أمّا عن الوظيفة الأولى فتتمثل في "تربية الناشئة على الأخلاق الحميدة والسّلوك القويم وروح المسؤوليّة والمبادرة ،وهي تضطلع على هذا الأساس :
التربية مشغل مجتمعيّ حسّاس ودقيق ،وحساسيته مردّها انتظارات المجموعة الوطنيّة منه في كلّ قطر، ولذلك فالاستثمار في المعرفة اليوم رهانٌ تتنافس من أجله الأمم والشعوب ،ويُباهي بإنجازاته بعضُها البعضَ، فضلا على أنّ مقياس رقيّ المجتمعات أضحى تربويّا ومعرفيّا. فالتربية مدرسيّة مثلما هو معلوم ،والمدرسة هي المؤسّسة المُناط بعهدتها وظائف ثلاث :الوظيفة التربويّة والوظيفة التعليميّة والوظيفة التأهيليّة ،أمّا عن الوظيفة الأولى فتتمثل في "تربية الناشئة على الأخلاق الحميدة والسّلوك القويم وروح المسؤوليّة والمبادرة ،وهي تضطلع على هذا الأساس :
- بتنمية الحسّ المدنيّ لدى الناشئة وتربيتهم على قيم المواطنة...
- بتنمية شخصيّة الفرد بكلّ أبعادها الخلقيّة والوجدانيّة والعقليّة والبدنيّة..
- بتنشئة التلميذ على احترام القيم الجماعيّة وقواعد العيش معا.."









