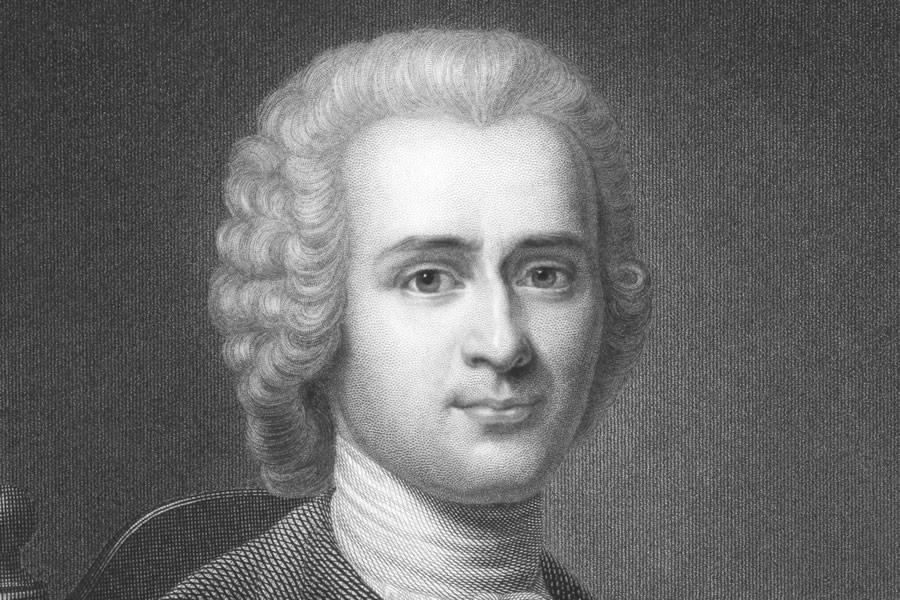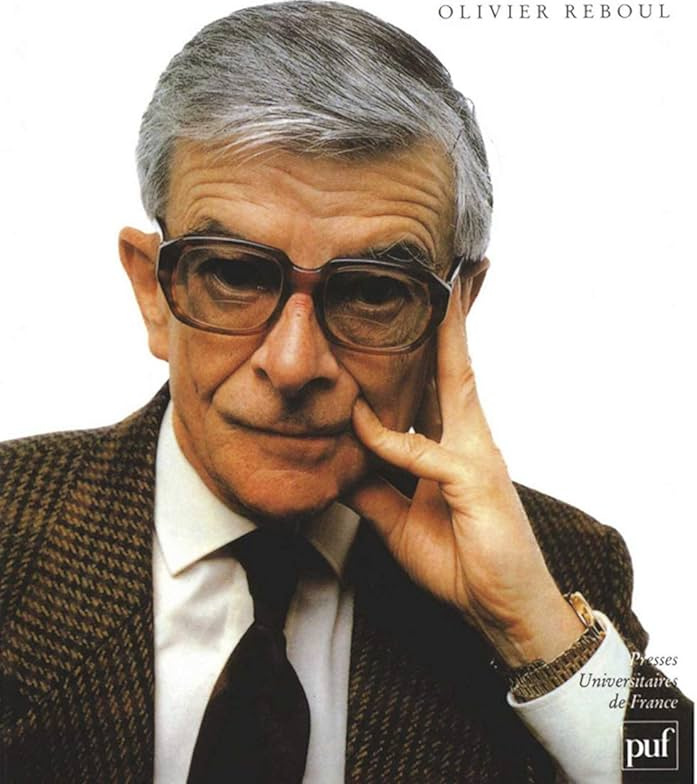كانت الأسئلة ولا تزال مفاتيح لتبديد حيرة الإنسان إزاء ذاته والموجودات من حوله. كلما استوقفه غموض أو غرابة، إلا وتوسل بتلك العملية الفطرية التي حقق بفضلها قفزات علمية وحضارية هائلة. بل ليس من المبالغة القول بأن أي حدث تاريخي أو علمي أو حتى مأساوي لم يخلُ من سؤال أو أسئلة سبقته، وحفزت البشرية للبحث عن أجوبة.
نتساءل عن كل شيء في حياتنا اليومية، لكن تكمن المشكلة في عدم امتلاكنا المسبق لصيغة تحدد الأسئلة التي يجب طرحها، وتلك التي ينبغي تنحيتها. وحتى يكون السؤال في محله فالمرء بحاجة إلى ما يشبه الموهبة التي يمكن أن يتعلمها؛ كأن النجابة تتوقف على طرح السؤال الجيد الذي يتناسب مع السياق، أي مع البيئة العامة التي توفر للسائل والمتلقي فهما أفضل للتوقعات. لذا تضعنا كتب اللغة والأدب أمام آلاف الوضعيات التي تختبر مقدرتنا على تفكيك الغامض والمبهم والمدهش، بنحت مثير عقلي واضح، يتوقف عليه حدوث استجابة ملائمة، وذلك هو السؤال!
ضمن حكايات وأخبار متفرقة، يحيل ظاهرها على الطرفة والإمتاع، ينبه ابن الجوزي قارئ كتابه (أخبار الأذكياء) إلى ثلاثة أغراض ينشد تحقيقها وهي:
- معرفة أقدارهم (الأذكياء) بذكر أحوالهم.
- تلقيح ألباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل تلك المرتبة.
- تأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من يعسر عليه لَحاقه.
وبين المعرفة والتلقيح والتأديب يتشكل فن السؤال باعتباره مرآة النجابة، ومظهرا أساسيا يكشف عن قوة الفطنة، وقوة جوهرية العقول:
" قال رجل لهشام بن عمرو القرَظي: كم تعُدّ؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأكثر، قال: لم أرد هذا، قال: فما أردتَ؟ قال: كم تعدّ من السن؟ قال: اثنتين وثلاثين سِنّة، ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل، قال: لم أرد هذا، قال: فما أردتَ؟ قال: كم لك من السنين؟ قال: مالي منها شيء، كلها لله عز وجل، قال: فما سنك؟ قال: عظم، قال: فابنُ كم أنت؟ قال: ابن اثنين، أب وأم، قال: فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى عليّ شيء لقتلني، قال: فكيف أقول؟ قال: قل: كم مضى من عمرك؟".
تفتح الأسئلة إذن خيارات التعلم للانتقال بالفرد من وضع التلقي السلبي إلى وضع التعلم النشط والحيوي والمتكامل. لا غرو إذن أن تشكل الأسئلة جوهر العملية التعليمية في فضائنا المدرسي، إذ لا يتصور في الأذهان تدريس خال من طرح الأسئلة، خاصة في ظل المقاربات الحديثة التي تبدي وعيا أكبر بضرورة التمحور حول المتعلم وتلبية احتياجاته.