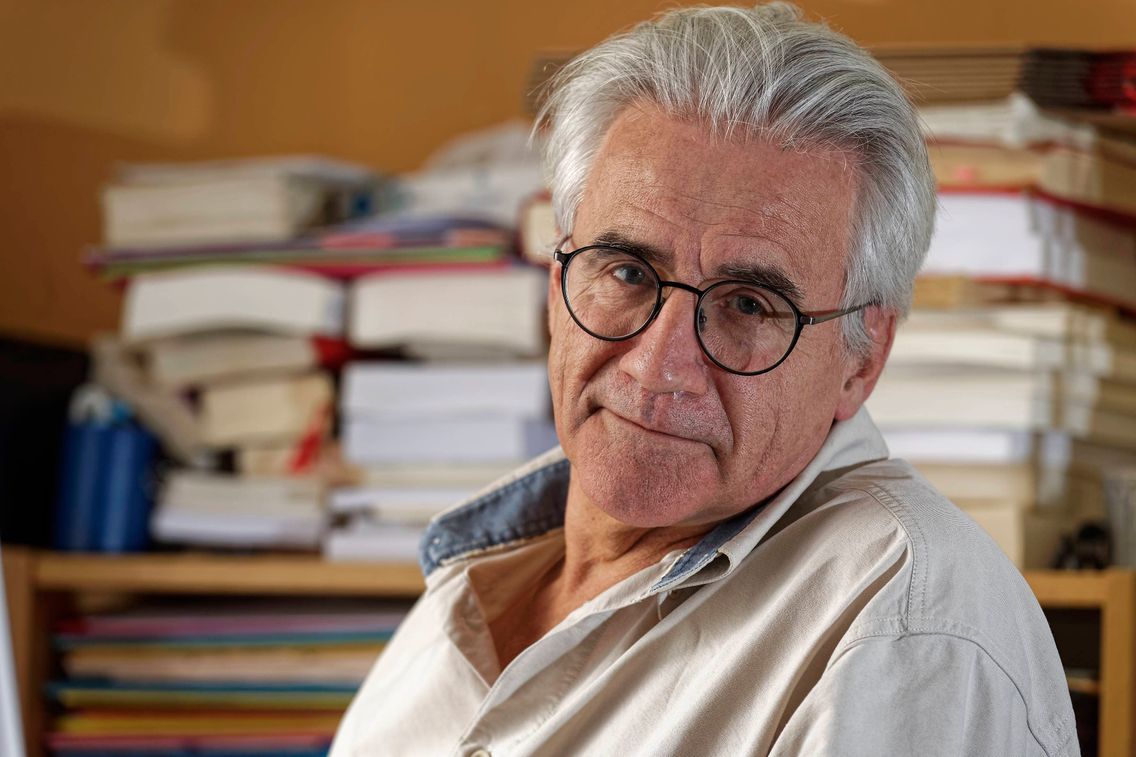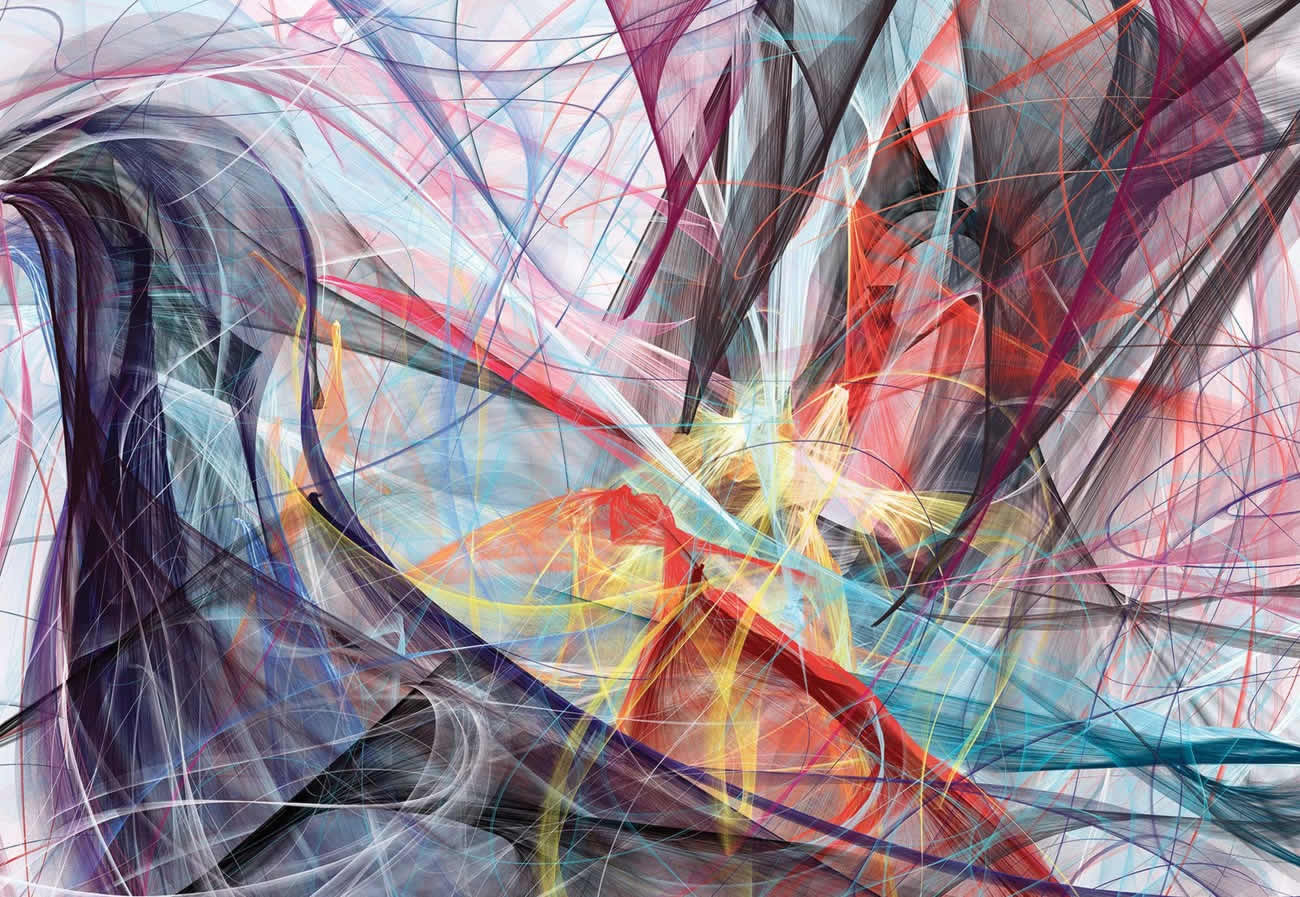في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومع سقوط جدار برلين وتفكُّك الاتحاد السوفيتي وسقوط الأنظمة الشيوعية، ساد تفاؤل عارم في الغرب بانتصار مُظفَّر ونهائي لليبرالية الغربية، لا سيما مع دخول العديد من دول "الكتلة الشرقية" (دول الشرق الأوروبي الشيوعي) في النظام الديمقراطي الليبرالي، مصحوبة بتأييد جماهيري ضخم وترحيب عالمي واسع، فيما عُرف تاريخيا بـ "الموجة الثالثة للديمقراطية".
أتى عقد التسعينيات إذن بوصفه عقد التفاؤل والهدوء العالمي والحلم الأميركي، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، القطب الدولي الأيديولوجي المضاد لواشنطن، اختفت صورة الحروب الكبرى من الأذهان، واختفت معها الانقلابات العسكرية المُدبَّرة والحروب الأهلية والصراعات السياسية الجذرية اختفاء شبه تام. وقد طُبع ذلك العقد في الذاكرة العالمية بالتفاؤل والهدوء، خاصة في صفوف مَن نشأوا وتَشكَّل وعيهم أثناءه، ومن ثمَّ باتت التسعينيات مناط الحنين لأيام لم ينشغل الفرد فيها إلا بهمومه الفردية والخاصة، مع لا مبالاة بأخبار السياسة والحُكَّام.
في معنى الفيلسوف - عبد الحفيظ أيت ناصر
" الهاجس المتمثل في البحث عن أسلوب جديد للتفلسف، يزيح التراتبية التقليدية بين الفلسفة و الأدب." ( مصطفى لعريصة، مدارات الذات، ص 33)
في معنى الفيلسوف؟
من الجميل أنه يحق لنا – نحن القراء العاديون – طرح هذا السؤال، أعني سؤالا بمثل هذه السخافة، لا يستطيع الفيلسوف ان يورط نفسه في مثل سخافة هذا السؤال، أي أنه لن يستطيع طرح هذا السؤال الا من ليس من الفلسفة في شيء.
الفيلسوف كائن حذر، كائن يكره الحماس، والناس العاديون مثلنا فقط يتحمسون، وينطلقون من دون أدنى درجة حذر. إن أي كائن ليس حذِرا هو كائن فاقد لكل أسباب الفاعلية والحياة.
لماذا نستطيع التحدث عن الفيلسوف، بكل بساطة لأننا لسنا فلاسفة، ثمة حرية رائعة في الامر، أن نستطيع التحدث عن هذا المخلوق العجيب، لسنا سوى اطفال يحركنا خيالنا ونحن ننظر عن بعد الى ظل هذا المخلوق الغرائبي. حتى إننا نستطيع ان نعيش ايامنا ونسير في عالمنا المعاش شبه جازمين انه ليس ثمة مخلوق بهذا الاسم، ليس هناك كائن بهذا الوصف. فيلسوف!
مفهوم الاغتراب - د.زهير الخويلدي
من الكلمة اللاتينية Alienus ، "الأجنبي" ، مشتق من aliud ، "الغريب". هذا المصطلح له في الأصل معنى قانوني: الاغتراب هو العطاء أو البيع. يستخدمه روسو بطريقة متناقضة في البداية لإدانة العبودية، ثم بشكل إيجابي للدلالة على الوصول، من خلال التبادل المتبادل للحريات، إلى مجتمع قانوني قائم على الإرادة العامة. يأخذ الاغتراب معنى أكثر فلسفية عند هيجل، الذي يستخدمه لوصف الحركة الديالكتيكية للوعي على أنها "ممر ضروري إلى الآخر" أولاً من خلال تقديم نفسه على أنه شيء بسيط، ثم بجعل نفسه غريبًا عن نفسه. هذا المصطلح مأخوذ من قبل خلفاء هيجل: فيورباخ ، مفكر الإلحاد ، يوضح كيف أن الإنسان "ينفر نفسه" من خلال نقل صفاته إلى الله. ماركس، من جانبه، يرى في الاغتراب الاقتصادي للبروليتاري خاليًا من الوعي الطبقي واستغلاله في عمله كاستراتيجية لنمط الإنتاج الرأسمالي من أجل الاحتفاظ بسلطته.
عناصر المجتمع الفلسفية - إبراهيم أبو عواد
1
تحليل الأفكار لا يتم بِمَعْزِل عن حاجةِ الفرد إلى الانتماء ، وحِرْصِه على تأكيد الذات ، فالانتماءُ يَمنح الأفكارَ شرعيتها الوجودية ، ومَدَاها الأخلاقي ، ومَجَالها الحَيَوي . وتأكيدُ الذات يمنح الأفكارَ القُدرةَ على التعبير عن ذاتها ، وتحقيق التوازن بين الخيال والواقع ، وإنشاء منظومة من التطبيقات الإبداعية على الأرض . وهذا يعني أن الأفكار مُجتمع مركزي شديد الاستقطاب ، يقوم على سياسة المحاور العقلانية التي تتوازى معَ الظواهر الثقافية، وتتقاطع معَ التجارب الاجتماعية . وبما أن الأفكار مُجتمع متكامل قائم بذاته ، فلا بُد أن يُنتج علاقات اجتماعية خاصَّة به . وإذا كانت الأفكارُ نَتَاج التفكير المُتكرِّر والتَّأمُّل العميق ، فإنَّ العلاقات الاجتماعية نَتَاج عملية التَّوليد المُستمر للأفكار ، التي تُؤَسِّس سُلطةَ المعرفة في بُنية المُجتمع الإنساني . وهذه السُّلطة _ بما تَملكه مِن آلِيَّات وأدوات _ قادرةٌ على تحويل الإفرازات الذهنية إلى سلوكيات عمليَّة ، ونقل الوَعْي الإنساني من المَبنى ( الشكل ) إلى المَعنى ( الجَوهر ) ، وعِندئذ يُصبح الخيالُ الهُلامي واقعًا مَحسوسًا ، وهذا يُساهم في بَلْوَرة شخصية الفرد الذاتية ، وتَكوينِ سُلطة المجتمع الاعتبارية . وكُل مُجتمع يَعرِف مَسَارَه ويُدرِك مَصِيرَه ، يَستمد قُوَّتَه الشرعية مِن سُلْطَتَين في آنٍ معًا : الوجود والمعرفة . وهاتان السُّلطتان تُحرِّران رُوحَ الوَعْي مِن جَسَد المنظومة الاستهلاكيَّة الماديَّة ، من أجل ضمان الانتقال السَّلِس للأفكار مِن الذهن المُجرَّد إلى الوجود المُحقَّق . وانتقالُ الأفكار يُمثِّل _ في واقع الأمر _ رحلةَ المجتمع من جسد اللامعنى في الفراغ إلى تجسيد المعنى في الوجود.
حول ريتشارد رورتي، البراغماتية كمناهضة للاستبداد - ترجمة: د.زهير الخويلدي
"إن التحول إلى مفهوم الإيتيقا المناهض للسلطوية يعني إعطاء المرء الحق والواجب لتغيير التقاليد من أجل تحسين المجتمع"
"سلسلة غير مسبوقة من المحاضرات تكشف وجهة نظر الفيلسوف البراغماتي ريتشارد رورتي حول الدين والحقيقة والإيتيقا، والتي تركزت على غياب مسؤولية البشر تجاه بعض السلطات غير البشرية (مثل الله أو الواقع أو الالتزامات الكونية). يسعى عمل ريتشارد رورتي (1931-2007) إلى استعادة نبلته إلى تيار فلسفي ظهر في الولايات المتحدة في بداية القرن التاسع عشر والذي استوعبته الفلسفة التحليلية: البراغماتية. في الوقت الذي تمزق فيه الفلسفة بسبب التنافس بين الفلسفة التحليلية والفلسفة القارية، تصور رورتي هذا التجديد كطريقة ثالثة. في عام 1996 ألقى رورتي سلسلة من عشر محاضرات في جامعة جيرونا بعنوان "مناهضة الاستبداد في نظرية المعرفة والأخلاق". إذا تم نسخ العديد منها بشكل مقتصد في مجموعات مختلفة من المقالات، فلن يتم نشر الكل إلا في شكله الأصلي باللغتين الكاتالونية والإسبانية في عامي 1998 و 2000. وهكذا فإن المنشور الحالي يتيح لأول مرة الفرصة لتقدير هذه الدورة باللغة الإنجليزية التي قدمها إدواردو مينديتا ، في خطته النهائية ، بأنه "أكثر التفسيرات تركيبية وتفصيلية" لفلسفة رورتي. يمكن النظر إلى هذه المحاضرات بشكل منفصل على أنها بانوراما موضوعية تعرض بشكل متتابع وجهة نظر رورتي حول الدين والحقيقة والايتيقا. ضع هذه الموضوعات المختلفة في مكانها هنا ، تصبح أكثر وضوحًا مع وجود لحظات مختلفة من نفس التأمل تتمحور حول فكرة مناهضة الاستبداد - أي رفض الاعتراف بأن البشر يمكن أن يتحملوا مسؤوليات تجاه شيء غير بشري (مثل الله ، الواقعة ، أو الالتزامات الكونية).
إعادة طرح الأسئلة الفلسفية الكبرى - د.زهير الخويلدي
" ضد "البشر بلا روح" وجميع أشكال الشمولية لدينا سلاح واحد فقط: التفكير!" حنة أرندت
الفلسفة ليست تقشفًا، فهي ليست مقصورة على أناس معينين. إنها موجودة في كل مكان في الحياة اليومية للجميع، ويمكن أن ترافقنا من أجل مصلحتنا. اللافت أن الفلسفة تعاني من تحيز مشترك، والذي يتمثل في الاعتقاد بأنها منفصلة عن الحياة اليومية. سيكون الفيلسوف هو الذي يفكر أكثر مما يفعل، والذي يكون رأسه في الغيوم، منشغلاً بمشاكل لا داعي لها. وبذلك يكون معارضًا لمن لديه إحساس بالواقع ورجلاه على الأرض. لتوضيح الأمر ببساطة، غالبًا ما يُنظر إلى الفيلسوف على أنه الشخص الذي يخترع المشكلات حيث لا توجد مشاكل من أجل سعادته. ما فائدة التساؤل عما إذا كنا أحرارًا حقًا، ولماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء، وماذا يعني أن تكون على طبيعتك، أو ما إذا كانت القوانين عادلة، أو كيف يمكن إزالة الفوارق بين الناس؟
هل يمكن للفلسفة أن تعلّمنا حبّ الحياة؟ - حوار مع : أندري كونت سبونفيل - حاورته: كارولين راكابي - ترجمة : عبد الوهاب البراهمي
- يذكّر هذا العدد الممتاز ببعض المفاهيم المفاتيح لمن لم يشتغل بالفلسفة منذ أمد طويل. هل يمكن التفلسف دون معرفة بتاريخ الأفكار؟
* أ. ك. س: التفلسف هو التفكير أبعد ممّا نعرف؛ هو أن نطرح على أنفسنا أسئلة لا يمكن لأيّ علم أن يجيب عنها. مثلا:" لماذا يوجد شيء بدل لاشيء؟"، "هل يوجد الإله؟" ، " ماذا يمكنني أن أعرف؟"، " ماذا يجب عليّ أن أفعل؟"، " ما العدالة؟"، " ما السعادة؟"، " كيف ندركها؟"...أو أن نطرح أيضا هذا السؤال الذي يلخّص كل الأسئلة الأخرى:" كيف نحيا؟" ولكن ما الفائدة من أن نطرح على أنفسنا أسئلة ، إذا لم يكن إلا من أجل أن لا نجيب عنها؟ وعلى خلاف ما نعتقد أحيانا، يجيب الفلاسفة عن الأسئلة التي يطرحونها، و هذه الأجوبة هي التي تكوّن فلسفتهم. من هنا تظهر الحاجة إلى الثقافة بأكثر وضوح. يمكن لطفل مثلا أن يطرح أسئلة فلسفية، تقريبا مثلما يكتب السيد جوردان نثرا. لكن أجوبته، إذا ما وجدت، ستكون تقريبا لا محالة ساذجة، بالمعنى السلبي للكلمة، لا بل فعلا حمقاء ، سطحيّة أو غير متناسقة. التفلسف، نتعلّمه! كيف؟ بالاحتكاك بالفلاسفة الكبار السابقين. يقول مالرو:" في المتاحف نتعلّم الرّسم" . وفي كتب الفلسفة نتعلّم التفلسف.
الإنسان الضائع في متاهة الحضارة - إبراهيم أبو عواد
1
وظيفةُ الظواهر الثقافية في الوجود الإنساني هي إقامةُ العلاقات الاجتماعية على القواعد الأخلاقية ، وتوظيفُ عناصر ذاكرة المجتمع من أجل تأسيس التوازن بين الذات الفردية والذات الجماعية، مِمَّا يَدفع باتِّجاه استثمار الخبرات الحياتية في تحليلِ الشعور الإنساني، وإنتاجِ فلسفة عملية تُساهم في تحقيق الذات ، وصناعةِ آلِيَّات معرفية ديناميكية تتعامل مع الواقع كمفهوم إبداعي ، وتتعامل مع الحقيقة كإطار مرجعي ، وهذا يُساهم في تفسير السُّلوك الإنساني ظاهريًّا وباطنيًّا ، والانتقال مِن كِيان الشخص إلى تَكوين الشخصية ، باعتبارها القُوَّة الضاربة والدافعة لتشييد وَعْي الإنسان بذاته في عَالَم يتشظَّى ، ويفقد كَينونته الأخلاقية تدريجيًّا تحت ضغط الأنماط الاستهلاكية المُتوحِّشة . وغرقُ العَالَم في أعماق اللامعنى المُوحِشة ناتجٌ عن انطماسِ الفِطْرَة الأُولَى وانكسارِ البراءة الأصلية ، فصارَ التاريخُ مشروعًا تجاريًّا ، وصارت الجُغرافيا شريعةً استغلالية ، وراحَ الإنسانُ يبحث عن نَفْسِه خارج نَفْسِه ، وأخذت الحضارةُ تَبْني شرعيتها على أنقاض الحضارات الأُخرى ، بسبب القناعة المغلوطة بأنَّ إثبات الحاضر لا يكون إلا بِنَفْي الماضي . وهذه الأوهامُ في بُنية التفكير تحوَّلت إلى قُوَّة مُحرِّكة لفلسفة نهاية التاريخ، والإنسانُ لا يستطيع أن يَحكم على التاريخ بالانتهاء،لأن التاريخ بدأ قبل الإنسان، ولَن يكون الإنسانُ موجودًا عندما ينتهي التاريخُ . والإنسانُ ضَيف على التاريخ ، ولَيس العكس . والضَّيْفُ لا يتحكَّم بصاحب البَيت .
اللامساواة بين اشكال الحياة الإنسانية - ترجمة: د.زهير الخويلدي
"بين الطبيعية والإنسانية، في منتصف الطريق بين بيريك وأدورنو ، يقترح ديدييه فاسين النظر في حياة البشر وفقًا لمتغير التقييم الممنوح لهم من البيئة الاجتماعية. ثم يتم استبدال أخلاق الرحمة بالمطالبة بالعدالة.
الحياة مشكلة قديمة، أعيد تعريفها في الفلسفة المعاصرة من قبل مؤلفين مثل أرندت، كانغيلام، فوكو، أو أغامبين بقدر ما أعيد تعريفها بواسطة الأنثروبولوجيا التي تتعامل مع هذا السؤال من خلال حشد منهجيات مختلفة. يقدم ديدييه فاسين في مقدمته وجهة نظر تركيبية لهذا التكوين المعرفي المميز بالتوتر بين مفهومين للحياة، يُنظر إليهما إما على أنهما ظاهرة بيولوجية "تجلب الإنسان إلى مجموعة كبيرة من الكائنات الحية"، أو كظاهرة تتعلق بالسيرة الذاتية، تصور الإنسان على أنه "كائن حي استثنائي من حيث أنه قادر على الوعي واللغة" في حين أن الفلاسفة القدامى والكلاسيكيين (أرسطو، لايبنيز ، ديكارت ، كانط) يقتربون من هذه الأبعاد من إطار مشترك ، يبدو أن النهج ثنائي التفرع ساد منذ القرن التاسع عشر ، لا سيما في العلوم الاجتماعية. يهتم عمل دراسات العلوم والتكنولوجيا بـ "الأحياء" بينما ينظر الآخرون إلى الوجود البشري كما يعيشون. يعمل مثل Vita.
"النزعـة الإنسـانيـة" في الحضـارتيـن اليـونـانيـة والعـربيـة - حـمـزة فــنــيــن
في أواخر يناير وأوائل فبراير من سنة 1947 ألقـى المرحـوم عبد الرحمـن بـدوي محاضـراتٍ قصدَ منها إحياءَ بعضٍ من العناصر الممتازة الخليقة بالبقاء في تراثـنا العربي، مُبتعداً في ذلك عن التجافي في التمجيد الزائف من جهة وعن الازدراء المتعالي من جهةٍ أخرى. وقد أعاد نشر هذه المحاضرات ضمن كتابه "الإنسـانيـة والوُجـوديـة فـي الفـكر العـربـي" (دار القلم، بيروت، ط 1982). وقد كانت "النزعة الإنسانية" من بين تلك المسائل الممتازة التي عرفها الفكر العربي قديماً قبل ظهورها في أوروبـا ما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر. فرأى عبد الرحمن بدوي ضرورة إحياء هذه النزعة، على الأقل بالتذكير بها، ودحض بعد أقوال المستشرقين.
ذلك العودُ المحوريّ إلى الوجود الذاتي الأصيل هو ما سُمّي في التاريخ العام باسم "النـزعـة الإنسـانيـة"، ويقرّ ع.بدوي أن خصائصه الإجمالية العامة هي واحدةٌ في كلّ الحضارات، ’’ ولهذا لم يعُد من المقبول في الفهم التاريخي الوجودي أن نقصر اسم هذه النزعة على "النزعة الإنسانية" الخاصة بالحضارة الأوروبية أو الفاوستية وحدها، دون بقية الحضارات، فهذا من قصر النظر التاريخي أو خداع المنظور أو من عدم الفهم الحقيقي لمدلول هذه النزعة الحقيقي‘‘. (م.ن، ص 24). وعند اليونان فقد تنبّه الباحثان W.Jeager و G.Saitta إلى حضور النزعة الإنسانية بكلّ معانيها عند السوفسطائيـة. و ع.بدوي نفسه لا يقف عند خصائص هذه النزعة في الحضارة الأوروبية إلا ويضـع ما يقابلها عند السوفسطائية في ثنايا عرضه.
العالم الطبيعي كمشكلة فلسفية حسب جان باتوشكا - د.زهير الخويلدي
تمهيد
جان باتوشكا هو من رواد الفلسفة المعاصرة ويتمثل عمل هذا الفيلسوف التشيكي أيضًا على الفينومينولوجيا ، تحت تأثير هوسرل وهيدجر ، كما في الفلسفة اليونانية ، التي تغذت من قراءاته لأفلاطون وأرسطو. يطور مفهومًا جديدًا للذات. وهو أحد مؤسسي دائرة براغ الفلسفية. ظهر العالم الطبيعي كمشكلة فلسفية، أطروحة التأهيل لجان باتوشكا ، لأول مرة في عام 1936 ، جنبًا إلى جنب مع الجزء الأول من الازمة. كان ذلك الوقت هو أول عمل - ولفترة طويلة هو العمل الوحيد - المكرس صراحة لمفهوم ووصف وتحليلات هوسرل للعالم الطبيعي. إذا ظل الشاب باتوشكا هناك مخلصًا للفلسفة المتعالية لأستاذه هوسرل، فإنه في كل استقلالية يحاول استعادة العالم الذي نعيش فيه - في حوار مع التحليلات الوجودية لهيدجر، وعلم كونيات فينك ، ونظرية شكل وإلهام دائرة براغ اللغوية. هذه الترجمة الجديدة، التي تضم النقد الذاتي المتعمق الذي أراد المؤلف إضافته في 1970 إلى الطبعة التشيكية الثانية، تسمح للقارئ بمتابعة تطور هذا الموضوع الرئيسي في التكوين. لمفهومه الأصلي للوجود كحركة والتحول نحو فينومينولوجيا "ذاتية".
نسيان العالم الطبيعي