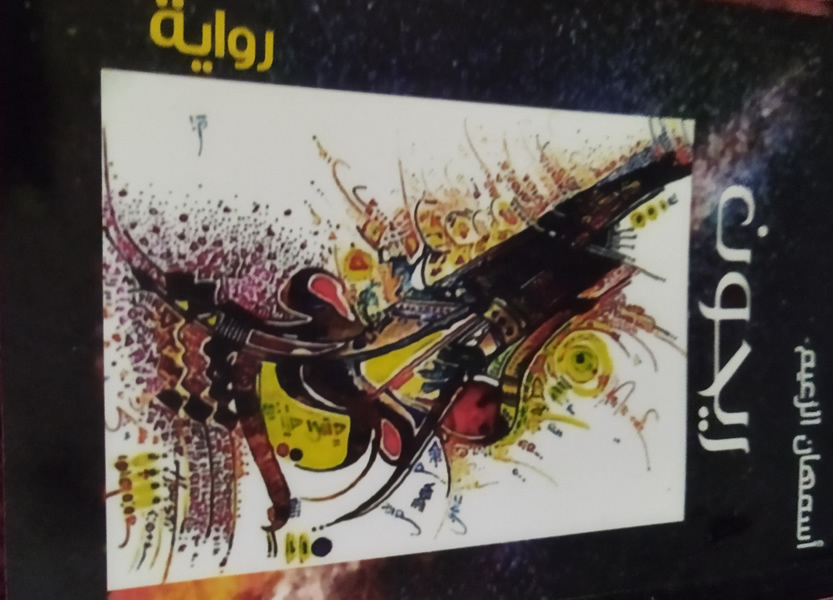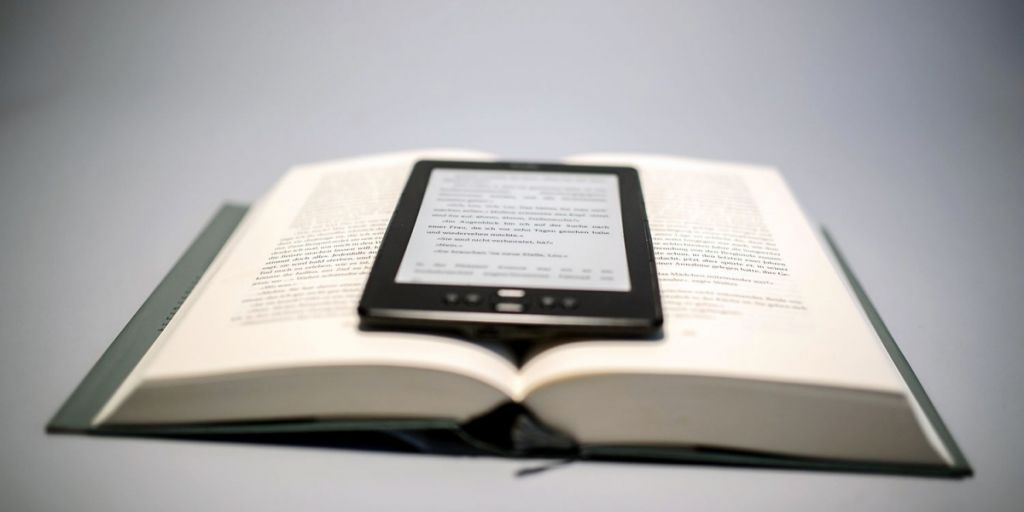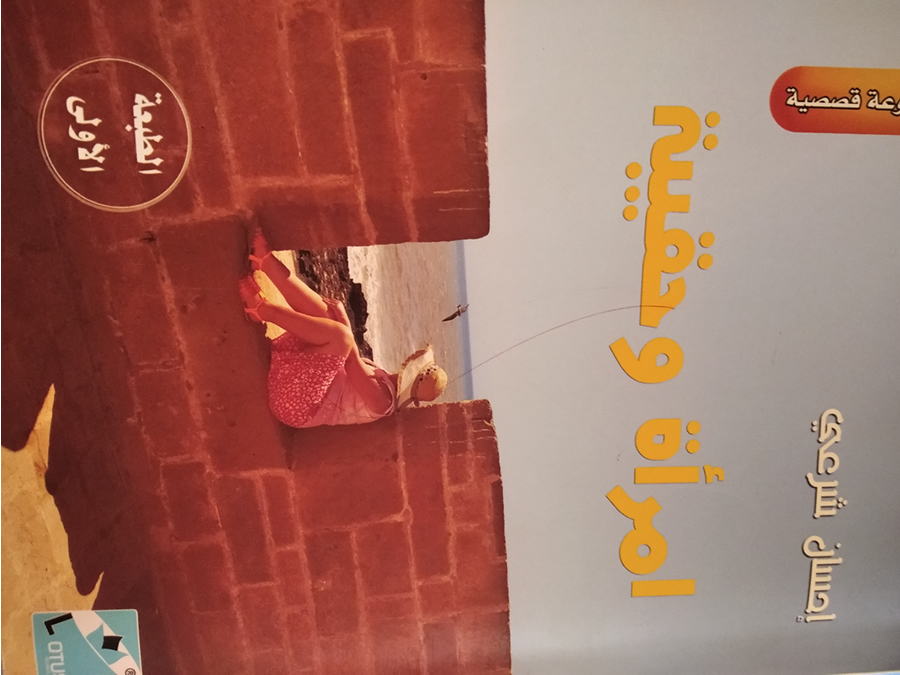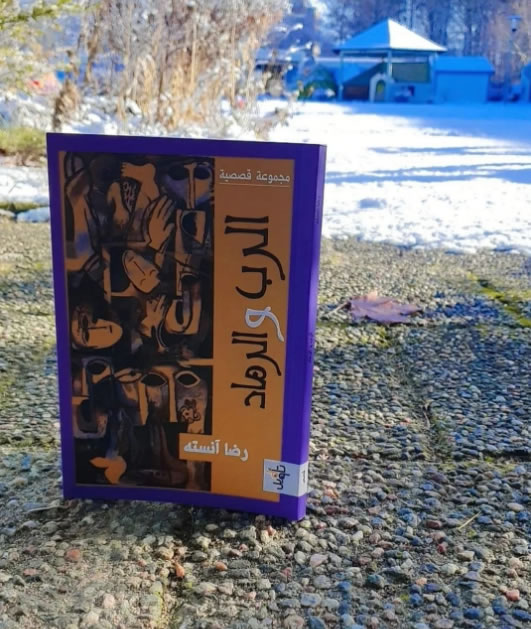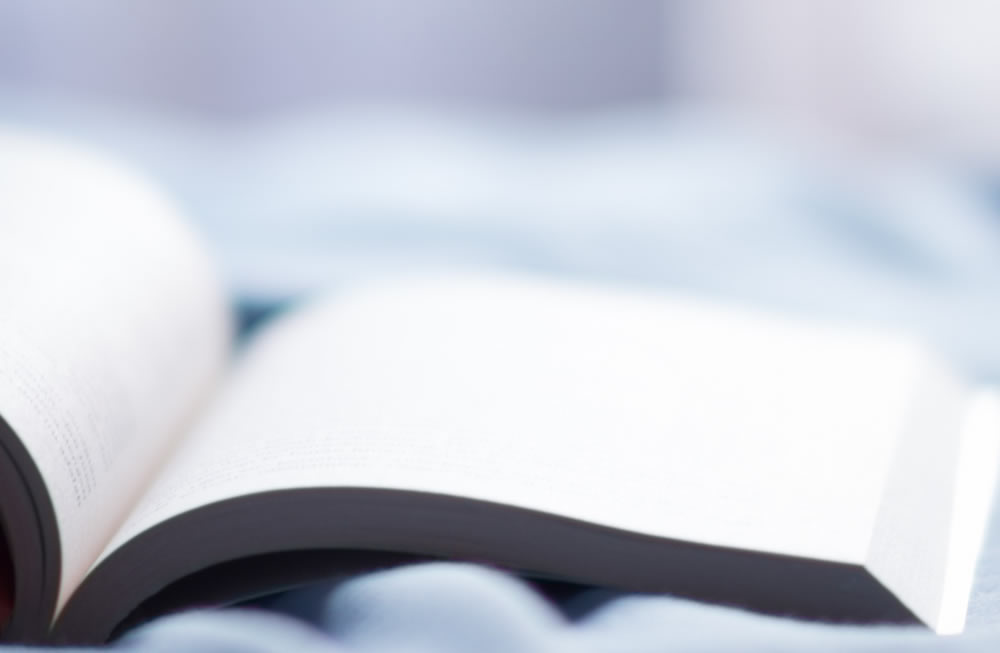1- على سبيل البدء.
لا يختلف الباحثون المهتمون بالشأن الشعري المغربي في كون تجربة الشاعر المغربي "أحمد المجاطي" الشعرية تجربة فريدة ومتميزة، تكمن فرادتها وتميزها في أنها استطاعت بشكل نَضِجٍ التأسيس([1]) لمغربية الشعر العربي المكتوب من طرف المبدعين المغاربة، الذين كانوا إلى عهد قريب، ينعتون وينعت منجزهم الشعري بالتبعية والتقليد للشعر المشرقي.
ولعل التدليل على ما ذهبنا إليه يتمظهر فيما تنماز به معظم قصائده الشعرية من خصوصيات، يطبعها العمق من جهة، والأصالة من جهة أخرى، بحيث يتبدى العمق من خلال مرس المجاطي بالشعر العربي القديم والحديث، حفظا ومعرفة وتدريسا، وكذلك من خلال ضبطه التام لعلمي البلاغة والعروض، هذه المعارف والعلوم عمقت قصائده الشعرية وخصبت مستوياتها الدلالية المعنوية والتخيلية والإيقاعية، ثم الأصالة المغربية المتجلية في ارتباطه الأثيل الأثير بهموم وطنه، وبهموم باقي الأوطان العربية.
وقد أسهم المجاطي بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء الشعرية المغربية الرائدة([2]) في إغناء مسار القصيدة الشعرية المغربية الحديثة، وذلك بنقلها من ضيق التقليد للشعرية المشرقية إلى رحب التجديد في الشعرية المغربية، التي صارت بعد ذلك نموذجا جماليا متفردا، دفع الشعرية المشرقية إلى الاقتداء والتناص مع مختلف مكوناته الموسومة بالتعدد والغنى الناتجين عن التنوع الثقافي والحضاري المغربيين، كما تفاعلت معه عدة شعريات غربية، انطلاقا من إنجازها لترجمات شعرية تترى ابتغاء الاسترفاد منه والانفتاح على خصوصياته.([3])
و رغم أن المجاطي كان مقلا في كتابة القصائد الشعرية إلا أن هذا الأمر ما عُدَّ نقيصة أو عيّا في مقدرته الشعرية، بل كان رهانا حصيفا على تلك القصيدة الأولى، أو القصيدة التي لم تُكْتَبْ بعدُ؛ لذلك كان يردد في غير ما مرة قوله المأثور:" لا نحتاج إلى من يكتب العشرات من الدواوين، بل نحتاج إلى من يكتب القصيدة الأولى"، وفي هذا إشارة عميقة إلى أن مكانة الشاعر وقيمة شعره لا تحدد في كثرة الدواوين الشعرية، ولا في كثرة الإصدارات والطبعات، وإنما تحدد في إجادة وإبداعية ما يكتبه من نصوص شعرية ضافية بالقيم الجمالية والإنسانية العليا.
ولعل الاطلاع على ديوانه الوحيد المسمى "الفروسية" يعد خير مثال وأفضل نموذج، يمكن أن يلمس فيه القارئ الخبير بمضايق الشعر تلك الجودة الإبداعية، التي راهن عليهما خلال عمره الشعري، المتجاوز لأربعة عقود، لذلك كله، يجدر بالقارئ الشاغف بالشعر المغربي الحق عدم الصدوف أو القفز على تجربة الشاعر أحمد المجاطي الشعرية، إذا ما أراد استجلاء الجوانب الدالة و المؤسسة لمغربية القصيدة الشعرية، المبنية عنده أساسا على حب الإنسان و المدينة و الأمكنة المغربية.