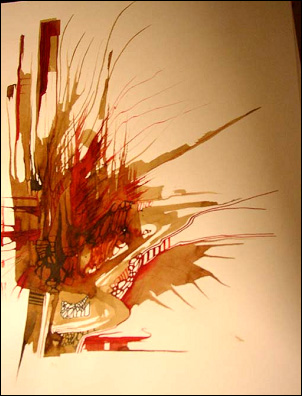 عند عرض الكلمتين اللاتينيتين (Mundus imaginalis) كعنوان لهذا النقاش نويت أن أعالج نظاما دقيقا من التناظر الواقعي للدقة السائدة للإدراك الحسي , لأن علم المصطلح اللاتيني يعطي الأفضلية من خلال وضعنا مع التعبير التقني والنقطة المثبتة في المصدر والتي نستطيع من خلالها مقارنة التنويعات بشكل اقل أو اكبر للمرادفات المحيرة التي تقترحها لغتنا المعاصرة لنا.
عند عرض الكلمتين اللاتينيتين (Mundus imaginalis) كعنوان لهذا النقاش نويت أن أعالج نظاما دقيقا من التناظر الواقعي للدقة السائدة للإدراك الحسي , لأن علم المصطلح اللاتيني يعطي الأفضلية من خلال وضعنا مع التعبير التقني والنقطة المثبتة في المصدر والتي نستطيع من خلالها مقارنة التنويعات بشكل اقل أو اكبر للمرادفات المحيرة التي تقترحها لغتنا المعاصرة لنا.
سأثبت حالا هذه الحقيقة وهي أن الاختيار لهاتين الكلمتين قد فرض نفسه علي فيما مضى لأنه كان من المستحيل - في ما ترجمت وقلت – أن أكون مقتنعا بكلمة خيال (Imaginary) .
مما لا جدال فيه إن هذا نقد موجه إلينا نحن الذين نعرف أن استخدام اللغة يعيق الاستعانة بهذه الكلمة ذلك أننا نحاول تقييمها بحس ايجابي وبغض النظر عن جهودنا , يبدو, أننا لا نستطيع منع استخدام هذا المصطلح (الخيال) عن الاستعمال الدارج , لأنه ليس متعمدا , أن يكون استخدامه مساويا لمغزى ما هو غير حقيقي لأنه شيء ما هناك وسيبقى خارج كينونته ووجود مختصر كشيء طوباوي ( utopian ( وأنا بالتأكيد ملزم بإيجاد مصطلح آخر لأنني ولعدة سنوات كنت وبحكم مهنتي وحرفتي مترجم للنصوص العربية والفارسية وهو الغرض الذي عتبر(نفسي) فيه خائنا لو أنني كنت ببساطة مقتنعا كليا أو حتى بشكل مساو أو بشيء من الحذر بمصطلح الخيال .
طريق خوصصة الإنسان ـ كورنيليوس كاستورياديس ـ ت: محمد عمر سعيد
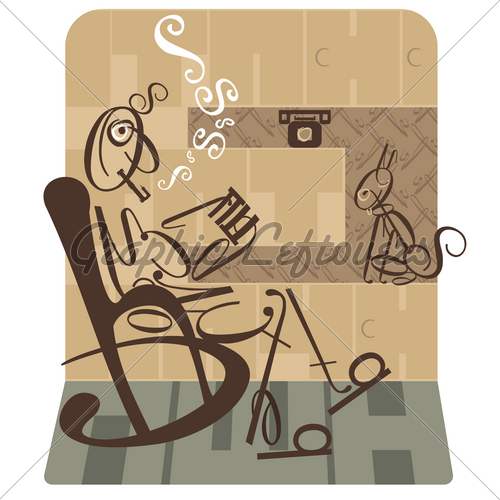 رحل في 26 ديسمبر 1997، كورنيليوس كاستورياديس، فيلسوف وخبير، أحد الوجوه البارزة في الساحة الثقافية الفرنسية، يوناني المولد، رحل إلى باريس سنة 1945 وفيها أسس مجلة (Socialisme ou Barbarie) . ونشر سنة 1968 رفقة إدغار موران وكلود لوفور (la Brèche) ، ساهم سنة 1970 في مجلة (Libre)، وإلى جانب مؤلفه الأساسي "تأسيس المجتمع تخيليا" سنة 1975 ، ألف عدة مؤلفات أساسية جمعت سنة 1978 ضمن سلسلة بعنوان: (Les Carrefours du labyrinthe)، وقد نشر هذا المقال قي صحيفة "Le Monde Diplomatique" فيفري 1998، وقمنا بترجمته للقارئ العربي لما رأينا فيه من صياغة مفاهيمية متينة ورؤية نقدية واعية.
رحل في 26 ديسمبر 1997، كورنيليوس كاستورياديس، فيلسوف وخبير، أحد الوجوه البارزة في الساحة الثقافية الفرنسية، يوناني المولد، رحل إلى باريس سنة 1945 وفيها أسس مجلة (Socialisme ou Barbarie) . ونشر سنة 1968 رفقة إدغار موران وكلود لوفور (la Brèche) ، ساهم سنة 1970 في مجلة (Libre)، وإلى جانب مؤلفه الأساسي "تأسيس المجتمع تخيليا" سنة 1975 ، ألف عدة مؤلفات أساسية جمعت سنة 1978 ضمن سلسلة بعنوان: (Les Carrefours du labyrinthe)، وقد نشر هذا المقال قي صحيفة "Le Monde Diplomatique" فيفري 1998، وقمنا بترجمته للقارئ العربي لما رأينا فيه من صياغة مفاهيمية متينة ورؤية نقدية واعية.
لا تكون الفلسفة فلسفة إذا لم تعبر عن نفسها بفكر ذاتي المصدر؛ فماذا تعني الأوتونوميا بما هي تعبير عن نسق ذاتي المصدر؟ إن المراد بالأوتونوموس هو "كل ما يستمد من ذاته قانونه الخاص"، وتعني هذه العبارة في مجال الفلسفة طرح السؤال دون رقيب أو سلطة حتى وإن كانت سلطة ذاتية تنبع من داخل الإنسان.
هذا الحكم يعتبر مساسا ضمنيا بمسلمة متفق عليها ذلك أن الفلاسفة وفي الغالب يبنون أنساقا بيضاوية مغلقة (نموذج سبينوزا وخاصة هيغل وشيئا ما أرسطو) الذين ارتهنوا ببعض الأشكال الفكرية التي صنعوها والتي لم يُقْدموا على إعادة مساءلتها، وقلة من كانوا عكس ذلك على غرار أفلاطون إضافة إلى نسق فرويد في التحليل النفسي رغم أنه لم يكن فيلسوفا.
ديرك ولكوت رجل متعدد الاصوات–ت:عمار كاظم محمد
 أكثر من أي شاعر معاصر يبدو ديرك ولكوت متوافقا مع برنامج ت.اس . اليوت الشعري حيث يميز نفسه في كل ما وصفه اليوت اجمالا " بالاصوات الشعرية الثلاثة " وهي القصيدة الغنائية ، والقصة او الملحمة والدراما ، فعلى الاقل منذ كتابه المعنون " منتصف الصيف " الصادر عام 1948 نشر ولكوت ما يمكن وصفه بالارتباط الغنائي في شعر ذاتي متسلسل بشكل قصائد فردية اريد لها تكوين تصور كامل عن الجميع .
أكثر من أي شاعر معاصر يبدو ديرك ولكوت متوافقا مع برنامج ت.اس . اليوت الشعري حيث يميز نفسه في كل ما وصفه اليوت اجمالا " بالاصوات الشعرية الثلاثة " وهي القصيدة الغنائية ، والقصة او الملحمة والدراما ، فعلى الاقل منذ كتابه المعنون " منتصف الصيف " الصادر عام 1948 نشر ولكوت ما يمكن وصفه بالارتباط الغنائي في شعر ذاتي متسلسل بشكل قصائد فردية اريد لها تكوين تصور كامل عن الجميع .
قصيدته الطويلة " اوميروس " الصادرة عام 1990 يمكن ان تسمى قانونا حيث ان تلك الكلمة لم تكن تشكل مشكلة في ذلك الوقت ومثل اليوت كان ديرك ولكوت كاتبا مسرحيا من خلال علاقته الطويلة بورشة ترنيداد المسرحية حيث اختزن الكثير من الافكار الدرامية الرائعة في كلا من النثر و في ذلك الشكل الصعب الذي دعي بالمسرحية الشعرية .
لكن القرابة مع اليوت بالنسبة لديرك ولكوت تمتد الى ما بعد ذلك الشكل . ففي مقال اليوت الشهير "الموروث والموهبة الفردية " الصادر عام 1919 قال اليوت " كلما كان الفنان أكثر مثالية كلما زاد الانفصال في داخله عما يكون عليه الانسان الذي يعاني والعقل الذي يبتكر " .
لقد تعمد ولكوت تجنب طريق الاعتراف الذي ابتكره صديقه منذ البداية وداعمه روبرت لويل حيث اختار بدلا عن ذلك صوت ما بعد الرومانسية واكثر قربا من الطبيعة والذي تكون فيه المفردات العرضية للحياة ذات رؤية شاعرية أكبر حيث لا تكون النفس فيها موضوعا ظاهرا .
ثم ظهر كتاب ولكوت المميز " طيور البلشون البيضاء " وهو مميز بسبب رؤيته في افضل تعبير لهذه الكلمة وذات جدا حتى كأنه سيرة ذاتية .
انه كتاب رجل عجوز يتوق الى يوم واحد من الضؤ والدفء وهو كتاب تقدير رزين ذلك التقدير الذي يحدث على عدة مستويات : البدني حيث تحمل التخريب البطيء لمرض السكر واجتماعي حيث موت الاصدقاء القدامى وزملائه من الشعراء ، لقد وصفه مواطنه سانت لوسيا بكونها "عبودية بدون سلاسل وبدون اراقة دماء " فهذا كتاب فيه ابتعاد عن كل ما هو حديث في الأدب " التعمد المتنافر في الابتهاج ونفحة الفوضى فمنذ الصفحة الاولى في بعض الكتب الجديدة " تجد القليل من الجمهور اللائق الذي يقول له " انت ايها القاريء صديقي الأغلى " .
زهير الشايب .. وعبقرية ترجمته "وصف مصر" - د• ناصر أحمد سنه

في 14/9/ 1979م أعلن المجلس الأعلي للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لذلك العام. وكان من بين الفائزين بالجائزة التشجيعية الأديب والمترجم الأستاذ "زهير الشايب"، وذلك لجهوده الرائدة في ترجمته أجزاء من موسوعة "وصف مصر". تلك الموسوعة ذات القيمة التاريخية والإجتماعية والعلمية والثقافية، والتي كتبها علماء الحملة الفرنسية المصاحبين لنابليون بونابرت إبان حملته على مصر 1798-1801م.
لم تكن مدافع الحملة الفرنسية قد صمتت بعد حين شرع علماؤها في وضع خططهم لسبر تاريخ مصر، بتفحص ورصد جوانب الحياة المختلفة.. جغرافياً وإجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وبيئياً الخ. فضلاً عن "استطلاع" أحوال الشرق، والتعرف علي أهله بشكل علمي ومنهجي وموضوعي. وشكل هذ "المسح العلمي" لمصر نهاية القرن18، مقدمات لتأليف كتاب "وصف مصر" (CARTE TOPOGRAPHIQUE DE L EGYPT).
وكان علماء الحملة قد استغرقوا في هذا العمل نحو ثلاثة عشر عاماً (1809-1822م). لكن الاب الروحي لكتاب "وصف مصر" هو تاجر مصري اسمه "هملان"، وهو عاشق للثقافة تعهد تمويل طبع الكتاب، وصدر المجلد الاول منه عام 1802م، و"طبع بأمر صاحب الجلالة الإمبراطور نابليون الأكبر" وأهدي إليه. في حين أهدي المجلد الثاني لحكومة الادارة.
الترجمــــــة ورهان العولمة - محمد حافظ دياب
 هل يمكن للترجمة أن تمثل سلاحا تستطيع به قوى العولمة تحقيق صياغة ملتبسة وملغومة للواقع والحقائق، ضمن تمرير مصوغاتها الاستراتيجية؟
هل يمكن للترجمة أن تمثل سلاحا تستطيع به قوى العولمة تحقيق صياغة ملتبسة وملغومة للواقع والحقائق، ضمن تمرير مصوغاتها الاستراتيجية؟
ذلك ان عملية التواصل عبر النص المترجم، وفي ظروف صراع مصالح هذه القوى، تصْطفي مصطلحات ومفاهيم بعينها، وتصوغ تصورات ذات أغراض وأهداف موجهة، قد تكسب صورة الواقع دلالات مخاتلة، ما يشي بأننا قبالة فعلين متنافيين: العولمة كهيكلة ناجزة للعالم في سعيها الى تثبيت الوحدة والتنميط، والترجمة كمحاولة لأنسنة هذا العالم بإحلالها للتواصل وتعدد اللغات والمعاني والدلالات.
بهذا الهاجس، يتحدد مقصد المساهمة هنا، في البحث عما يسمح باستيضاح العلاقة بين الترجمة والعولمة، وصولا الى فهم حيثياتها، والتعرف على أوضاعها بصورة أجلى، من خلال التماس الجواب عن تساؤلات من قبيل: ماذا عن طبيعة هذه العلاقة في ظروف حرب المصطلحات والمفاهيم الرائجة راهنا؟ أية وقائع عبّر عنها توظيف الترجمة ضمن أهداف استراتيجية لقوى بعينها؟ وكيف عن السياق الذي يحكم هذا التوظيف؟
وهل في الامكان النظر الى ما يطلق عليه «الترجمة الليبرالية»، والتي تميز، في الحاضر، الخطاب الاعلاني للشركات الكونية، كشاهد على وطأة هذا التوظيف؟ وما هي الآليات التي ابتدعتها قوى الهيمنة الفكرية للعولمة في «ضبط» عملية الترجمة؟ وأخيراً، ما الذي قدمه درس الترجمة العربية في هذا الصدد؟
رُهاب الترجمة
لا تذهب بدوني : جلال الدين الرومي ـ ترجمة : عمار كاظم محمد
 أسم مولانا جلال الدين الرومي يمثل الحب والتحليق المنتشي في اللانهائي . يعد الرومي واحدا من كبار الأساتذة الروحيين والعبقريات الشعرية الإنسانية وقد أسس الطريقة المولوية الصوفية في السلوك . ولد جلال الدين الرومي في أفغانستان الخاضعة ل(بلخ) في 30 أيلول عام 1207 لعائلة ملتزمة دينيا وقد هربوا من غزو المغول ودمار الحروب حيث سافر مع عائلته في ارض الإسلام حيث قاموا بالحج إلى مكة واستقروا في النهاية في (قونيه) من بلاد الأناضول ليصبحوا جزاء من الإمبراطورية السلجوقية وعندما توفي والده بهاء الدين ولد نجح جلال الدين في أن يأخذ مكان والده في تدريس العلوم الدينية حيث أكمل دراسته الدينية والعلوم الشرعية . لقد دخل جلال الدين الرومي المجال الصوفي بواسطة درويش جوال يدعى شمس الدين التبريزي والذي كتب عنه فيما بعد ديوان (شمس تبريز) ألف جلال الدين الرومي ملحمة شعرية تعليمية هي كتاب (المثنوي) وقد دعيت قرآن الفارسية كما يقول الشاعر عبد الرحمن الجامي وكذلك ألف كتاب(فيه ما فيه) ليعرف مريديه بطريق الميتافيزيقيا . إذا كان هناك أي فكرة عامة عميقة في شعر جلال الدين فهي حبه المطلق ل (لله) ونفوذه في الفكر والشعر والأدب وكل أشكال التعبيرالأخلاقية في عالم الإسلام . توفي مولانا جلال الدين الرومي في 17 ديسمبر 1273 وتبع جنازته خمسة من أصدقائه المخلصين وقد سميت تلك الليلة (ليلة الاتحاد) ومنذ ذلك التاريخ ودراويش المولوية يعتبرونها مناسبة لهم .
أسم مولانا جلال الدين الرومي يمثل الحب والتحليق المنتشي في اللانهائي . يعد الرومي واحدا من كبار الأساتذة الروحيين والعبقريات الشعرية الإنسانية وقد أسس الطريقة المولوية الصوفية في السلوك . ولد جلال الدين الرومي في أفغانستان الخاضعة ل(بلخ) في 30 أيلول عام 1207 لعائلة ملتزمة دينيا وقد هربوا من غزو المغول ودمار الحروب حيث سافر مع عائلته في ارض الإسلام حيث قاموا بالحج إلى مكة واستقروا في النهاية في (قونيه) من بلاد الأناضول ليصبحوا جزاء من الإمبراطورية السلجوقية وعندما توفي والده بهاء الدين ولد نجح جلال الدين في أن يأخذ مكان والده في تدريس العلوم الدينية حيث أكمل دراسته الدينية والعلوم الشرعية . لقد دخل جلال الدين الرومي المجال الصوفي بواسطة درويش جوال يدعى شمس الدين التبريزي والذي كتب عنه فيما بعد ديوان (شمس تبريز) ألف جلال الدين الرومي ملحمة شعرية تعليمية هي كتاب (المثنوي) وقد دعيت قرآن الفارسية كما يقول الشاعر عبد الرحمن الجامي وكذلك ألف كتاب(فيه ما فيه) ليعرف مريديه بطريق الميتافيزيقيا . إذا كان هناك أي فكرة عامة عميقة في شعر جلال الدين فهي حبه المطلق ل (لله) ونفوذه في الفكر والشعر والأدب وكل أشكال التعبيرالأخلاقية في عالم الإسلام . توفي مولانا جلال الدين الرومي في 17 ديسمبر 1273 وتبع جنازته خمسة من أصدقائه المخلصين وقد سميت تلك الليلة (ليلة الاتحاد) ومنذ ذلك التاريخ ودراويش المولوية يعتبرونها مناسبة لهم .
هارولد بنتر شاعرا - ترجمة: عمار كاظم محمد
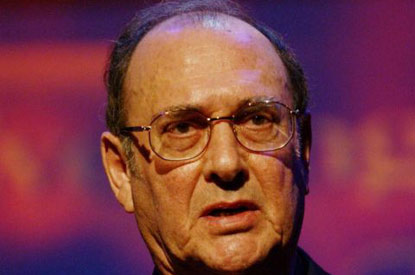 على الرغم من أن سمعته قد بنيت على كونه كاتبا مسرحيا لكن هارولد بنتر ظل حتى نهاية حياته يعود مرارا وتكرارا الى طهارة الشعر كوسيط يبدي من خلاله غضبه السياسي المتزايد .
على الرغم من أن سمعته قد بنيت على كونه كاتبا مسرحيا لكن هارولد بنتر ظل حتى نهاية حياته يعود مرارا وتكرارا الى طهارة الشعر كوسيط يبدي من خلاله غضبه السياسي المتزايد .وعلى الرغم من أن نتاجه الشعري لا يعد في الاعتبار العالمي ضمن مجتمع الشعراء لكنه منح مع ذلك جائزة ولفريد أوين للشعر حيث منح هذه الجائزة باعتباره استمرارا لتقاليد ولفرد أوين الشعرية عن ديوان المعنون الحرب .
يقول مايكل غراير رئيس هيئة ولفرد أوين بان قصائدة قد كتبت بتركيز شديد ووضوح واقتصاد وكان العديد من قصائده قد ظهرت لأول مرة في صحيفة الغارديان وبعض تلك القصائد يعود الى عام 1995 .
( 17 كانون الثاني 1995 )
لا تنظر
فالعالم على وشك أن يتحطم
لاتنظر
فالعالم على وشك أن يتخلص من كل ضيائه
ليحشرنا في حفرة ظلامه
مفهوم الجمالية المسرحية(*) -كاثرين نوكريت(**) - ترجمة: م. أحمد حُسَيني
 1-إعادة تعريف المسرح
1-إعادة تعريف المسرحإن المهمة الأولى للجمالية المسرحية الجديدة التي تأسست في منعطف القرنين التاسع عشر والعشرين هي إعادة تعريف المسرح باعتباره فنا. فبعد أن اقتصر البعد الفني للمسرح على الأدب الدرامي، أصبح الأمر يتعلق بإعادة تأسيس المعايير الجمالية للفن المسرحي. إذ بعد المصلحين الأوائل للمسرح، زولاZola أنطوان Antoine، ستراندبوغ Strindberg و جاري Jarry، فإن المنظرين أدولف أبيا Adolphe Appia (1862-1928) وادوارد كردون كريغ Edward Gordon Craig (1872-1966) هما اللذان وضعا الأسس التصورية للفن المسرحي الحديث. في "الحوار الأول حول فن المسرحle Premier Dialogue de L’art du théâtre )1905( أعلن كريغ بهذه الطريقة "نهضة" مسرحنا في الغرب التي سينجزها "المخرج، فنان مسرح المستقبل". "فعندما يتم ظهور إنسان يتحلى بكل الخصال التي تجعل منه نابغة في فن المسرح وكذلك تجديد المسرح كوسيلة وأداة، أي عندما يصبح المسرح رائعة من روائع الآلية ويخترع تقنيته الخاصة به، سيولَد دون عناء فنه الخاص وهو فن خلاق ومبدع" ثم إنه يعطي بواسطة صوت "القيم" الذي ينشط هذا الحوار على المسرح، وهو يجيب على أسئلة "هاوي المسرح"، التعريف المشهور اليوم لهذا الفن المسرحي الجديد الذي أصبح "مبدِعا": "تابعوا إذن، باهتمام ما سأقوله لكم وقلدوه كلما دخلتم إلى منازلكم. بما أنكم منحتموني كل ما طلبت، ها كم العناصر التي سيكون منها فنان مسرح المستقبل روائعه : الحركة، الديكور، الصوت. أليس ذلك بالهين؟
أقصد بالحركة الإشارة والرقص اللذين يمثلان نثر الحركة وشعرها.
أقصد بالديكور كل ما نراه كالملابس، الإنارة، والديكور بحصر المعنى.
أقصد بالصوت الأقوال المنطوقة أو المغناة في مقابل الأقوال المكتوبة، لأن للأقوال المكتوبة لتقرأ وتلك المكتوبة لتنطق نظامين مختلفين تماما".
لقد ولد مع كريغ المفهوم الجمالي لفن مسرحي مستقل، لم يعد قائما على النص، بل على العرض. إن الثورة الثقافية للممارسة المسرحية خلال ثمانينات القرن التاسع عشر ولدت منذ مطلع القرن العشرين أفكارا جديدة عن المسرح؛ أي أفكارا مؤسسة ستحدد بدورها كل التاريخ المسرحي المعاصر وتوجهه.












